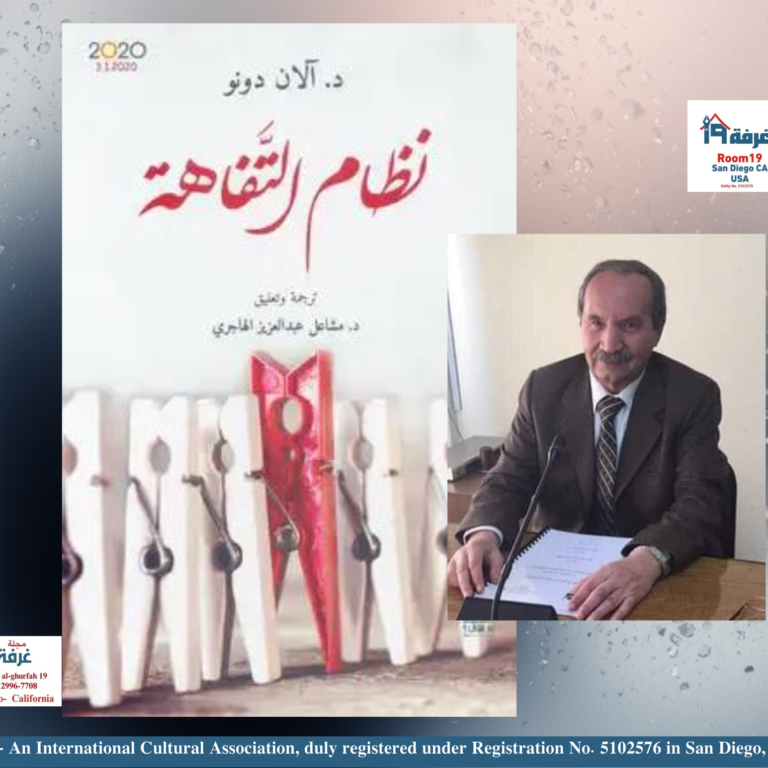اللوحة للفنان والشاعر اللبناني يامن صعب

اللوحة المرفقة: للفنان والشاعر يامن صعب
زياد الرحباني: صوت الوجدان اللبناني وضمير الفن
” هل تعرفين؟
الصغيرُ أمام الكبير،
أمامَ سيّده
كلامُه أحلى من كلام سيّده!”
زياد صديقي الله
في رحيل زياد الرحباني، لا ينطفئ فنان فحسب، بل تنطفئ حقبة كاملة من الفن الذي قاوم الرداءة، والوعي الذي دافع عن الحقيقة بلغة النغمة، والمسرح، والكلمة. هو أحد أبرز الأصوات التي شكّلت الذاكرة الجمعية للبنانيين والعرب، ليس فقط عبر ألحانه أو كلماته، بل عبر حضوره الفكريّ النقديّ، وسخريته النبيلة التي كانت تفضح قبح الواقع من دون أن تسرق منا القدرة على الضحك.
كتب زياد:
“إن لم أكن فرحاً
لا أستطيع أن أصلي
ما من مرة صليتُ
وإلا وفي قلبي
عصفورٌ يلعب
وغصنٌ يلوّح.”
زياد صديقي الله
وُلد زياد في بيت موسيقيّ استثنائي، ابن السيّدة فيروز والأستاذ عاصي الرحباني، ونشأ في كنف تراث لبناني لا مثيل له. لم يكن مجرّد امتداد تلقائيّ للرحابنة، بل اختار أن يكون امتدادًا مغايِرًا، خاصًا، متفرّدًا. سكّن الإرث الثقيل الفني في روحه، وأعاد تأويله بما يتماشى مع نبض المدينة ومعاناة الناس اليومية، فمزج بين عبق فيروز ونبض عاصي وروح الناس في الشارع، فجعل من موسيقاه مرآةً لهويةٍ لا تموت، مهما تراكم عليها من ركام.
حين نستعيد صوت زياد، فإننا لا نستعيد مجرد فنان، بل نستحضر مشاهد من الطفولة، من مقاهي الحمراء، من مسارح الحرب والسلم، من إذاعة “الجمهورية”، من حواراته التي كنا نتابعها كما لو كانت جلسات اعتراف جماعية. نسمعه، فنضحك ونبكي ونغضب ونفكّر، لأنه لا يقدّم “محتوى”، بل يعيد ترتيب مفاهيمنا عن الوطن، عن الجمال، عن الدين، عن الفنّ، وحتى عن أنفسنا.
في مسرحه، كنا نرى لبنان كما لم نره من قبل: مشاكسًا، طائفيًا، مشلولًا، لكنه حيّ في الألم وفي الضحكة معًا.في موسيقاه، كان يعيد رسم خريطة شعورنا، كما في “ميس الريم” و”نزل السرور” و”ع هدير البوسطة”، الأغنية التي اختزلت جغرافيا الضيعة وهمّ الوطن في سطر واحد. لقد كتب زياد ذاكرة بصرية في شكل أغنية، لدرجة أننا لم نعد نسمع الموسيقا فقط، بل نراها، نشمّها، ونعيشها.
كان زياد مثقفًا عضويًا بامتياز. لم يرض أن يكون ترفًا بصريًا في مشهد فارغ، ولا جزءًا من ديكور ثقافي استهلاكي. رفض الاصطفاف المجاني، والولاء الأعمى، ووقف دائمًا إلى جانب الناس، وإن كان على حساب شعبيّته أحيانًا. كان ناقدًا حتى لذاته، ساخرًا حتى من أمه فيروز، مقدّسًا للحبّ والعدالة والصدق.
“كيف أفهمك
يا عصفور قفصينا
إنني أنا غيرُ أهلي
لا أُحب أن أقتني
لا أقفاصا ولا عصافير.”
زياد صديقي الله
في وجه من ” يجرحون الأرض بالسلاح”
كتب زياد عن الإيمان، كما لم يكتب أحد، وصرخ ضدّ الجوع كما لم يصرخ أحد. قال “أنا مش كافر… بس الجوع كافر”، فهزّ وجدان أمّة بأكملها، معلناً أن الفن لا يجب أن يكون حياديًا أو جبانًا، بل شجاعًا يُسائل ويكسر التابوهات.
قدّم زياد نموذجًا فنيًا جديدًا في لبنان، لم يكن تكرارًا لأبويه، بل تأسيسًا لهوية فنية مستقلة. أخذ من الرحابنة الحسّ الجماليّ والعمق الموسيقيّ، لكنه أضاف إليه السخرية، النقد، الارتجال، وتفكيك الخطاب الطوباوي. وبهذا، كان هو نفسه مشروعًا للحداثة الفنية اللبنانية، بل مشروعًا لما بعد الرحابنة، حيث لا قداسة لأحد، بل الإنسان أولًا، بكل ضعفه، وبكل مقاومته.
في عالم عربيّ يستهلك الفنّ استهلاكًا، ويخاف من الفكر النقدي، كان زياد استثناءً مؤلمًا. كان صوته في الراديو يسبق وعينا. يضحكنا فنضحك، لكنه في العمق يوقظ فينا شيئًا نائمًا. في السياسة، في الحبّ، في الموسيقا، في اللهجة، كان دائمًا المختلف، القريب، الإنسان.
لا يمكن لأي لبناني أو عربي أن يفصل وعيه الفني والاجتماعي عن تأثير زياد الرحباني. هو الذي علّمنا أن المسرح ليس مجرد متعة، بل موقف، وأن الموسيقا ليست خلفية جميلة، بل صرخة حق. زياد لم يكن مجرد مؤلف، كان ضميرًا، شاهدًا على الحرب، على الطائفية، على الغدر، على الرحيل… شاهدًا على لبنان الذي نحلم به، ولبنان الذي ينهار.
وقد عبر هن ذلك بأكثر من قصيدة:
كتب:
“أتيتُ الأولاد المشردين بالأوراق
وسألتهم أن يرسموا أشجاراً
فرسموا أغصاناً طويلة فارغة
نائمة على الأرص
وعليها مدفعٌ وعسكر
فقلتُ: لا، إلا هذا
ارسموا زهراً وبيتاً
فرسموا زهوراً ملقاةٌ في مياه المطر
والعسكر يدوسُها”
زياد صديقي الله
في موته، ترك لنا زياد رسالة مؤلمة بقدر ما كانت مفاجئة. لقد عاش خيبات مريرة قبل من فقدان الاصدقاء، إلى خيبات الوطن، إلى خذلان القريب، رحل زياد، كما يرحل الكبار، بهدوء، لكن بصدى لا يزول.
وكتب:
” صرت أخاف
أن أطيل النوم
كي لا يذهب الجميع
وأبقى وحدي”
زياد صديقي الله
وداعًا يا زياد… لن ننساك

هل رحل زياد فعليًا، لا بل هو في خلفية كل أغنية، في ضحكة كل ساخر، في وعي كل شاب يتعلّم أن يرفض القبح باسم الجمال، أن يرفض الظلم باسم الفنّ، أن يضحك بينما ينزف. هو في اللاوعي الجمعيّ لهذا الوطن، حيث الحزن لا يخلو من أمل، وحيث النغمة لا تنفصل عن الفكر.
زياد الرحباني أكثر من فنان، مدرسة، بل وطنًا صغيرًا بحجم بيانو وميكروفون وكلمة جارحة، يتم يجوب شوارعنا الان في بلد لا يُجيد التعامل مع ابنائه العباقرة، لكنّك زرعت فينا ما يكفي من الموسيقا في الوجدان.
“تعبت فجلستُ
ومرّت بي فتاة وقالت:
ما بك تجلس على الوقت!”
زياد صديقي الله
وداعًا أيها المثقف، أيها العاشق، أيها الفيلسوف، أيها الساخر النبيل.
أنت لم تمت… بل صرت ذاكرةً تُعاش.
“كلهم يعرفون أنّ دقيقة العُمر
مرةً تأتي
ويعرفون أن الفرح فيها
أحلى من الحزن
لكنّهم لا يصدقون أنفسهم”
زياد صديقي الله