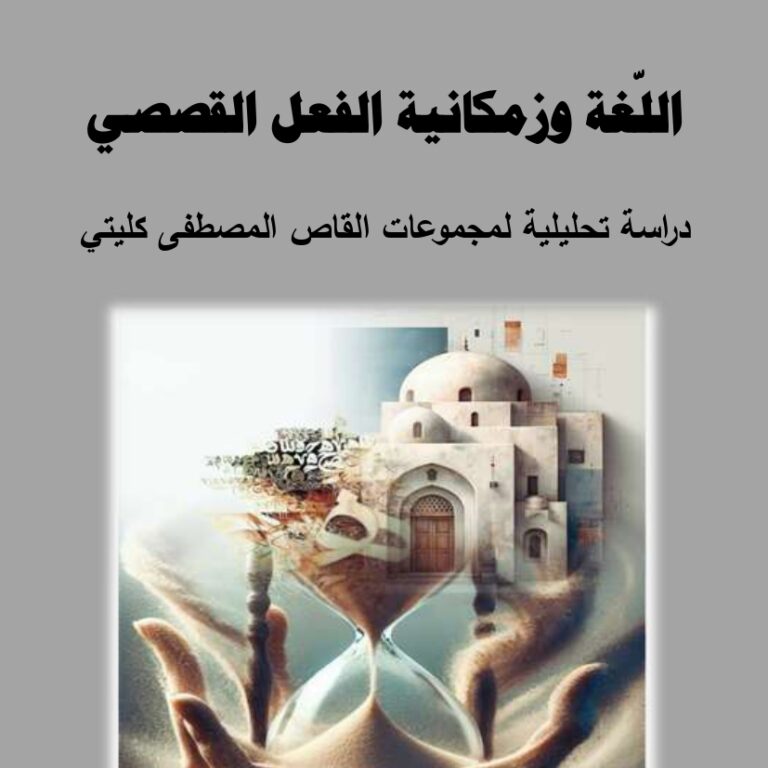من اليمين أمام: خالد السروجي- أحمد محمد حميدة من اليمين خلف: عبد الله هاشم- الشربيني المهندس- منير عتيبة- د. أحمد صبرة- سعيد بكر
لذلك عندما قررت التعرف إلى الحياة الثقافية في الإسكندرية، وكانت البداية بـ”ندوة الإثنين” أقوى ندوة للقصة والرواية بالمدينة، بقصر ثقافة الحرية (مركز الحرية للإبداع حاليًا) كنت ذاهبًا إلى الندوة بقدر كبير من الثقة بالنفس، ولكي أطمئن نفسي أكثر، قررت قراءة قصة منشورة بالفعل، قرأتها من الصحيفة مباشرة، كنوع من التأثير النفسي على المستمعين!
انتهيت من قراءة القصة، انتظرت التعليقات، مرت دقيقة أو دقيقتان كانتا كدهر، انتظرت التصفيق، الإشادة بالمستوى الممتاز للقصة، السجود لله شكرًا أن انضم إلى الندوة قاص شاب عبقري مثلي. لم يتحدث أحد. ثم تنحنح رجل أبيض، طويل، وجهه مدور ممتلئ، شعره ناعم خفيف، عدَّل وضع نظارته فوق أنفه، ثم قال لي: “هذه أقرب إلى تمثيلية في الإذاعة منها إلى قصة قصيرة، فالحوار غالب عليها بشكل كبير”. اختفت المرئيات من أمامي، ولم أعد أسمع ما يقال بالندوة، من قرأ قصة، من علق عليها، لا أدري، أنا في حالة غياب تام. انتهت الندوة فانصرفت وحيدًا. مشيت من قصر الثقافة إلى موقف محطة مصر، ثم ركبت المشروع (الميكروباص) من محطة مصر إلى العوايد، حوالي نصف ساعة، ثم ربع ساعة في مشروع آخر إلى قريتي خورشيد.

طول الطريق كنت أفكر كم أنا غبي؟ كاتب لامع مثلي تنشر قصصه على صفحة في ملحق الوفد الأسبوعي، ويشيد بي أصدقائي من المبدعين والصحفيين الشباب، لماذا أذهب إلى ندوة في قصر ثقافة، لا أحد يعرف من فيها، رجال يعيشون في قوقعة مع أنفسهم، وسيظلون مجهولين إلى الأبد، الغيرة جعلتهم يصمتون، ومن تكلم منهم قال “أي كلام”، أكيد أنا خطر عليهم بأعمالي البديعة، وشهرتي التي ستطبق الآفاق (يعني إيه؟ كنت أقرأها هكذا!)، ونمت قرير العين، فقد عرفت السر، أنا “تمام/زي الفل” مبدع موهوب عبقري، وهم جهلة مجهولون يغارون من بزوغي الوشيك!
مر يوم، يومان، وأنا لا أفكر فيما حدث، تجاهله عقلي تمامًا، فاستراحت نفسي، ثم أمسكت بالجريدة، فتحت صفحة القصة، تأملت اسمي المكتوب بخط عريض، شعرت بالزهو. أغلقت الجريدة. مرت فترة مجاهدة حقيقية، فتحت الجريدة مرة أخرى، لم أنظر إلى اسمي، بل قرأت القصة بعيني ذلك الرجل الذي علَّق عليها.
“القصة يا سيد منير على أفضل الأحوال متوسطة القيمة، لكنها مناسبة للنشر في الصحف لتسلي القراء، والحوار يغلب عليها فعلًا، ربما أنت متأثر بعلاقتك بالراديو أكثر من المجموعات القصصية التي تقرأها”. هكذا قلت لنفسي، وبدأت أعمل في اتجاهات ثلاثة.

الاتجاهات الثلاث
أولًا إعادة قراءة ما قرأت من مجموعات قصصية من قبل بعين جديدة فاحصة ناقدة محللة، في حدود قدراتي على فعل ذلك وقتها، وقراءة مجموعات أخرى جديدة.
ثانيًا الاستماع إلى التمثيليات والمسلسلات الإذاعية بالعين الفاحصة نفسها، وشراء كتب عن الدراما الإذاعية وأصول كتابتها، وشراء بعض الأعمال الإذاعية المنشورة في كتب، أذكر منها مجموعة تمثيليات لثروت أباظة، ونص مسلسل إذاعي اسمه “سرحان بشارة سرحان.. روبرت كينيدي يجب أن يموت”.
ثالثًا المواظبة على حضور ندوة الاثنين، أستمع إلى القصص المقروءة، والنقد الموجه إليها، وأعيد تنظيم دماغي وأفكاري وكتاباتي.
وقد أفادني ذلك لأصبح كاتبًا معتمدًا بإذاعة الإسكندرية بعد سنوات قليلة من التدريب على الكتابة للإذاعة (فالرجل الذي علق على قصتي اكتشف فيَّ هذه الموهبة ونبهني لها فانتبهت)، وحرصت على تجويد قصصي فبدأ النقد لها يصبح أقل فأقل. وتعرفت على رواد ندوة الاثنين والخريطة الثقافية في الإسكندرية، فعرفت من هو الجاهل الأحمق الجهول إلخ ما تشاء من صفات في هذا الاتجاه،.. قلت كل هذه الصفات لنفسي عن نفسي فلم تعترض!
الرجل الذي علق على قصتي ليس مجرد الرجل الذي علق على قصتي، إنه “سعيد بكر” أحد كبار كتاب مصر، والحائز على جائزة الدولة التشجيعية، والرجل الذي يقود الندوة هو “عبد الله هاشم” هو أحد أهم الفاعلين الثقافيين في مصر،
 أحد لقاءات ندوة الإثنين الحاشدة بمناسبة اللقاء مع أستاذي الكاتب الكبير محمد جبريل
أحد لقاءات ندوة الإثنين الحاشدة بمناسبة اللقاء مع أستاذي الكاتب الكبير محمد جبريل
الرجل الذي علق على قصتي ليس مجرد الرجل الذي علق على قصتي، إنه “سعيد بكر” أحد كبار كتاب مصر، والحائز على جائزة الدولة التشجيعية، والرجل الذي يقود الندوة هو “عبد الله هاشم” هو أحد أهم الفاعلين الثقافيين في مصر، وندوة الاثنين نفسها من أعرق وأقدم الندوات المصرية وكان من أعضائها كبار أمثال محمد حافظ رجب وإبراهيم عبد المجيد ومحمد جبريل وغيرهم.
الصحافة والأدب السكندري
كنت أمارس الصحافة في ذلك الوقت (الصحافة المحلية في الإسكندرية قصة مهمة لابد أن تروى يومًا) فقررت التعرف على أدباء الإسكندرية الكبار وإجراء حوارات صحفية معهم، قلت لنفسي إياك أن تطرح الأسئلة الغبية التي لخصها الصحفي في فيلم “لعبة الست” “أين ترعرعت سيدتي؟!”، ولكن؛ كيف سأطرح أسئلة ذكية وأنا لم أقرأ لهؤلاء الكتاب؟
اخترت الأسماء الأكثر ترددًا، وكل منهم سيدلني على غيره، سعيد سالم، مصطفى نصر، محمد الجمل، حجاح أدول، صبري أبو علم، رجب سعد السيد، أحمد محمد حميدة، د.حورية البدري، وغيرهم، كلهم لهم إصدارات مهمة، حصلوا على جوائز، كتب عنهم كبار النقاد…
كنت أذهب إلى الكاتب، أعرفه بنفسي كصحفي وأديب، أطلب منه نسخًا من كتبه، يعطيني ما تيسر له منها (تعهدت لأستاذ مصطفى نصر بإعادة بعضها لأنها كانت النسخة الوحيدة لديه) أعود بعد أسابيع إلى الكاتب الذي نسيني غالبًا، أعود وقد ذاكرته تمامًا، أحدثه عن أعماله، أربط بينها بطريقة تفاجئه أحيانًا، وهذ ميزة قراءة أعمال لكاتب كلها معًا وليس على فترات، أجري الحوار الذكي الذي أتمناه، وعند النشر أصيغ الحوار بحيث يكون مكان السؤال عدد من النقاط هكذا (……….؟) وتكون الإجابة مشيرة إلى السؤال، يبدو أن تواضعي وتحجيمي لنفسي وصل إلى أنني لم أضع كلمات أسئلتي بجوار كلمات إجابات هؤلاء المبدعين الذين لم يمنحوني فقط كتبهم، ولا وقتهم لإجراء حوار صحفي، بل أعطوني ما هو أهم؛ صداقة بها الكثير من الأبوة، وأبوة أدبية مليئة بالمحبة، لا أزال أمرح في حدائقها حتى اليوم، وأشعر بسعادة عندما أعلق على “بوست” لأحدهم بكلمة “أستاذي”، وبلغ من تواضع أحدهم “المبدع الكبير حجاج أدول” أن كتب لي على الخاص أننا أصدقاء ولا تكتب لي كلمة أستاذي، مع أنه فعلًا أحد أساتذتي الذين أحبهم وأقدرهم.

للأسف ضاعت هذه الحوارات الأولى لي كمحرر أدبي، وإن كنت أجريت بعد ذلك حوارات أخرى كثيرة مع مبدعين ومبدعات مصريين وعرب وأجانب، نُشرت في صحف ومجلات مصرية وعربية، ونشرت بعضها في كتابي (عن الكتابة.. السحر والألم)، لكنني سأظل أدين لهذه التجربة بالفضل، التجربة التي علمتني أن أشتغل على نفسي قدر الطاقة، أن أعرف نقاط القوة حتى ولو كان من ينبهني لها لا يقصد، وأشتغل عليها، وأن أعرف نقاط الضعف وأحاول تجنبها، وأنه ليس مهمًا كيف تكون البداية، ولكن الطريق الذي ستسلكه لتجعل الخطوات التالية أفضل، والأهم أن أعرف مدى جهلي، فليس معنى أنني لا أعرف فلان أنه مجهول، أو أنه بلا قيمة، لكن المعنى الوحيد أنني جاهل به وعلي أن أزيل هذا الجهل، أو أظل متخبطًا في ظلامه ولا ألوم سوى نفسي التي كثيرًا ما أمرتني بالكبرياء الغبية عند الصدمات المريعة!