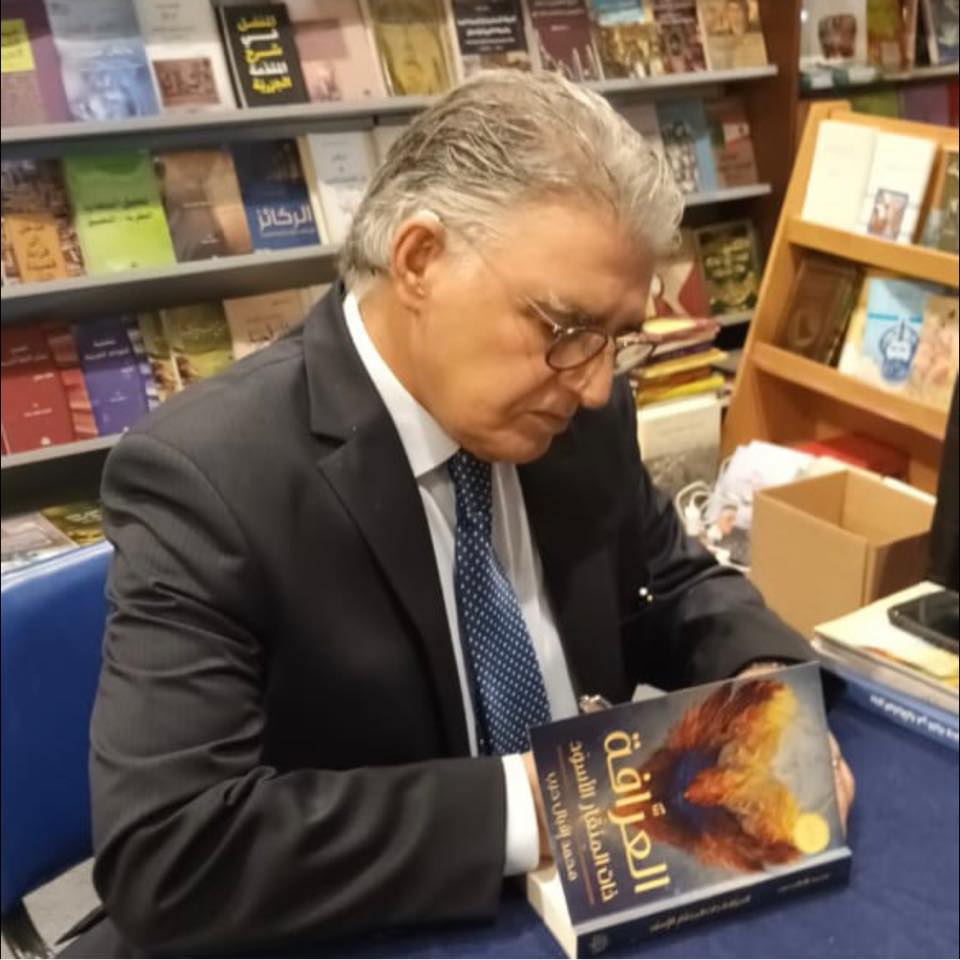
مداخلتي بعنوان “نظرة على مستقبل البشرية في الدورة المقبلة”. لكن اسمحوا لي أن
قبل ذلك أن أشاركَكم بعضَ المعلومات التي قد تعرفونها أو سمعتُم عنها.
- سنة1968، قام العالِم الأميركي جون كالهون John Calhon بتجربةٍ مُهمّةٍ أثارت ضجةً كبيرةً في عِلم الاجتماع عُرفت بالتجربة 25. بدأ بتوفير مِساحةٍ كبيرةٍ مُصمّمةٍ خصّيصًا للفئران، أمّن لهم فيها وَفرةً من الطعامِ والماء، ومِساحةً كبيرةً للعيش. بدأ بثمانيةِ أزواجٍ وما لبثت أن تزايدت بشكلٍ سريع. بعد وُصول العدد إلى 315 بدأ التكاثُر بالانخفاض. وما أن وصلَ إلى 600 فأر ظهر بينهم ما يُعرَف بـ “الميل إلى الانعزال”، وبعد ذلك ظهرت طبقةٌ عُرفت بـ “البؤساء” وبدأت الفئران الأكبر في الحجم مُهاجمةَ المجموعةِ الأصغر والأضعف مما أدى إلى انهيار نفسي لكثير من الذكور. كذلك تخلّت إناثُ الفئرانِ عن دورها في حمايةِ صِغارها وهاجمَت صِغارَ الأُخريات من دون سبب؟! ومع مُرور الوقت بلَغ مُعدّل وفيات الفئران الصغيرة 100٪ وانخفض مُعدّل الإنجاب إلى 0٪، وظهرت المثليّة الجنسية. أكثر من ذلك، فقد اقتاتت الفئرانُ لحومَ بعضِها البعض على الرغم من توافُر الطعام. سنة 1973 ماتت كلّ الفئران في هذه التجربة التي أُطلق عليها “universe 25”.
تمّ تكرار التجربة 25 مرةً، وفي كلّ مرّة كانت النتيجةُ هي هي، لذلك سُميّت بهذا الاسم.
- في دراسات مُوثّقة من ناسا سمعتُها خلال محاضرة ألقاها العالِم المصري د. فاروق الباز، رئيس قسم الجيولوجيا في وكالة ناسا، وتمّ توضيح النقاط في اليوم التالي في جلسةٍ خاصة، يبدو أن كوكبَ الأرض يمرُّ بدوراتٍ تغييريّة شاملةٍ كلّ 12 ألف سنة تقريبًا، يتغيّر خلالها محورُ الأرض، مع تباطؤ في سُرعتها ما يُحدثُ تدميرًا شاملًا للحياة التي نعرفُها وإعادةَ هيكلةِ جغرافيةِ الأرض. بما أن ذلك لا يحدُث بين ليلةٍ وضُحاها فإن التغيّراتِ المناخيّة وحركةَ الصفائحِ التكتونيّة تتغيّرُ ببُطء حسب شعورِنا بالزمن. وهذه التغيّرات قد تبدأ في أي وقتٍ قريب إن لم تكن قد بدأت فعلًا. هذه الدراسات مُثبّتة بصورٍ جيولوجيةٍ لآثار الدورات السابقة في الطبقات العميقةِ من سطحِ الأرض. على سبيل المثال، هناك آثارُ نهرٍ كان ينبع من الكويت ويصبُّ في البحر الأحمر من الجزيرة العربيّة مُرورًا بالربع الخالي. كذلك وجدوا أحافيرَ لبيض النَعام في مناطقَ سودانيّةٍ صحراويةٍ وأن الرُبعَ الخالي كان عامرًا بالحياة. لذلك، وبعد كلّ دورة لا يبقى من البشر إلا قلةٌ نادرة مشرذمةٌ يقعُ على عاتِقها إعادةُ بناءِ حضارةٍ بشريّة جديدة.
- نال د. زويل جائزة نوبل لقُدرته على قياس الفيمتو سكوند التي تساوي لحظة من مليون مليار جزءٍ من الثانية، كالمُقارنة بين الثانية و32 مليون سنة. خلال شرحه لفائدة ذلك، بطريقة مُبسّطة قال: لو صوّرنا البكتيريا التي تعيشُ دقائقَ بأسلوب الفيمتو سكوند لوجدنا أنها تُولد طفلة، تكبر وتتزوج وتنجب وتهرم. وذلك ما يعادل سبعين عامًا من سنواتنا.
انتهت النقاط الثلاث التي أردتُ عرضَها قبل المُداخلة.
المداخلة
يعتقد البشر أنّهم مميّزون عن باقي الكائنات، وأنهم من الأهمية بمكان ما يستدعي أن يمنحَهم الخالقُ حياة بعد موت كنوع من الخُلود. بل يُصرّون على أن مُستقبلَ البشريّةِ مضمون، إن لم يكُن على سطحِ الأرض ففي البُعد الآخر أو عوالمَ موازيةٍ عن طريق الإيمانِ بالغيبِ على تَعداد الدياناتِ الكثيرة أو لنظرياتٍ وفلسفاتٍ مُختلفة. ومن المُفارقات الغريبة التي لا تتناسب مع الفِكر الإنساني الذي نراه يزداد توهجًا، قياس الحياة والحضارة في الكون _ إن وُجدت_ بمقياسٍ بشري. أي أننا نعتقدُ، بل نجزُم أن أسبابَ حياتِنا مقياسُ أسبابِ الحياة في الكون غير متصوّرين إمكانيّة وجود حيوات كثيرة لا تحتاج إلى ماء وهواء أو أيّ نوع من الصفات البشريّة. أيضًا نُعمّم نحن البشرَ مقياسَ الزمنِ على باقي المخلوقاتِ بميزانِنا غير مُدركين أن الدقائقَ القليلةَ التي نرصُدها لدورةِ حياة البكتيريا الكاملةِ توازي سبعين عامًا من حياتنا كما وضّح د. زويل. لذلك من المُمكن جدًا ألا تساوي حياتُنا المديدة، برأينا، بضعَ دقائقَ في حياة كائن آخر. وهذا ما يجعل حركتَنا بالنسبة إليه دقائقَ لا يُعيرُها اهتمامًا، تمامًا كما حياة البكتيريا بالنسبة لنا.
من هنا يكون بحثُنا عن مستقبلِ البشريّةِ بمفهومِنا وقُدراتِنا البشريّة في المُستقبل البعيد أكثرَ أهميةٍ من المستقبلِ القريب. ما بنيناه كبشر على سطح هذا الكوكب منذ حوالى عشرة آلاف سنة هو ما حدّد واقعَنا ومستقبلَنا القريبَ وما سنفعلُه خلال المُستقبل المنظور سيحدّد مُستقبلَ البشريّةِ للدورةِ المُقبلةِ.
ساهمت عواملُ عدّة مُتراكمة ومُستمرة من بداية وجودِنا الإنساني إلى ما نحن عليه من تناحُر وصراعٍ مستمرين في نشرِ الكراهيّةِ وفلسفةِ سفك الدماء، إذ بتنا الكائنَ الوحيدَ الذي يُغذّي طموحاتِه وأحلامَه من خلال تعذيب بني جِنسه وقتلِهم وإفنائهم. لقد راكمنا وحفّزنا تلك “الطموحات” عبر وسائلَ كثيرةٍ أشعلت حروبًا فتّاكة لا تنتهي. يتذرّع كل فريق بمُعتقداته الدينيّة والقبليّة والعِرقيّة لتبنِّي فلسفةٍ تُحفّز على قتل وإفناء الأطراف الأُخرى تحت صُنوف من الشِّعارات والعناوين المقدّسة إما دينيًّا أو ثقافيًّا. بل افتخرت كلّ مجموعة بالقتلة فسمّتهم شهداءَ وأبطالًا فيما دمغت شهداءَ الطرفِ الآخر بالإجرام والإرهاب. هذا التراكُم من الكراهيّة والضغينة بين المجموعات البشريّة يرتكزُ على مُواصفات ترسّخت عبر العُصور بقُدسيّة غريبة. وقد أضحت هذه المواصفات التي كان لها الأثرُ الأكبرُ في صيرورتنا الحاليّةِ بأهميّة الجينات الوراثيّة من حيث تأثيرِها على وجودنا البشري. نذكر منها:
- الأعراق
- الديانات
- المعرفة
- الروحانيات
- المادّة
- العقل البشري
ليست هذ العوامل جديدة على البشريّة، بل قديمة قِدَم الإنسانِ الذي غذّاها وتفنّن في سُبل تنفيذها. فالقتلُ والكراهيّة وحُبّ السُلطة والصراع بين المجموعات البشريّة كلِّها واحد لم يتغيّر. الذي تغيّر هو سُبل تنفيذِها وإعطاؤها أسماءً مختلفةً وأدواتِ تنفيذ تتناسب والعصر الموجودة فيه. لن أدخلَ في تفاصيل كل واحدة من هذه العوامل لأن المجالَ لا يسمحُ بتفنيدِها على حِدةٍ، إذ يحتاج كلُّ عامل إلى مُجلّدات من البحث والتمحيص. لكن لو فكّرنا في كلّ منها بتجرُّد سنصلُ إلى صِلتها بطريقة أو بأُخرى بموجاتِ الكراهيّةِ المُعشّشة في القلوب بنِسب مُتفاوتة. وسنُدركُ أن حتى المُتعلّمين والمُثقّفين قد يكونون العاملَ الأذكى في نشر الدمار والخراب. أليس ذكيًّا من اخترع البارود والقنبلة الذريّة؟ أليس عبقريًّا من أقنع آلافَ، بل ملايين البشرِ بعظمةِ سفكِ دماء الإنسانِ الآخر لأسباب دينيّة وعرقيّة في كلّ بُقعة من بقاع الأرض وعِبر كلّ إثنيّة وعِرق كُلّما سنحت الظروف؟ الغريب أن كلّ منظّري وروّاد بني البشر يتبنَّون المبادئَ نفسَها بطُرق مختلفةِ تدّعي نقاءهم وتلوّثَ الأطرافِ الأخرى، ولم يجدوا وسيلةً أنجعَ من قتل الأطرافِ الأُخرى لبناء صرحِهم الدّاعي إلى المحبّة والسّلام، سلامٍ مبني على أجداثِ وأشلاء الأطراف الأخرى. قرأت بحثًا، منذ أيام، حول ضحايا الحروب التي قامت على أُسس دينيّة عبر الألفيتين الفائتتين وقد بلغ العدد أكثر من 500 مليون بشري والبحث في كتاب
War and Peace In Islam . أليس غريبًا أن تُزهَق هذه الأرواحُ باسم المحبّة والسلام والرحمة؟ أليس ضعيفُ الحُجّة هو الأكثر توحّشًا؟
لا يجدر بنا التغاضي عن التطور التكنولوجي، في ثورةٍ علميّة مُدهشة، الذي نما وترعرعَ بسُرعة غير مسبوقة خلال النِصف الثاني من القرن المنصرم وأدّى إلى رَفاهيّةِ الفِكر الإنساني بإبداع غير مسبوق. لكن لم يترافق مع تطورٍ وِجداني موازٍ مما دفَع إلى ضُمور المناقِب البشريّة وتحفيزِ الفرديّة وزيادة الرفاهيّة التي قال عنها ابن خلدون منذ 900 سنة إنها السبب الرئيس في انهيار الأُمم.
لنَعُد إلى تجربة 25 التي قام بها د. جون كالهون ونأخُذ المغزى المُفيد وهو تحوّل الجنّة إلى جحيم بسبب الازدحام وسقوط القِيم ومن ثَمَّ الانقراض، حسب دِراسة نشرتها مجلة Smithonian الراقية. وهذا ما يحدث حاليًا لبني البشر على الكوكب، بالطبع ليس حرفيًا كما حصل للفئران. ففي المناطق الفقيرة المُتزايدة حول العالم أدّت الكثافةُ السُكانيةُ إلى انتشار الأوبئة وارتفاع مُعدّل الجريمة وعددِ العاملين في تجارة المخدّرات وترويجها وباتت منجمًا للإرهاب والرذيلة. وفي المناطق الغنيّة والمتوسطة ازدادت الإباحيّة والفردانيّة التي تُغذّيها التكنولوجيا الموجّهة حتى بتنا نلحظُ التغيّرَ السريعَ في القِيم والأخلاق وأصبحنا نحن الجيلَ القديم جِدَّ غرباء عن الواقع الحالي لكننا مضطرون لمُعايشتِه في ظلّ القوانين التي سعت بعض الحكومات، لعقود خلت، إلى حماية كلّ ما كان مُحرّمًا. ولا ننسى الموجة الأخيرة التي شرّعت المِثليّة الجنسيّة في عدد من الدول ما قد يساهم في تقليص الولادات وتغيير القِيم والأخلاق التي تربى عليها أبناءُ كوكب الأرض سواء من خلال القوانينِ الدينيّة أو المدنيّة. الغريب أن التصالُح الاجتماعي حول هذه النقاط يخضع لديكتاتوريّة ناعمة تُمرّر دساتيرَ الفناء من خلال الإعلام والقوانين الداعمةِ والتعليم المُمنهج لتدمير النَّشء الجديد. وفي الشقّ الاقتصادي نرى أن 80% من موارد كوكبنا تمتلكُها منظّمات وشركات خاصة وسريّة من ماسونيّة وعائلات من بينها روكفلر وروتشيلد ومجموعات هيدلبرغ. هذه الجماعات هي المُصنّع الرئيسي للحروب وترويج المخدّرات وتفتيت القِيم من خلال نشر العُنف والرذيلة عبر وسائل الإعلام. ألم يكن قرارُ ديزني لاند، في العام الفائت، أن يكون 25% من إنتاجِها الإعلامي للتوجيه المثلي للأطفال والشباب، بعد الحصول على تشريعات قانونيّة تدعم قرارَها الناجم عن ضغوطات من “لوبيات” خفيّةٍ تعملُ على تنفيذ خِطّة ما ليست في صالح البشريّة.
حتى لا أُطيلَ، أعترفُ بأن من الصعوبةِ بمكان، بل من المُستحيل التنبؤ بمُستقبل البشريّة على المدى المنظور، لا سيما بعد فضائح تصنيعِ الأوبئةِ ونشرها، من الجمرةِ الخبيثةِ وإيبولا إلى كوفيد 19 وأسرته اللعينة إضافة إلى تشجيع صناعة الحُروب من قِبل مصانع الأسلحةِ على مساحة الكوكب، التي تعمل على نشر فلسفةِ القتل عبر نشر العُنف، بداية من ألعاب الفيديو التي أصبحت أكثر إدمانًا وفتكًا من أي سلاح، وإدخال مظاهر القتل في معظم الأفلام حتى الرومانسية منها، وما ذلك إلا لنزع الرحمة من قلوب الأطفال والشباب، ناهيك عن شراسةِ الدول الكبرى بخاصة عصابةُ الدولِ الصناعيّة السبع التي تستعبِدُ دولَ إفريقيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وشرق آسيا ذات الثروات الطبيعية الهائلة. فمثلًا، نرى أن فرنسا تتمتّع بِطاقة نظيفة، رخيصةٍ تحصل على مُعظمها من خلال المُفاعلات النوويّة في النيجر التي تعتمد على مادة اليورانيوم فيما 90% من سكّان هذا البلد يعيشون في ظلام دامس. العمل على تدمير أو تفكيك دولٍ كثيرة واعدة حول العالم لا يعطي أملًا بمُستقبل إنساني واعد، مما يُسعد ثُلّة من عديمي المشاعر والأخلاق في الدول العُظمى.
أخيرًا، وبعدما تكلّمنا عن العوامل التي تقف حاجزًا أمام بشريّة مُتناغمة، مُتوازنة خالية من العُنصريّة والكراهيّة، سأنتقل إلى المُستقبل البعيد الذي أرى فيه بصيصَ أمل لن أعيشَه لبُعده. لا بد من أن نكون واقعيين من ناحية اقتراب انتهاء دورة الحياة البشريّة الحاليّة من منظور علمي يخمّن ذلك.
من هنا أرى أن العملَ على الإصلاح الجَذري الكوني غير مُمكن، فالإصلاحاتُ المُقترحةُ من خلال هذا المؤتمر أو غيرِه من المؤتمرات الرسميّة لن تكون أكثر من ضماداتٍ تُخفي أسبابَ المشكلةِ الرئيسية وجوهرَها. فها هي مُشكلةُ الاحتباس الحراري التي تُعتبر وجوديّةً بالنسبة إلى البشر لم تجد آذانًا صاغيةً من معظم القِوى الكبرى التي تُساهم في تدمير طبقة الأوزون رغم كل المقرّرات والاجتماعات. من هنا نرى أن تصحيحَ المسار يبدأ من بناء الإنسان بأسلوب ينبُذ العُنفَ والكراهيّة بكل الأطياف وهذا، للأسف، بيد رواد الحروب والكراهيّة.
اقترابُ الأرضِ من موعد تغيير محورِها وجغرافيتِها من خلال انقلاب مغناطيسي يترافق مع عواصفَ مغناطيسية. وأعني باقتراب انتهاء الدورة حوالى قرن أو أكثر من الزمن. لذلك إذا كنّا حريصين على مُستقبل البشريّة على سطح هذا الكوكب علينا أن نفكّر في إنسان الدورة المقبلة حتى لا تكون إعادة للسيناريو الذي تكرّر مرّات لا نعرفها في لولبية “Deja Vu ” المستمرة منذ آماد طويلة. برأيي، ستعتمد المرحلةُ المُقبلة في دورة الكوكب الجديدة كليًّا على نوعيّة من سينجو من البشر ليبدأ حياة جديدة. لو افترضنا أن أكثريّة الناجين كانوا من الناس البُسطاء فإن تطورَهم سيستغرقُ قرونًا من التجارب كما حصل في دورتنا. أما لو كان الناجون من أصحاب العِلم والمعرفة والقُدرة على مُواجهة الطبيعة فستَختصر المرحلةُ الجديدة عشراتِ القرون ليصلوا إلى مرحلة متقدّمة أسرع من دورتنا. ذاك ما قد يوفّر على البشرية المُقبلة سنوات من التخلّف والعيش البدائي. لكن الأخطر هو أن يحمِل الناجون، وهذا ما قد حصل مع دورتنا، كما أُخمّن، موروثات العنصريّة والطائفية والكراهية وتصنيف البشر لبعضهم البعض درجات سامية وأخرى حقيرة مما ينشر فيروسات التفتُّت منذ البداية. لذلك يجب التركيز سريعًا على القضاء على هذا الوباء حتى ينعمَ الجنسُ البشري بدورة جديدة في وقت مُبكر تمكّنه من النجاة من كارثة التغيّر الكوني قبل حدوثِه.
ربما، بل الحقيقة أن كثيرين يعتقدون بأن ما أقولَه هو مجرّدُ خيالٍ واهٍ لا أصلَ له. لكنني مؤمن بأن مُستقبلَ البشريّة الحالي لا يُبشّرُ بالخير الكثير قبيل الفناء، وأفضلَ ما يُمكننا القيام به هو تحضيرُ البشريّة وتحذيرُها من نقلِ سُموم هذه الدورة التي يحياها جنسُنا منذ ما يقارب عشرة آلاف سنة إلى الدورة الجديدة. وذلك من خلال إقامة مراكزَ في أماكنَ يختارُها جيولوجيون كمكان آمن من الدمار على غرار مُستعمرات مُستقبلية لجيل خال من الكراهيّة والعنف، مسلّح بالعلم والمعرفة القادرة على إعادة بناء الكوكب من خلال سُلالة لا تؤمن بالعُنف والعُنصريّة والتلذّذ بقتل بني جنسها.
في النهاية، أؤمن بأن الجنسَ البشري الذي استمرّ وتطوّر عبر الثلاثة ملايين سنة الفائتة في سُلالات لا يمكن معرفتُها إلى ما وصلنا إليه من مخلوق ذكي، منتصب القامة، سيطر على باقي الكائنات وعاث فسادًا في الأرض تحت شعار “المخلوق المثالي” وبنى وأبدع وتألق كسيّد للمخلوقات كما يراها ويزعم، سيبقى إلى آجال ودروات كونية مديدة. لكن السؤال هو كيف سيستمر؟ وهل سنشهد عصرًا جديدًا، إنسانيًّا بامتياز؟
- ألقيت المحاضرة في المؤتمر الثاني للمنتدى الثقافي الأسترالي العربي “الانفتاح على الذات وعلى الآخر – قراءة في سمات اللحظة البشرية القادمة” في 10 أيلول 2023





