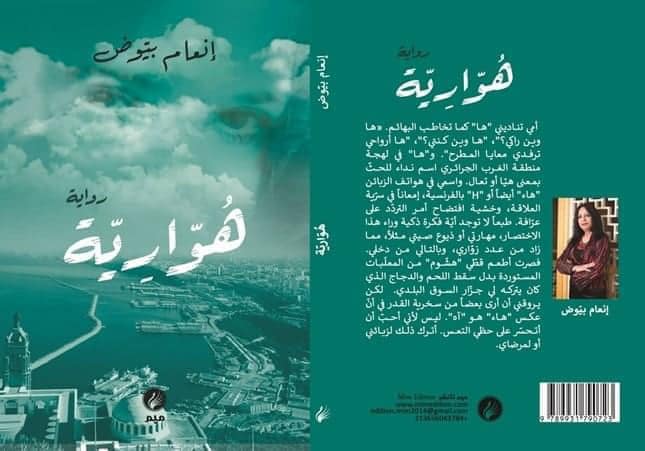فاتن فوعاني

“أنا أعرف نفسي تعبتُ من جرّها إلى حيث لا تشاء مريضة تجهل ما تريد”
يا يوسف حبشي الأشقر يا ملحمة الملاحم كيف انقضت ثلاثون غيابكَ كأنّها كذبة؟
عقل العويط
ثلاثون مرّت يا يوسف حبشي الأشقر (1929-1992). ثلاثون سنةً كأنّها أمس الذي عبر. فكيف مرّ كلّ هذا الذي مرّ، وكيف انقضيتَ، وقضيتَ، علمًا أنّك بيننا الذي تعرف أقداركَ ومصائركَ، علمًا أنّك لا تعرف. علمًا أنّ أبطالكَ وشخصيّاتكَ كلّهم كانوا، يا يوسف، لا يعرفون مصائرهم وأقدارهم. علمًا أنّهم كلّهم كانوا يعرفون
المرأة، والرجل، الريفيّ، والمدينيّ، والمثقّف، واليساريّ، والغنيّ، والفقير، والعبثيّ، والمقامر، والمنتحر، والمتشائم، والمتفائل، واليائس، والمقاتل، والمسالم، والكاره، والحاقد، والحالم، والحزبيّ، واللّاحزبيّ، والمحارب، واللّامحارب، والطائفيّ، واللّاطائفيّ، والعارف، والجاهل، والمؤمن، واللاأدريّ…، كلّهم كانوا يذهبون إلى أقدارهم ومصائرهم، ويلاقونها، كَمَن يذهبون إلى مواعيدَ واستحقاقاتٍ عابرة، وفي اعتبارهم أنّهم سيعودون بعد تحقيقها وانقضائها، إلى حروبهم، إلى طواحينهم، إلى أحلامهم، إلى عزلاتهم، إلى طموحاتهم، إلى انكساراتهم، سيعودون إلى أيّامهم، إلى أمكنتهم، إلى أزمنتهم، إلى حيواتهم العبثيّة النكراء، لمواصلة مصائرهم وأقدارهم. وأيّ مصائر، وأيّ أقدار
كان أبطالكَ وشخصيّاتكَ، يا يوسف حبشي، لا يعرفون. وكانوا يعرفون

كانوا يحملون معاصيهم، وبراءاتهم، وسذاجاتهم، وانتحاراتهم، ومقتلاتهم، وموتهم المحتوم؛ كانوا يحملونها في أرواحهم المعطوبة، في أجسادهم التي كانت لا تطيق أجسادهم، من فرط التصاقها بتراباتها، بغيومها، بشهواتها، برغباتها، وبجدرانها المسدودة
وكانوا يحبّون الحياة، يا يوسف حبشي الأشقر، وكانوا يكرهونها، وكانوا يعيشونها، وكانوا يهرسونها، وكم كانوا يستشهدونها، وكم وكم كانوا ينتقمون منها
لو كانوا يدرون ماذا فعلوا بكَ، وماذا كانوا يفعلون، وماذا كانوا يريدون أنْ يفعلوا بكَ غدًا وبعد غد، لكانوا ربّما أحجموا، أو تردّدوا قليلًا. بل ربّما كانوا فعلوا المستحيل وشبه المستحيل ليغيّروا ما بأنفسهم وما بأجسادهم، خشيةَ أنْ يعتريكَ ما اعتراكَ من جرّائهم. الأبطال والشخصيّات عندما يذهبون بعيدًا في رؤوسهم ومخيّلاتهم ومقامراتهم، يستولون على الكاتب – وأنتَ أدرى بذلك يا يوسف – فيستولي السحر بل ينقلب على الساحر، ويصير، هو، أي الكاتب – الساحر، يصير بين أيديهم، ألعوبةَ أيديهم، وفريستَها، بدل أنْ يكونوا هم الألعوبة وهم الفريسة
أهكذا انقلب سحركَ عليكَ، يا يوسف؟
كلّما عدتُ إلى كتبكَ، إلى قصصكَ الأولى والثانية والثالثة، وإلى رواياتكَ، إلى قريتكَ، إلى مدينتكَ، انبرى في وجهي أبطالكَ هؤلاء، وشخصيّاتكَ، كلٌّ منهم حاملًا اسمه وكنيته – أما كانوا يا ترى يحملون (خفيةً) اسمكَ وكنيتكَ وعمركَ وجسمكَ وروحكَ وغليونكَ وسخريتكَ ومرارتكَ وقلقكَ وهجسكَ وسؤالكَ وعبثكَ الوجوديّ المرير؟! -، وكأنّ كلًّا من هؤلاء كان يطلب من القارئ – أيًّا يكن – أنْ يكفّ عن التأويل والبحث والسؤال والالتباس، لأنّه لن يتراجع، ولن يعيد النظر في ما هو سائرٌ إليه من أقدارٍ ومصائر
أإلى هذا الحدّ، أسلستَ لهم القياد، يا يوسف؟ أإلى هذا الحدّ، حدّثتْكَ نفسُكَ بأنّ الكاتب إنّما هو أبطاله وشخصيّاته، مهما استقال منهم، ومهما انزاح عنهم، ومهما توارى، ومهما ترك لهم حرّيّة القرار والخيار؟
ليتكَ لم تفعل، يا يوسف. ليتكَ لم
لكنّكَ كنتَ عارفًا بما يضمرون، وبما يكشفون، ولكنّكَ كنتَ – يا لانتحاركَ الوجوديّ المفتوح – لا تأبه، ولا ترعوي، ولا تكفّ، ولا تتراجع
وما الروائيّ الروائيّ إذا لم يكن هكذا، على منوالكَ، على سجيّتكَ، على فلسفتكَ، على جموحكَ الوجوديّ العبثيّ الدفين الدفين؟
أهي القرية، أهي كفرملّات، فعلتْ بكَ هذا كلّه، يا يوسف؟! أهي المدينة، أهي بيروت، أهو لبنان، يا ابن الأشقر؟
لم يعد ذلك مهمًّا، يقول لي قائلٌ. ويقول آخر مستفهمًا: لقد مات الكاتب البطل، أيّها القارئ، مذ قتل بطلَه المفضّل، وشخصيّته المفضّلة. فلمَن، والحال هذه، كنتَ تكتب، يا يوسف، في غياب البطل، عارفًا أنّ الكتابة ليست عزاءً، وأنّها كذبة؟ أتكتب للراوي؟ أم تكتب للشاعر؟ أم تكتب للمناضل؟ أم تكتب للمقامر؟ أم تكتب للغنيّ؟ أم تكتب للعشيق؟ أم تكتب للمنتحر؟ أم تكتب للمقاتل؟ أم تكتب للميليشيويّ؟ أم تكتب للطائفيّ المذهبيّ؟ أم تكتب لرجل الدين؟ أم تكتب للعلمانيّ؟ أم تكتب للكافر للملحد للاأدريّ للعابث اللامبالي؟
لا. لم يمت الكاتب. ليس صحيحًا أنّه مات. لو أنّه مات، لو كان ميتًا، لما كان في مقدور أبطاله وشخصيّاته أنْ يتقمّصوه، أنْ يأخذوا بيده، بقلمه، بحبره، ليواصلوا كتابة أقدارهم ومصائرهم، كما لو كانوا هم الكاتب
لا يحيّرني ما كتبتَه، يا يوسف. بل يفترسني. لأنّكَ مفترس. وأنتَ كنتَ تفترس، لا بهمجيّة الوحش، بل بقَدَر المنتحر، وبذكاء المايسترو الرائي، المتخفّي، الحاذق، الجاثم وراء الوقائع، في المتاهات، في الأمكنة، في الأزمنة، في الأروقة، في الدهاليز، في تداخل التقنيات والأساليب، في تماهيها، وانسياباتها، وخروجها على المعقول، على اللّامعقول، لتتشمّس، لتنسى، لتهرب، لتتعزّى (هل كانت تتعزّى حقًّا؟!) في لحظات الهدنة، في لحظات الصمت، في لحظات النوم والحلم، لتعود تواصل عمل النهش المنتظم، بقَدَريّة مَن لا يفقد جنون حيويّته الهادرة، المتدفّقة، السلسة، المتماسكة، المتناسقة، على تعدّد الأصوات والنبرات والإيقاعات، المتمسّكة بالنواصي، وهي تقود الدفّة، وتمسك بالبوصلة، وتتحكّم بالاتجاهات
حتى الافراح تتكاثر
وإذ أرى هذا كلّه، أقول في نفسي، كيف استطعتَ، يا يوسف، أنْ تمزج الواقع البسيط بالواقع المركّب – المعقّد؟ وكيف جعلتَ القرويّ ينزل إلى بيروت فيصير بيروتيًّا من دون أنْ تُستأصل جذوره، أو يستأصلها؟ وبقي يفعل ذلك، ويفعل العكس، بدون افتعالٍ ولا اصطناع. ثمّ كيف استطعتَ أنْ تضع في فراشٍ واحدٍ، وتحت سقفٍ واحدٍ، وفي بنيةٍ شموليّةٍ واحدة، حنونة وصارمة، متحرّكة ومغلقة ومفتوحة، كلّ هذه الأحداث والوقائع والفانتازيات والفلسفات والأفكار والنظريّات والمتخيّلات والتراثات والبداهات والأساطير والخرافات والثرثرات والاختصارات والحوارات والأوصاف والسرديّات والحكم والمأثورات والأقاويل، وكلّ هؤلاء الناس، وكلّ هؤلاء الأبطال والشخصيّات… في رواية؟
لعجبٌ عجاب ما قمتَ به، يا يوسف. عجبٌ عجاب أعمالكَ القصصيّة الريفيّة القرويّة. عجبٌ عجاب ثلاثيّتكَ الروائيّة الفذّة، وهي ملحمة الملاحم. وهذه الانسجامات المذهلة، الجامعة في البوتقة الأموميّة، مجملَ التمزّقات والشروخ والالتئامات والتناقضات والتطلّعات والأحلام والكراهات والأحقاد والكوابيس والمنامات والأوهام المكسورة والمطحونة والممعوسة، بين مختبر كفرملّات ومختبر بيروت، اللذين صارا – يا للعجب العجاب – مختبرًا روائيًّا فريدًا من نوعه في العربيّة الحديثة
وها أنا أستنطق اسكندر الحمّاني، وأنسي، ويوسف الخرّوبي، وميرا، ومونا، ومها، ومارت، وباولا، وميشال، والمنتحر، واليساريّ، والغنيّ، والمثقّف، والعدميّ، والعبثيّ، سائلًا إيّاهم هل رأيتم يوسف، هل سترونه؟ وإنّي أسألهم لأنّي أريده هنا والآن، ليرى أين انتهى أبطاله وشخصيّاته، وأين انتهت بيروت، وكفرملّات، وأين انتهى لبنانه
- لا شيء لي يا حبيبي/ ميسون أسد
- حكاية قلب بايعَ الكتب
- قراءة أنثروبولوجية لأغنية “بنت الجيران” لحسن شاكوش وعمر كمال
- غرفة 19 تقدم: عطر ودماء للكاتب يوسف طراد
- شربل داغر: فينوس خوري-غاتا عائدة من عالم الموت
ولأنّي عارفٌ أنّكَ عارف، ما رأيكَ لو تكتب لنا الرواية التي لم يكتبها أحد، والتي لن يكتبها أحد؟
رواية، لا عن الدمار والخراب والتفكّك والزوال واليأس والانتحار والموت والجدران المسدودة واللّاجدوى في حياتنا وبيروتنا وكفرملّاتنا ولبناننا فحسب، بل عنكَ بالذات، وأنتَ تتقمّص حياتكَ وموتكَ وأبطالك وشخصيّاتكَ وأمكنتكَ، وهم يتقمّصونكَ
وماذا لو سألتُكَ “خدمةً” صغيرةً فأظلّ حاملًا دينها ما حييتُ؟ ألا تجد معي أنّ هؤلاء الوحوش الذين يصطادون حياتنا وبلادنا، ألا تجد معي أنّهم يستحقّون مقصلتكَ الروائيّة؟
وبعد، كم نحن في حاجةٍ إليكَ يا يوسف الروائيّ. وكم أنّ الثلاثين سنةً التي مرّت، هي كالذلّ الذي أنتَ كتبتَ عنه، وقلتَ إنّه سويّة الموت. سلامي إليك، يا ملحمة الملاحم