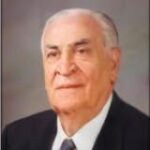الباحث الدكتور عبدالملك مرتاض لا يخاف الحداثة :
* ليتذكر المؤرخون المنصفون أننا أعطينا للأوربيين أكثر مما أخذنا منهم
* ختمت القرآن الكريم ، وتعلمت مباديء الفقه ، وأصول اللغة العربية
وعمري 11 عاما لا أكثر
* أصبت بمرض صدري، جئت به من فرنسا لأنني كنت أعمل أعمالا شاقة ، وأنا لا أزال فتى غض الإهاب
* أطروحة دكتوراة ” فن المقامة في الأدب العربي ” هي أول دكتوراة تمنحها جامعة الجزائر في عهد الاستقلال
* عدت من بلدة ” مسير “، وانا أمتطي حمارا، وبيدي كتاب النحو الواضح للاستاذ علي الجارم
* نبهني أستاذي إبراهيم الكتاني إلى أهمية أن أدرس الأدب الجزائري ، و لفت نظري إلى أن هناك حقولا معرفية لا يعرفها سوى القليل من الناس
* أول كتاب نشرته كان ” القصة في الأدب العربي القديم ” بعدها تفجر ينبوع التأليف وصار لي حتى الآن حوالي 42 كتابا
* هناك أسماء تتعامل مع النقد الحداثي لأنها تستفيد من المنهج الأوربي
* حين أحاول أن أعالج قضية من القضايا النقدية في الوقت الراهن أركز على أنني دائما ما أنطلق من تراثي العربي الإسلامي
* ألف أحمد البحوحو أول رواية جزائرية ، تجري أحداثها في الأجواء السعودية
* اللغة هي مفتاح المعرفة ، من أجل ذلك اتجهت أنا والغذامي إلى معالجة قضايا فكرية واسعة

الباحث والأكاديمي الجزائري الدكتور عبدالملك مرتاض له رحلة طويلة من التعب والمعاناة بدأها في دروب الجزائر والثورة تشتعل ضد الفرنسيين ، واستمرت مع سفره إلى فرنسا كي يعمل أعمالا شاقة ليكسب لقمة العيش ، ليعود مصدورا ، ثم سفره إلى جامعة القرويين ، وحصوله على شهادة جامعية قبل أن يلتقي صدفة بمستعرب فرنسي حوّل مسار حياته تماما حين جعله يسجل في السربون ويبدأ رحلة شيقة للبحث الأدبي والمعرفي.
رحلة شاقة نبدأها من الطفولة ، كما تعودنا ليكون سؤالنا التقليدي في زاوية ” بداية مشوار ” ،عن البدايات ، ليحدثنا بعد ذلك عن حياته ومسيرته الثقافية والفكرية التي امتدت بالكلمة المسؤولة والحرف المضيء حتى اليوم.
* ننطلق من الطفولة ، والمكونات الأولى التي شكلت شخصية عبد الملك مرتاض . فمتى وأين ولدت ؟ وما مكوناتك الأولى؟
ـ شكرا ل اليمامة ، وشكرا للمملكة العربية السعودية ، واسأل الله أن يحفظ العرب في كل مكان . عبد الملك مرتاض ولد في 10 يناير سنة 1935، ببلدة ” مسردة ” ولاية تلمسان بالجزائر ، بعد خمس سنوات قضيتها في بيت أقرب إلى أن يكون بدويا منه إلى أن يكون ريفيا أدخلني الوالد الكتاب لأحفظ القرآن الكريم ، وقد كان الكتاب يبتعد عن البيت زهاء كيلو متر ونصف ، فكنت أتردد على الكتاب ، وابتدأت أقرأ القرآن الكريم ، وختمته إحدى عشرة ختمة ، وسني في الحادية عشر تقريبا ، وقد كلفني الوالد ـ وكان إمام مسجد “الخماس ” ـ أن أصلى التراويح جماعة ، وعمري إثنا عشر عاما تقريبا ، وتعلمت منه مباديء الفقه ، وأصول اللغة العربية ، فكنا ندرس مع مجموعة قليلة من حفظة القرآن ، كنا نتعلم ” المرشد المعين في الضروري من علوم الدين “، وهو منظومة للشيخ عبد الواحد عاشر على مذهب الإمام مالك ، وفي الوقت نفسه كنا نتلقى بعض الدروس في مباديء النحو العربي ، وبعد أن بلغت السادسة عشرة أو نحوها أردت أن التحق إما بالجامع الأزهر أو بجامع القرويين بفاس بالمغرب، ولكن الوالد لم يكن يملك شيئا ؛ فقد كانت الأسرة تعيش في فقر مدقع ، فاضطررت إلى الهجرة إلى فرنسا من أجل العمل ، وعمري سبعة عشر عاما ، وهناك عملت خمسة عشر شهرا ، وجمعت قليلا من النقود ، والتحقت بمعهد عبد الحميد بن باديس صاحب الحركة المعروفة ـ هذه الشخصية كتبت عنها أكثر من مقال عندكم بالمملكة ـ وهو رئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر ، وكان يتهم بأنه على سنن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، والحقيقة أن الحلقة الاصلاحية في الجزائر لا تبتعد كثيرا عن الحركة الوهابية في المملكة .
إذن أسس هذا المعهد لتعليم اللغة العربية بقسنطينة ، وتابعت هناك ستة أشهر ، أصبت بعدها بمرض صدري( السل ) ، ويبدو أنني كنت قد جئت به من فرنسا لأنني كنت أعمل أعمالا يمكن أن توصف بأنها شاقة ، وأنا لا أزال فتى غض الإهاب ، وقد التحقت بعد ذلك بجامعة القرويين بفاس ، كان ذلك في سنة 1955 ، أما فرنسا فقد ذهبت إليها سنة 1953 ميلادية .
لم أدرس في جامعة القرويين إلا شهرا واحدا تقريبا ، واستفحل المرض ، وبدأت أتقيأ دما ، فأدخلت إحدى مستشفيات فاس ، وكانت العناية الطبية مكثفة ـ وقاك الله شر هذا المرض ـ وشفيت منه والحمد لله .بعد مداواة زادت عن ستة أشهر .
من بعد ذلك كان المغرب العربي قد استقل ، وكانت الثورة الجزائرية على أشدها ، وكان الجزائريون المقيمون على الحدود المغربية الجزائرية ، وأنا منهم يهاجرون إلى المغرب الأقصى، وفي هذه الآونة أعلن خبر عن تنظيم مسابقة لاختيار مدرسين في مدرسة ابتدائية بمدينة ” وجدة ” المغربية ، فشاركت في هذه المسابقة ، ونجحت والحمد لله ، وقيل لي أنني كنت من الأوائل ، وعينت بمدينة ” وجدة ” ، ولكنني اعتذرت والتحقت بمدينة ” أخضير ” حيث كانت تقيم أسرتي .
بعد خمس سنوات من التدريس في حقل التعليم الابتدائي كنت أتعلم اللغة الفرنسية بالمراسلة مع المدرسة العالمية للمراسلة باللغة الفرنسية بباريس . أديت امتحان الشهادة الابتدائية باللغة الفرنسية ، ونجحت ، وفي السنة نفسها ترشحت لنيل القسم الثاني من الشهادة الثانوية بمدينة ” تطوان” في معهدها الديني فنجحت ، وسجلت بجامعة الرباط ، وبعد ثلاث سنوات ( 1960 ـ 1963) حصلت على شهادة الإجازة في الأدب ” الليسانس ” كما حصلت على شهادة التربية وعلم النفس من المدرسة العليا للأساتذة بالرباط ، وعينت بثانوية مولاي يوسف بالرباط ، ولكنني اعتذرت للأخوة المغاربة ، والتحقت بالجزائر للإسهام في نشر اللغة العربية بها ، وبدأت أدرس بالتعليم الثانوي ـ هذه المرة ـ بمعهد ابن باديس .
معهد ابن باديس هذا درست به في قسنطينية ، ثم بدأت أدرس في مؤسسة أخرى تسمى ثانوية ابن باديس بمدينة وهران في الغرب الجزائري ، وفي الوقت نفسه ظللت منشغلا في التحصيل ، فحاولت أن أتسجل في الماجستير والدكتوراة إلى أن أفلحت في أن أتسجل في جامعة الجزائر، مع الأستاذ الدكتور إحسان النص من سوريا وكان مدرسا بالجزائر، وهنا افتح قوسين أسجل بينهما أن الأخوة العرب جميعا أسهموا في بداية استقلال الجزائر في نشر اللغة العربية ، وأغلق القوسين . منهم مدرسون كنت أعرفهم شخصيا ، كان من بينهم أستاذ سعودي يدرّس بالتعليم الثانوي ونسيت اسمه مع الأسف ، كان هذا المعلم جاري في مدينة وهران ، فشكرا للمملكة بمناسبة تذكري هذه الواقعة .
ناقشت أطروحة دكتوراة الحلقة الثالثة حول موضوع ” فن المقامة في الأدب العربي ” في 7 مارس ” آذار ” 1970 ، وكانت أول دكتوراة تمنحها جامعة الجزائر في عهد الاستقلال ، لكنني لم اقتنع بهذا ، وهو أمر طبيعي ، فأردت أن أحصل على دكتوراة الدولة ، لأن نظام التعليم الفرنسي كان يقوم على نظامين : الأول دكتوراة الحلقة الأولي ، ودكتوراة الدولة ، وهي أرقى وأعلى .
فتسجلت أول مرة مع الدكتور عباس الجراري بجامعة الرباط ، وأنجزت العمل ، ثم كانت هناك ظروف سياسية قاهرة منعتني من مناقشة تلك الأطروحة بجامعة الرباط ، فحاولت أن أحول تسجيلي إما إلى بغداد ، وإما إلى دمشق ، وإما إلى القاهرة ، وكان السعي قائما كي يمكنني أن ألتحق بإحدى هذه الجامعات منتسبا ، وليس مداوما ، وإني لكذلك : أراسل واستقبل الاجابات ، فإذ بالمستشرق الفرنسي أندريه ميكيل يزور مدينة وهران ، ويلقي محاضرة بجامعتها حيث كنت ـ أنا ـ أستاذا بهذه الجامعة ، فعرضت عليه أن يتفضل بالإشراف عليّ فقبل ، فتحولت من تحرير الدكتوراة التي كنت قد اقتربت من إنهائها باللغة العربية إلى اللغة الفرنسية ، وكان ذلك من سنة 1976 إلى سنة 1983 ، حيث ناقشت دكتوراة الدولة باللغة الفرنسية بجامعة السوربون الثالثة بباريس ، وهذه تقريبا هي مرحلة الدراسة .
* المرحلة الأولى للثقافة أليس فيها جوانب أخرى . البدايات هل كانت ثقافة دينية بحتة أم كانت ثقافة أدبية ؟
ـ في الحقيقة لم تكن ثقافتي الأولى أدبية لأن الناس لم يكونوا يعرفون الأدب لسانا ولا نصا ، وكل ما في الأمر أنني كنت أستمع إلى بعض الأناشيد التي كانت تلقى في بعض حلقات الذكر الصوفية . والتصوف في الجزائر ما شاء الله ، فتعلمت ، وحفظت مجموعة من الأشعار الدينية ، ولكن عندما كنا نتعلم النحو ـ مثلا ـ لم نكن نعرف لماذا نتعلم النحو ؟
( ضرب زيدٌ عمروا ً .. قام زيدٌ .. ) .
لم يكن أحد منا بقادر ـ من الناحية المعرفية ـ على أن يلقى على الشيخ سؤال : لماذا نردد هذا الكلام ؟
فهذه البلدة ، بلدة ” مسير ” ، تجاور الحدود المغربية ، فكنا نذهب يوم الإثنين إلى سوق كبير ، وكان بهذا السوق باعة شعبيون يبيعون بعض الكتب، فرأيت كتاب النحو الواضح للاستاذ علي الجارم . عدت من السوق إلى البيت ، وانا أمتطي حمارا ، وبدأت أقرأ : ” الحديقة جميلة . الولد مهذب . .. إلى آخره ” .. فقلت في نفسي : “والله هذا شيء جميل . لماذا لم نكن نتعلم هذا ” .
من هنا بدأت رحلتي مع الأدب ، لكن البداية الحقيقية بدأت بمدينة قسنطينية حيث كنت ـ ولله الحمد ولازلت ـ سريع الحفظ ، فحفظت في خمسة شهور عددا ضخما من أهم الأشعار العربية ، المعلقات الجاهلية ، قصائد المتنبي ، كل القصائد الشهيرة تقريبا التي تدرس للطلاب في المرحلة الابتدائية والثانوية في الوطن العربي : لأبي العلاء المعري ، جبران خليل حبران ، وعشرات القصائد الأخرى . حاولت أن أكتب شعرا ، ولازالت لدي قصيدة تقع في عشر أبيات تقريبا ، والحقيقة ألا صلة لها بالشعر على الإطلاق ، لاوزنا ولا تصويرا ، ولا تكثيفا ولا يحزنون .
فعندما ذهبت إلى جامعة القرويين كان يجري أختبار من أجل تصنيف الطلاب ، بحيث يتم تحديد في أي صف دراسي ينتظمون ؟
فامتحنني الأستاذ عبد الكريم تواتي ، وقيل لي : هو أديب شاعر ، ما يزال حيا يرزق . أمتحنني في بعض العمليات الحسابية البسيطة : العمليات الأربعة الساسية ، والكسور العشرية والاعتيادية ، وما إلى ذلك . ثم من بعد ذلك قال : هل تحفظ شيئا من الشعر العربي؟ قلت له : الكثير . فاندهش لأن طلبة القرويين بفاس لم يكن بإمكانهم حفظ الشعر ، وقال لي : لمن مثـلا ؟ قلت له : المعلقات ، وقصائد لأبي الطيب المتنبي . قال لي : هات .
( ملومكموا يجل على الملام ) لأبي الطيب المتنبي . فقرأت إلى أن وصلت إلى وصف الحمى ، فبدا يسألني عن بعض المفردات ، وكنت أجيبه بسرعة فأعجب بي ، وقال لي : في أي سنة تريد أن تنخرط؟
فقلت له : في السنة الثالثة من الطور الأول . فقال لي : يا بني . لماذا لا تنخرط في السنة الثالثة من الطور الثاني؟ فقلت له : يا سيدي الأستاذ . انا لم ادرس الألفية ( النحو ) . وكنت أعتقد أن من لم يدرس الألفية لا يمكنه أن يعرف النحو على الإطلاق .
إذن ، كما ترى في البداية كان التأثير ممتزجا . كان دينيا ، شعبيا ، والذي أثر فيّ أول مرة ـ في الحقيقة ـ هو الأستاذ احمد بن ذياب ، وما زال حيا ، وقد فقد بصره الآن ، ويعيش بمدينة ” بليدة ” . كان يوجه الطلاب ، دون أن يوجهني شخصيا ، فكان عندما يأتينا ، يدرس لنا تدريسا تقليديا ، لكنه كان يقول لنا : أنا ظللت أبحث عن بيت من الشعر أحققه لشاعر أندلسي ، فلم أعثر على صاحبه إلا بعد شهور . مثل هذا الكلام لفت انتباهي ، وبدأت أحفظ الشعر ، كما بدأت أقلد الكبار .
أذكر أنني كنت أحفظ طه حسين ، مقدمة ابن خلدون ، على هامش السيرة مثلا : ” هذه صحف لم تكتب للعلماء ، ولا للمؤرخين ، لأنني لم أرد بها العلم ، ولم اقصد بها إلى التاريخ ، وإنما هي صورة عرضت لي أثناء قراءاتي للسيرة ، فأثبتها مسرعا ثم أني لم أر بنشرها بأسا .. الخ ” .
فكنت ألتهم كل نص جميل من شعر ونثر ، فلما بلغت السنة الرابعة في الجامعة كتبت أول رواية ، وربما كانت أول رواية تكتب باللغة العربية في الجزائر ، وإن تأخرت في نشرها ، وقد عنونتها عنوانا رومانتيكيا ” دماء ودموع ” ، وهي تصور حياة فتى أحب فتاة . كان مدرسا . التحق بالجبل ( بالثوار المجاهدين ) من أجل أن يحرر الأرض من الاستعمار الفرنسي ، وتعرف على فتاة وأحبها ، والتحقت هي أيضا ، إلى آخر الحكاية .
وقدمت بحثا في السنة الثالثة بجامعة الرباط مع الدكتور جعفر الكتاني حول تحليل القسم الغزلي من معلقة أمريء القيس فكتب لي ملاحظة ما زلت أحتفظ بها : ” بحث لم أقرأ له مثيلا طيلة وجودي بكلية الآداب ، فتقبل إعجابي وتنويهي ، وأرجو أن تكون ميسورا لأن تكون شيئا ” .
ولم يكتب العلامة ، ولكن كتب ” ممتاز فوق العادة ” ، وكان هوالدكتور نجيب البهديسي عليه رحمة الله ، وهو علاّمة كبير ، صاحب المعلقة العربية ، وصاحب تاريخ الشعر العربي حتى أواخر القرن الثالث ، فكان يملي علينا درسه ، وكان يحلل القرآن الكريم ، وكان يقدم لنا بعض القصائد من المفضليات للظبي .
لكنه حلل لنا تقريبا الجزء الأول من سورة البقرة ، فكان يضع إصبعيه على جبهته ، يتأمل ، وينظر إلى المصحف ، ثم يحلل النص مباشرة ، إرتجالا فكنت أكتب ، وكان يدرس أيضا بالمركز الجامعي بمدينة فاس ، فكان يطلب مني حتى لا يرتجل مرة اخرى أن يأخذ ما أكتب على لسانه ، بعد أن يجري بعض التصويبات البسيطة ، وقد أخجلني يوما حين قال للطلاب : ” لو أن كل واحد منكم عبد الملك ؟ ! ”
ربما من هذه الناحية كنت مدللا عند أساتذتي ويبدو أن هذا هو الذي دفعني إلى أن اكون هذا الشيء الذي صرته ، وهو بسيط جدا .
لابد أن أذكر فضل مغربي آخر هو الأستاذ إبراهيم الكتاني ، فهو الذي وجهني أن أدرس الأدب الجزائري ، وكان يتفاهم مع جمعية العلماء ـ هذه الحركة الاصلاحية الدينية ـ وقد كنت في بداية أمري أريد أن أحضر موضوعا كلاسيكيا حول الشعر في سوق عكاظ ، فنبهني إلى أن هناك حقولا معرفية لا يعرفها سوى القليل من الناس .
* ليتك تحدثنا يادكتور عن كتبك التي أثريت بها المكتبة العربية ؟
ـ كان أول كتاب لي وأصنفه ضمن نطاق التأليف الكلاسيكي ” القصة في الأدب العربي القديم ” ، وثاني كتبي هو ” نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر ” ، بعدها تفجر ينبوع التأليف وصار لي حتى الآن حوالي 42 كتابا والحمد لله على ذلك.
* تحدثت بصورة بانورامية شاملة ، فدعنا نعود لتلك المرحلة بشيء من التفصيل ، وعلى وجه التحديد عرفنا متى ألفت أول كتاب ، وهو المصنف الذي يمكن اعتباره بداية الاسهام في حركة الكتابات النقدية ؟
ـ في الحقيقة ابتدأت مشواري الأدبي في مجال الدراسات النقدية بكتابي الذي ذكرته حالا وهو ” القصة في الأدب العربي القديم “وهو كتاب ـ للأسف الشديد ـ لم ينشر إلا في الجزائر ، ولم يوزع خارجها ، ونفدت طبعته منذ عهد طويل ، ولم نعد لطبعه ثانية ، وهناك دار نشر تحاول أن تعيد طبع كل أعمالي ومنها هذا الكتاب .
ألفت هذا الكتاب سنة 1967 تقريبا ، وظهر الكتاب في السواق سنة 1968. أما كتابي الثاني ” نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر ” فقد ظهر حوالي سنة 1969 أو سنة 1970 ن بعد ذلك بدأت بقية الكتب تتوالى .
* وماهي كشوفاتكم في مجال البحث العلمي للقصة القصيرة بالأدب العربي ؟
ـ الحقيقة تعود هذه القصة ليوم أن قرأت للمستشرق الفرنسي ” أرنست ريونان ” كلاما سيئا جدا في العرب ، وكنت وقتها بكلية الآداب بجامعة الرباط . الرجل يتحامل على العرب بشكل شنيع ، ويتهمهم بأنهم غير قادرين على كتابة القصة ، وأن الإغريق جاءوا بالملحمة في حين أن العرب لا يكتبون إلا الشعر .
فأنا ومن نزوات الشباب ، وعنفوانه انطلقت من هذا المبدأ ، وصممت أن أرد عليه ، وقد رددت عليه بعنف في مقدمة طويلة ، وأثبتت أن العرب عرفوا القصة ، وإن كنت لم أفصل الأمور ، وأحللها على نحو أكاديمي مميز ، لأنها تجربة أولى .
حاولت أن أثبت أنه كان للعرب قصة شعرية ، وانطلقت من قصة امرؤالقيس وحبيبته ، ومن قصة عمرو بن أبي ربيعة في قصيدة ” نُعم ” ، ثم بعد ذلك انطلقت من القصيدة الرومانتيكية : قيس ليلى ، لبنى ، ثم انطلقت إلى القصة الفلسفية ، فتوقفت عند رسالة الغفران لأبي العلاء المعري ، وكذلك قصة حي بن يقظان لإبن طفيل .
وقد توقفت طويلا من أجل أن اثبت أن ” رسالة الغفران ” هي أسبـق من ” الكوميديا الإلهية ” لدانتي ، وأن اللاتين كانوا يطلعون عن طريق الترجمة على الآثار العربية الإسلامية ، وأنهم أفادوا من رسالة الغفران لأبي العلاء المعري ، ولم يكن ذلك مجرد توارد خواطر. تقريبا هذه هي الإشكالية التي عالجتها في هذا الكتاب الأول بالنسبة لي .
* هذه مرحلة البدايات . أتصور ان هناك مجموعة من الكتب تجاوزت بها هذه المرحلة الاستكشافية إن صح التعبير . حدثنا عن مرحلة النضج الأدبي .
ـ فيما يخص مسألة التجاوز أعتقد ان كل كتاب جديد أنتهي منه يتجاوز ما قبله . لكن المرحلة الأكاديمية والمعرفية يمكن أن تنقسم إلى قسمين اثنين .
القسم الأول من سنة التخرج 1963 إلى سنة التسجيل بالسربون 1976 . في هذه المرحلة كنت أعول فيها على الإنشائية ، والأسلوب الجميل ، وإن ظل هذا الأسلوب الجميل يتنازعني ويلازمني إلى يومنا هذا ، ولكنني لم أكن أعرف المنهج الغربي ، فكنت أعول على تقليد الراسخين ، وأقتفي آثارهم : كيف يكتب طه حسين ؟ كيف يكتب زكي مبارك ؟ وغيرهم من رواد تعلمنا منهم في فترة البدايات . الدكتور محمد إحسان النص أحسن الله إليه قال لي :” لي فيك ثقة عمياء ” .
قالها وهو يشرف علىّ ، لم يقرأ لي إلى أن ناقشت أول أطروحة ، وهي الدكتوراة . معنى هذا أنه اعتمد على ما قرأه لي ، فقد كان كتابي عن ” القصة القصيرة في الأدب العربي ” قد ظهر ، وكذلك كتاب ” الأدب العربي المعاصر في الجزائر ” قد خرج إلى النور كذلك ، وهذا نادر أن تجد شخصا يناقش شهادة تعادل الماجستير ، وله كتابان في السوق .
أما الدكتور محمد الطاهر مكي ، وكان أستاذا لي ، فقد قال لي في جلسة من الجلسات : ” يا أخي ، كنت أعتقدك شيخا كبيرا ” .
ربما ذلك للغة التي حررت بها أول كتاب . كنت أقلد د. طه حسين والجاحظ مجتمعين ، وبحكم أنني حفظت القرآن الكريم ، ومجموعة كبيرة من الشعر العربي القديم فقد ظهر ذلك جليا في لغة هذا الكتاب .
لقد ظهر أسلوبي وكأنه أسلوب كاتب فحل بكل تواضع .
* وماذا عن المرحلة الثانية التي بدأت تشتبك فيها مع المنتج الغربي؟
ـ هي مرحلة النضج ، عندما تسجلت في السربون تواعدت مع أستاذي المستشرق الفرنسي أندريه ميكائيل في قسم الإسلاميات ب” الكولدج دي فرنس” ، وقدمت له المنهج الذي سأتناول به إشكالية البحث ، وهي أجناس النص الأدبي في الجزائر ( 1931 ـ 1945 ) . ابتسم لي الرجل ابتسامة فهمت منها كل شيء . فهمت أن هذا المنهج غير لائق على الإطلاق .
كان هذا بعد أن أصدرت ثمانية او تسعة كتب . قال لي : أنا أعطيك مجموعة من الكتب لتنظر فيها ، وكانت لمجموعة من النقاد واللغويين منهم : جريماس ، رولان بارت ، تودوروف ، جراجينيت ، كلود ديستوف. يعني مجموعة من عمالقة النقد ، والأنثروبولوجيا . قال لي بثقة : بعد أن تقرأ لهؤلاء أكتب ما شئت !
مشكلتي أنني أعرف الفرنسية ، لكنني لا أفهم ما يقولون ، لأنها لغة جديدة ، واقصد لغة الحداثة ، وهذا دفعني إلى أن أقرأ ما منحني من كتب .
أول كتاب قرأته كان لرولان بارت ، وهو ” الكتابة في درجة الصفر ” . أشتريته من مكتبة مقابلة للسوربون ، كنا في الشهر السادس من السنة ، وذهبت إلى حديقة مجاورة ، فقد كان الجو جميلا ، إلى حدما .
بدأت أقرأ إلا أنني لم أفهم شيئا ، لكنني أصررت على أن أفهم ما يقولون ، لذا اشتريت كل المعاجم الفرنسية الكبيرة التي توازي لسان العرب . يعني ” روبير ” في سبعة أجزاء ، كما اشتريت الموسوعة العالمية ، واشتريت ما يمكن أن يطلق عليه ” سيبويه ” الفرنسيين ، وهو جريفيس ، وهذا كتاب في النحو الفرنسي ، لا يكاد يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا وذكرها .
فقضيت سنواتي الأولى فقط لا أكتب ، ولكن أقرأ وأفهم ، والحمد لله ، أمكنني أن أستفيد كل الاستفادة من هذه القراءة الممنهجة ، حيث قدمت الأطروحة في نهاية الأمر ، ونوقشت بامتياز ، وكان رئيس لجنة المناقشة هو الأستاذ محمد أركون في السربون .
* أعتقد انه تقاعد الآن ؟
ـ نعم ، تقاعد الدكتور محمد أركون لكنه صاحب نشاط مستمر .
* نعود لمسيرتكم مع التأليف .
ـ بالطبع ، في مرحلة النضج والتأثر بالمناهج الفرنسية أنطلقت عبر أعمال تتميز بشيء من المنهجية ، وكان ثمرة ذلك كتاب ” النص الأدبي .. من أين وإلى أين ؟ ” . وأنا أتابع الدراسة كنت لا أنقطع عن الكتابة . جمعت مقالات هذا الكتاب ، وكانت في الأصل عبارة عن محاضرات كنت ألقيها على طلابي في الماجستير في جامعة وهران .
أعتقد كان ذلك سنة 1982 ، وحللت في هذا الكتاب نصا من ” الإشارات الإلهية ” لأبي حيان التوحيدي ، من الرسائل القصيرة ، واستغرق التحليل كتابا كاملا .
الشيء الثاني ، يبقى أن أنبه إلى شيء ، هو أن كثيرا من الأخوة في المملكة ، وغير المملكة يعتقدون بأن الحداثة هي معادل للكفر ، وربما هم محقون في حالات قليلة ومحدودة ، لكن حداثة الناضجين من الكتاب والنقاد بما فيهم الدكتور عبد الله الغذامي ، والدكتور عز الدين اسماعيل ، والدكتور جابر عصفور ، وأسماء أخرى كثيرة ، مثل هذه الأسماء تتعامل مع النقد الحداثي فقط لأنها تستفيد من المنهج الأوربي والحكمة ضالة المؤمن ينشدها أنى وجدها ، فليس محرما علينا ذلك ، وليتذكر المؤرخون المنصفون أننا أعطينا للأوربيين أكثر مما أخذنا منهم .
فليس علينا وزرا إن أخذنا منهم الآن ، فشخص مثلي ثقافته دينية ، وتراثية ، وثقافة يغلب عليها الطابع العربي الإسلامي الأصيل ، ولكن شاءت الظروف ألا أناقش دكتوراة الدولة في جامعة الرباط ، بل في جامعة السوربون بباريس ، فتحولت مسيرتي من هذا الطرف إلى ذاك ، غير أن مكوناتي الثقافية هي هي لم تختلف البتة .
حين أحاول أن أعالج قضية من القضايا النقدية في الوقت الراهن أركز على أنني دائما ما انطلق من تراثي العربي الإسلامي .
فأبحث عند الجاحظ ، وعند عبد القاهر الجرجاني ، وعند ابن سلام ، وعند ابن قتيبة ، وعند قدامة بن جعفر ، كذلك عند ابن رشيق ، وعند القرطاجني .. الخ .
عندما أحس أن هؤلاء لم يلتفتوا إلى المسألة الحداثية التي أريد معالجتها ، حينئذ أنطلق من ( الصفر ) على مضض . لكنني قلما أنطلق من ( الصفر ) والحمد لله ، ففي بعض الأطوار أجد إما أنهم تناولوا الإشكالية بوعي معرفي كامل ، و إما تناولوها على سبيل التلميح والإشارة ، فانطلق ـ أنا ـ كباحث من ذلك .
ـ حدثنا يا دكتور عن رسالة دكتوراة الدولة التي حصلتم عليها من جامعة السوربون ؟
ـ والله لقد كانت هذه الرسالة ككل الرسائل الجامعية المحترمة ، من الصعب على أي طالب أن يحضر دكتوراة دون أن يبدع فيها ، فبحكم أن الموضوع دقيق ومحدد بالزمان ،و المكان ، وبحكم أن كل كلمة تكتبها ربما يأتي أحد المناقشين ليحاسبك عليها .
من جملة الأشياء التي وردت في المناقشة باللغة الفرنسية طبعا أنني اعترضت على ترجمة قوله تعالى : ” إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ، وأشفقن منها ، وحملها الإنسان ” .. إلى آخر الآية الكريمة .
هم يترجمون الأمانة ب” الثقة ” ، بمعنى أننا عرضنا الثقة على الإنسان ، وقد اعترضت على هذا الفهم ، فاعترض على اعتراضي مستشرق فرنسي ، لا أذكر اسمه ، وقال لي : لماذا تعترض على هذه الترجمة؟ وبأي شيء تترجمها ؟
قلت له : أنا الآن لا أملك من الفرنسية ما يسمح لي بأن أترجم إعجاز القرآن ، لكنني وأنا عربي مسلم أفهم أن هذه الأمانة بمعنى ليس هو الثقة بحال ، يمكن أن تكون الثقة من بينها ، لكن هذه الأمانة هي جملة أشياء ، وشبكة من القيم الروحية العظيمة التي وهبها الله للإنسان .
كانت هذه المداخلة من ضمن نقاط المناقشة ، أما في موضوع الرسالة الأصلي فقد كان يتحدث عن قضايا تقليدية مثل أجناس النص الأدبي ، فتحدث عن المقالة ، القصة ، الرواية ، وبهذه المناسبة فإن الرواية التي تحدثت عنها في رسالتي السربونية هي رواية للأستاذ أحمد البحوحو، والشباب منكم لا يعرفون الأستاذ أحمد البحوحو ، فقد عاش في المملكة حوالي عشر سنوات ، وكان يحرر بمجلة ” المنهل ” ، كما كان يترجم بعض المسرحيات والقصص عن اللغة الفرنسية ، وينشرها في المنهل .
وقد كتب أول محاولة روائية باللغة العربية عنوانها ( غادة أم القرى ) . باختصار حكايتها أن فتاة تعيش في مكة المكرمة ، وكانت وهي صغيرة تعرف ابن خالتها الذي استشهد في الحرب السعودية اليمنية ، وحين اقتربت من البلوغ بحكم الشريعة الإسلامية حجبت عن الفتى ، لكنها ظلت تحتفظ له في قلبها بحب لم تستطع أن تبوح بهذا الحب لأي إنسان ، وكان لها أخت أكبر منها ، إعتقدت الفتاة أنها ذكية ، وكان لها أخت أكبر منها ، وكانت تحب ابن خالتها محمود حبا شديدا ، ولم يكن يعلم أنها تحبه .
كان محمود يعيش مع العائلة ، وعندما كبرت الفتاتان وكبر هو أيضا ، انتقل إلى بيت قريب استؤجر في مدينة مكة المكرمة ، لكنه بحكم القرابة ظل يتردد على العائلة ، فجاء يوما بالمصادفة إلى بيت خالته ( زكية) ، وطرق الباب ، ولم يكن بالبيت إلا هي . فبطبيعة الحال لم تفتح الباب ، فصفقت له تصفيقتين أو ثلاث على أساس انه لا يوجد أحد بالبيت.
كان قلبها يخفق خفقانا شديدا ، وفي تلك الأمسية جاء تاجر كبير متعفن ، خاطبا ، ولم يذكر البنت الصغيرة ولا الكبيرة . كانت زكية تسمع ، فأجاب أبو زكية الخاطب البعيد القريب : “إن ابنتي مخطوبة ، وقد خطبت اليوم ” .
فاعتقدت زكية أن محمودا قد جاء ذلك اليوم ليخطبها . أعتبر الخاطب الفاشل ان رفضه إهانة ، ودبر مكيدة للفتاة . أدخل محمود السجن بتهمة أنه ضبط سكرانا في الشارع. كان حكم تلك الجريمة على ما تقول الرواية ستة اشهر على ان يخرج من السجن كل أسبوع ، يشهر به ، ويضرب في الشارع .
محمود وهو المظلوم طلب من الله تبارك وتعالى ـ وهو بريء ـ أن ينقذه من هذه الفضيحة ، وأن يقبض روحه ، فتوفى في السجن قبل أن تعقد المحاكمة .
في تلك الأيام جاء الملك بن سعود إلى مكة ، وكان يستقبل الناس وهم يقدمون له بعض التظلمات . استطاعت هذه السيدة أن تخترق كل الحواجز ، وأن تصل إلى الملك ، وأن تسر له في أذنه ، فينصت لها ، ويقول : انصرفي راشدة.
وعندما يعود يخبرونه أن محمودا قد توفى في السجن ، لكنهم حين يقتربون من الدار يسمعون بكاء وعويلا ونحيبا . جنازة قائمة ، فيقول الحراس بعضهم لبعض : لا داعي لأن نخبرهم فبالتأكيد قد وصلهم الخبر .
كان أهل الدار مشتغلين بمأتم زكية ، ولم يكن فيهم من يعلم بموت محمود . كانت النهاية لقطة حزينة لكنها جميلة فنيا.
هذه أول رواية لكاتب جزائري ، والموضوع يجري في الأجواء السعودية ، سبحان الله .
نشرت القصة في الجزائر سنة 1947 ، وعندي نصها في طبعته الأولى .
* أخذتنا إلى أجواء الرواية بكل ما فيها من ميلودراما ، فلنعد إلى مشروعك النقدي ، فمن الواضح ان لديك مشروعا نقديا مختلفا .
ـ يا صديقي مشروعي ليس كتلة مصمتة بل ينقسم فعليا إلى ثلاث مراحل .
فالأعمال الأولى كانت في تصوري وباعترافي لا ترقى إلى مستوى النظرية النقدية ، وأعتقد أنه من المفروض على كل كاتب أن يقر بهذا .
أحيانا نصاب بالغرور ونبدأ في الكتابة قبل أن تنضج أدواتنا النقدية ، وتكون كتابة لا ترقى إلى المستوى الأعلى ، والمستوى الأعلى لا يمكن أن نصل إليه حتى يوم الدين باعتبار أن الانسان ناقص في معارفه ، والكمال لله وحده.
فالأعمال الأولى اقتصرت في معظمها على تحليل النصوص ، وبطريقة لم أسبق إليها ـ في تصوري ـ في العالم العربي ، وفي كثير من تجارب الغرب ، فأنا مثلا كتبت كتابين اثنين عن قصيدة ” أشجان يمنية ” لعبد العزيز المقالح ، وكتبت كتابا كاملا عن قصيدة قصيرة لمحمد العيد آل خليفة الجزائري كتبها سنة 1938 ، يتحدث فيها عن ليلى ، وهو يقصد بها الحرية : حرية الجزائر التي كانت مستعمرة . كتبت عنها كتابا كاملا بعنوان ( أ .. ي.. ) . كذلك كتبت كتابا كاملا عن رواية” زقاق المدق ” لنجيب محفوظ ، وأصدرت عدة كتب أخرى عن قصائد وروايات مختلفة ، وتلك تقريبا مرحلة الأعوام الثمانية الأولى في تجربتي النقدية .
كتبت أيضا الكتاب الذي نشرتموه بدار ” اليمامة ” كتاب الرياضن وهو ” قراءة النص ” وحللت فيه قمر شيراز لعبد الوهاب البياتي .
* هل يتضمن أكثر من نص أم نصا واحدا؟
ـ درست فيه قصيدة واحدة هي ” قمر شيراز ” ، والكتاب يقع في أكثر من 400 صفحة .
كانت هذه مرحلة ، وكنت في كل كتاب أضع مقدمة نظرية أتحدث فيها عن : كيف يمكن قراءة النص ؟ وكيف نحلله؟ وكيف نتفهمه ؟
كانت مجموعة من الشباب تحيط بي ، وكنت أشرف عليهم ، وأوجههم ، وقد أصبحوا الآن زملاء ، ظلوا يغرونني أن انتقل من مرحلة النقد التطبيقى إلى مرحلة التنظير.
ـ وهل تجاوبت مع هذه الرغبة؟
ـ بحمد الله ، وبفضله تبارك وتعالى تخطيت حاجز التخوف ، وكان أول كتاب يظهر لي في التنظير هو الكتاب الذي تضمن ” نظرية الرواية ” والذي نشرته في سلسلة عالم المعرفة بالكويت.
ثم بعد ذلك الكتاب الثاني الذي نشر في المملكة، ضمن سلسلة ( كتاب الرياض ) ، هو كتاب ” الكتابة من موقع العدم ” ، ونشرت كتابا ثالثا في النظرية النقدية بالجزائر عنوانه ” في نظرية النقد ” ، أما الكتاب الرابع وقد انتهيت منه ” في نظرية النص الأدبي ” ، ربما أقدمه لدار اليمامة إن شاء الله .
* حدثنا في إيجاز عن هذا الكتاب الذي انتهيت منه مؤخرا .
ـ هو كتاب يحوي جهدا كبيرا ، تناولت فيه قضايا لم تتناول في النقد العربي من قبل ، وانا واثق مما أقول ، هذا أمر واقع فعلا ، فأن تخصص فصلا كاملا للحيز الأدبي لبيتروف . النقاد العرب يتناولون هذا الحيز الأدبي تحت مصطلح الفضاء ، ولا يتناولون الفضاء إلا ومعه المكان ، ولا يتناولون المكان إلا في النصوص الروائية ، ولا يجاوزونها إلى غيرها ، في حين أن مفهوم الحيز الأدبي ، أو حتى الفضاء الأدبي ، هو أكثر من ذلك في النظريات الغربية عند موريس بلانشو ، وعند جيرارجينيت ، وعند مجموعة من الباحثين الغربيين الذين أفدت منهم ، وحاولت أن أعود للتراث العربي ، فوجدت مقولة نظرية للجاحظ ، وقد انطلقت منها ، وأقمت عليها أحكاما ونظريات .
* على ما يبدو أنك بصدد التنظير لجملة من القضايا ، فهل هذا صحيح؟
ـ بالطبع ، ولكن ذلك لا يعني أنني نضجت واكتملت ، أو أن ما أكتبه هو شيء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. معاذ الله.
فما أقدمه ما هو إلا محاولات بسيطة أضمها إلى المحاولات النقدية التنظيرية لزملائي في العالم العربي ، وهذا المشروع انتهيت منه ، وبيضته نهائيا .
لكنني في الحقيقة أهتم ايضا بالعديد من القضايا الفكرية ، وليس فقط بالقضايا النقدية الخالصة ، وقد كتبت هذا في مقالة نشرتها في المملكة ، يوم سهرت أنا وصديقي الدكتور عبد الله الغذامي بتونس في مقهى شهير اسمه ” أفريقيا” ، وقررنا أن نحور المكان ، فلا نبقى مقتصرين على النقد بمفهومه الصارم الضيق ، وإنما يمكن أن ننتقل إلى القضايا الفكرية .
التصور أن الأديب الذي يمتلك ناصية اللغة ، يمكن أن يذهب للأدب وحده ، لكنه ينصرف في حديثه عن الحضارة ، عن التاريخ ، عن السياسة ،تصور ناقص ؛ فالناقد الأدبي بقراءة واعية يمكنه أن يكتب في كل هذه المجالات ، وعندما يفعل ستكون كتابته مختلفة ومحملة بالإرث الثقافي ؛ ذلك أن اللغة هي مفتاح المعرفة ، في حين أن زملاءنا في التاريخ ، وعلم النفس ، وعلم الاجتماع ، هم لا يغرفون من بحر ، ولكن ينحتون من صخر ، وهذا واقع.
من أجل ذلك اتجهت أنا والغذامي إلى معالجة قضايا فكرية واسعة .
* أنتم إذن كنتم تسجنون أنفسكم في قضايا أدبية ضيقة؟
ـ نعم ،الواحد عليه كناقد أن يتوسع ، فكتب الغذامي بدأت التأسيس لذلك . الكتاب المعروف في الوطن العربي ب” النقد الثقافي ” من هذه العينة ، وأنا نفسي كتبت كتابين اثنين في هذا الاتجاه .
الكتاب الأول ” نظام الخطاب القرآني ” ، حللت فيه سورة الرحمن ، وهي عروس القرآن بالحديث الذي رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وكذلك آخر كتاب صدر لي منذ شهور هو ” الإسلام والقضايا المعاصرة ” ، تناولت فيه قضايا الحركات الإصلاحية بما فيها حركة الإمام محمد بن عبد الوهاب ، وحاولت أن أنصفه لأنني وجدت الأستاذ محمد البهي يقسو عليه كثيرا ، ووجدت معظم الكتاب يقسون على هذا المفكر الإسلامي الكبير .
لكن أجمل وأفضل ما يمكن أن نقدمه إذا أمد الله في العمر ، هو أنني بصدد كتابة فصول عن ” السيرة النبوية ” . ليس بطريقة تاريخية ، ولكن بطريقة أدبية . مثلا ، أنا اتصور ان حلف الفضول قد وقع في جلسة واحدة ، لكنني أعود بهذا اليمني الذي ظلم في مكة ، والذي جاء كتاجر زبيب ، هذا اليمني أريد أن أتقصى كيف كانت أسرته ، يعني يتم الأمر بطريقة سينمائية .
كتبت حتى الآن أربعة فصول ، وأثبتت تاريخيا وسياسيا أن العرب هم أول من عرف حقوق الإنسان .
يعني هذا أن العرب ، وقبل أن يأتي الله بالإسلام توصلوا إلى هذا الجانب الهام ، وقد خصصت فصلا للرجل الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم : ذاك رجل يبعث أمة .
إذن انا بصدد كتابة فصول عن هذه الأمور ، وفيها أركز على بعض الملامح التي يمكن أن يمر عليها الباحث التاريخي مرور الكرام .
كما أنني في فصل آخر ركزت على هدم “اللات ” في الطائف ، وفي ثقيف.. الخ ، وأيضا بلغة عربية قديمة ” فحلة ” إذا صح هذا الوصف.
* واضح انك تقف إلى جانب الدكتور عبد الله الغذامي في مشروعه النقدي الثقافي ؟
ـ لا ، لست إلى جانبه ، لكنني أقدر عمله ، وأدعوه أن يرد في هذا الكتاب بكتابات أخرى تثري الموضوع ، حتى تتضح المعالم تماما . أمس كنت أتحدث مع صديق من بلد عربي ، عن هذا الكتاب والحقيقة أن هناك كثيرا من الناس لم يفهموا ماذا يريد الغذامي بالنقد الثقافي ؛ فلابد من تأسيس لهذه النظرية ، فلكي تصبح نظرية قائمة لابد من تطبيق ذلك على نص ، وإلا فلن يكون نقدا ، لأن النقد يجب أن يدور حول النص الأدبي ، وإلا فيمكننا أن نذهب إلى التاريخ ، أو الحضارة ، أو السياسة .
إذن أنا مع كل جديد رصين ، وقد كتبت مقالة عن هذا الكتاب ، ولكنني شخصيا لمـاّ تتبلور الفكرة التي طرحها الدكتور الغذامي في نفسي . لذلك أعتقد أنه سوف تخرج لنا كتابات أخرى حول هذه الإشكالية حتى يمكن أن نثري النقد العربي المعاصر .