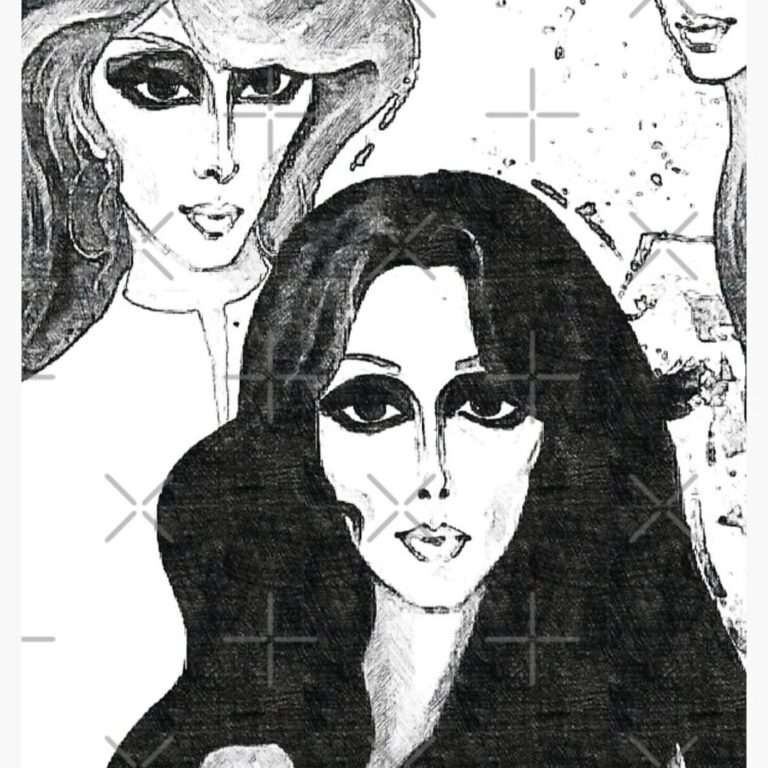“أنا مي زيادة”، رواية الكاتب علي حسن…
لماذا؟
وقبل أن نخوض في الحديث عن هذه الرّواية فإنّ مي زيادة أديبة حفرت في أديم لأدب، وتركت خربشات لن يمحوها الزّمن، وأوصلت نتاجها على الرّغم من كل ما حدث معها، وأثر مي واضح عند الحديث عن حقبة زمنيّة مهمة في الأدب العربيّ، فهي من المنتجين لإعادة انبعاث النّهضة، وهي صاحبة الصّالون الأدبي المسمّى باسمها.
لكن نحن نتحدث الآن عن الرّواية لهذا سأعود إلى “أنا مي زيادة” وأتساءل من جديد لماذا؟… نعم هذا ما يتبادر إلى الذهن عند قراءة عنوان الرّواية، لماذا أنا مي زيادة؟ ما هي هذه الصّرخة المدويّة الآن التي تعود بنا إلى مي زيادة لتؤكّد هويتها؟
ومن لماذا تتلاحق الأسئلة العديدة، عن أي مي زيادة يتحدّث الكاتب، هل مي هي رمز شهرزاديّ آخر؟ هل تمثّل علامة بارزة تقودنا إلى الحديث عن المرأة وقضاياها؟
عم يتحدّث الكاتب؟ هل الحبّ جريمة؟ هل ثقة المرأة بمن تحبّ نجاة أو هلاك؟
هل يمكن لدين الإنسانيّة إصلاح العالم؟ وكيف؟
هل نقف أمام الإبداع الأدبي انطلاقًا من الغيرة الأدبيّة أو كما نقول في الدارج غيرة الكار الواحد؟
هل الرّسائل تشكّل وسيلة تواصل؟ ماذا لو كانت مي زيادة اليوم في زمن التّواصل الاجتماعيّ، وفي المساحات المفتوحة؟ هل تتغير حكايتها؟
وسؤالي الأخير -وإن كانت طاقة الأسئلة مفتوحة على الكثير- ما سيميائية البدء في اليوم 25 يناير/ كانون الثاني 2011؟
هذه التّساؤلات شكّلت مفاتيح لأدخل دهاليز هذا الكتاب، وأوّل ما يمكن أن نبحث فيه هو تصنيف الكتاب، هل هي سيرة غيريّة، أي سرد إخباريّ يتركّز على شخص هو بطل السّيرة، ويتناول الظّروف والأحوال التي رافقت نشأته، والأحداث التي قامت في وجهه أو كان هو صانعها، والنّهاية التي آل إليها بعد حياة صاخبة مدوّيّة.
نعم، هذا ما يمكن قوله على هذا النّتاج، لأنّ الكاتب علي حسن اهتم في العودة إلى المراجع التي بنى عليها سرده لحكاية مي زيادة، وأفرد في ختام العمل مسردًا بهذه المراجع، ما يعطي للعمل صبغته الموضوعيّة في نقل المعلومات.
وقد أفرد الكاتب في عمله الجزء الأكبر للسّرد التّوثيقيّ لما حدث مع مي زيادة، فجاء العمل مقسّمًا إلى ستة أقسام، وضمن كلّ قسم عناوين عديدة، حرص من خلالها على تأريخها باليوم والمكان، وفي ذلك استطاع ان يعتمد استراتيجية القطع، والقفز من مرحلة إلى أخرى، مع ورود بعض التّواريخ بشكل يوميّ.
لكن استطاع الكاتب أن يبعد هذا العمل عن تصنيفه ضمن السّيرة الغيريّة ومنحه صفة الرّواية، لأنّه قدّم عمله في الجزء الأوّل منه على بناء سرديّ واقعيّ متخيّل يعادل الواقع الموضوعيّ ويغايره في آن، فقدّم لنا الراوي المتكلّم العليم مريم، لتحكي لنا حكايتها، وأية حكاية تحكيها؟ إنّها حكاية الظّلم الواقع عليها من مجتمع فرض ذكوريته فباتت المرأة ورثًا ضمن الإرث العينيّ والماديّ، وهكذا تحوّلت أمّها لتكون زوجة للعم بعد وفاة والدها، وتحكي حكاية سفاح الأرحام الذي تعرضت له، وإلى فقدان العون والصّديق والأمان، وإلى كلّ ما تعرّضت له من رفض لكينونتها ولوجودها.
نعم هي حكاية المرأة في المجتمع، تقول مريم “قد يجد الرّجال في عائلتنا بعض الحظ والسّعادة، لكنّ النّساء على النّقيض تمامًا، لم أرَ امرأة واحدة تبتسم في تلك العائلة التّعيسة!”.
هذه هي حكاية مريم التي رأت في أن تتماهى مع حكاية أخرى، وهي حكاية مي زيادة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فمريم = مي ومي باسمها الذي عرفت فيه= ماري = مريم العذراء، فجميعهن واحد، وترى مي زيادة أنّ الله أراد “مريم بلا أب، بلا زوجٍ، بلا ابنٍ، بلا ظلٍ على دفاتر أوراقي إلا دواتي وأقلامي، البيضاء، وبلا ظهر إلا وأمل مرسوم على جبين أم عجوز!”.
وإن كان هذا شعور مي زيادة فإنّ مريم الراوية قد حملت التماهي نفسه، تقول “ولجت عالما آخر، فقدت فيه السّيطرة على نفسي تمامًا، لست أدري، هل أنا مريم التي أتقوقع داخل جسدها؟ أم أنا مي التي احتونتي بكلّ ما لديها من كاريزما، ثم هيمنت على كلّ حواسي، فصرت قبسًا من نورها، وصرت ميًا بروحها وجسدها”.
ويتّضح التّماهي بين المريمتين في تفاصيل الحياة، وفي المعاناة التي مرّت بها، لهذا فهي لا تفرّق بين نفسها وبين مي، “إنّه اندماج مذهل ومبهم، وتفاصيل قد تكون باهتة رغم أنّها غاية في الوضوح، أنا أريد الكتابة عن مي ولكن ما أحاول أن أؤكده أنّ تلك الرّواية هي حياتي بكل تفاصيلها ودقائقها”.
وهكذا يجد الكاتب علي حسن مخرجًا لعرض سيرة مي زيادة، فهي ثمرة ما حصلت عليه بطلة روايته مريم من مذكّراتها، فبدأت بسرد يوميات مي لتكون سردًا ليومياتها.
وهنا نرى أنّ مي زيادة تحوّلت إلى أيقونة تعبّر عن المرأة واضطهادها، واستطعنا عبر المذكرات أن نقرا أجزاءً على لسان نساء أخريات تعرّفت بهن مي في العصفورية، فكانت حكاية ماجدة شيخون القاصر التي تتزوّج برجل مزواج يتجاوز الأربعين من عمره، وحكاية مايا جارديان الأرمنية وميراي فيلو الكلدانيّة، وغيرهن.
وفي هذا التّماهي يتحدّث الكاتب عن حكايات حبّ، قد نفهم منها أنّه تحت ستار الحبّ نقع في المحظور، فيتحوّل الحبيب إلى السّجان وإلى من يحرم الحبيبة حريّتها.
وتتشابه مريم مع مي في عشقها للأدب والكتابة، فهي كاتبة وشاعرة، نالت شهرتها، فكان شعرها على وسائل التّواصل عبر الفيس بوك بوابتها لإصدار ديوانها الشّعري، أمّا مي فالتّاريخ يشهد لها بأنّ صالونها الأدبي قد ضمّ العديد من الأدباء والمفكرين، وعاش صالونها مجدًا أدبيًّا مهمًّا، لكن ذلك لم يمنع مي من أن تفقد هذا السّند الذي عرفته في صالونها في أثناء محنتها، ويظهر جليًا من مذكراتها عتبها على من وقفت بجانبهم في أثناء أزماتهم، لكن البعض منهم كان أبعد من تقديم العون المثمر لها، تقول مي زيادة “أما أصدقاء الأدب والقلم، فلم أجد بجواري أحدًا منهم ولهذا لا أستطيع والله أن أصفح عن تخلّيهم عني في أيامي السوداء”، إنّها أزمة المرأة أيضًا، لكنّها المرأة المبدعة التي تواجه أندادًا في الميدان.
والقارئ للرّواية عبر صفحات المذكّرات يكتشف الدّور الفاعل الذي كان يؤدّيه الفنّ الأدبيّ وهو الرّسائل، ولعلّ أهمها الرّسائل المتبادلة بين مي وجبران، وجميعنا يدرك قيمة هذه الرّسائل في بعدها الأدبي وطرحها للكثير من القضايا النقديّة، بعيدًا من قصة الحبّ التي حيكت بين مي وجبران اللذين لم يلتقيا إلا على الورق، وحتّى في وصف مي لطبيعة علاقة الحبّ بينها وبين جبران بقولها “الحبّ كالكتابة لا يزهر إلّا في تربة الغياب”، فكان حبّهما لا ينمو إلّا في هذا البعد. ولا ننسى أيضا العدد الكبير من الرّسائل المتبادلة بين مي والعديد من الأدباء الذين تواصلوا معها وعبر هذه الرّسائل اكتملت أحداث المذكرات، وتشكلّت لدينا جزءًا من سيرة مي.
ولعلنا هنا نقف متسائلين عن قيمة هذا التّواصل سابقًا لنربطه بما نراه في زماننا من وسائل التّواصل الحديثة ونفترض حكاية مي في هذا الزّمن هل يمكن أن تختلف نهايتها، ولعلّ ما أورده الكاتب في حكاية بطلته وأنّ هذه الوسائل قدّمت لها شهرة ما، ومع ذلك لم يكن هذا شافعًا لها في التّخلّص من مظلوميتها، بل ربما يقودنا التّخيّل لنرى كيف يمكن أن تؤدّي وسائل التّواصل الاجتماعيّ من تجاذبات واختلاف في الرّأي، وما يمكن أن تواجهه المرأة من ضيم وظلم على مرّ العصور، وهذا ما يربط مريم بمي، فالمأساة واحدة. وما تريد الرّواية قوله “دائما تأخذنا عقارب الساعة إلى الوراء، هكذا بكل يسر وسهولة، وهاهي المرأة تعاني الضيم والعنف والتحرش والاغتصاب، ها هي تدافع عن حقوقها وتطلب المزيد من الحريّة التي يعتقد البعض أنّها نالتها، ولكن مسألة الحريّة مسألة تختلف من مكان إلى مكان، ومن عصر إلى عصر”.
وما يميّز هذه الرّواية غناها بالشّخصيّات إن كان في حكاية مريم، أو عبر مذكرات مي، واستطاعت هذه الشّخصيات أن تأخذ حيّزًا من الرّواية، كونها كانت الرّاوي في بعض أجزائها، وهذا ما يبعد الرّوايه من الصّوت المنفرد، بل إنّها متعدّدة الأصوات أو كما سمّاها باختين الرواية (البوليفونيّة)، فتحوّلت هذه المذكّرات إلى تقديم أكثر من منظور واحد يحكم العمل.
وما يلفت أيضًا أنّ الكاتب قد قدّم روايته بعتبات نصيّة فإذا حرص على وضع أقوال لمي مع بداية كلّ جزء من الأجزاء السّتة، يربط بينها وبين مضمون الجزء، فإنّه قدّم بعتبة الإهداء اهداءين أحدهما إلى مي زيادة والثّاني إلى من شجّعه على إتمام العمل أي إلى مصطفى بيومي، وفي الإهداء الأوّل يحاول أن يسوّغ كتابة هذه الرّواية وهدفها هو إنصاف مي وإنصاف المرأة العربيّة.
ومن هذا الإهداء الذي أراد فيه إنصاف مي يلفتنا اختياره لتاريخ 25 يناير 2011، وهو تاريخ بدء الثّورة في مصر إشارة واضحة منه إلى رغبته في التّغيير ورفض السّائد، وهو ما تمثّلت به بطلة الرواية.
هذه بعض خواطر خرجت بها من قراءة الرّواية وإن كان فيها الكثير، وبالتأكيد الحديث عن مي يطول ويطول، ولعلنا نقول مع حسن علي هل أنصفنا مي، إنّ إنصافها هو في التّخلّص من كل ما يسود مجتمعاتنا من ظلم وضيم يلحق بالمرأة، لهذا نعود إلى سؤالنا الأول ونقول نعم لماذا لأن الزمن ما زال يكرّر نفسه، وما وقعت به مي يمكن أن تقع به الكثير مع اختلاف معطيات العصر.