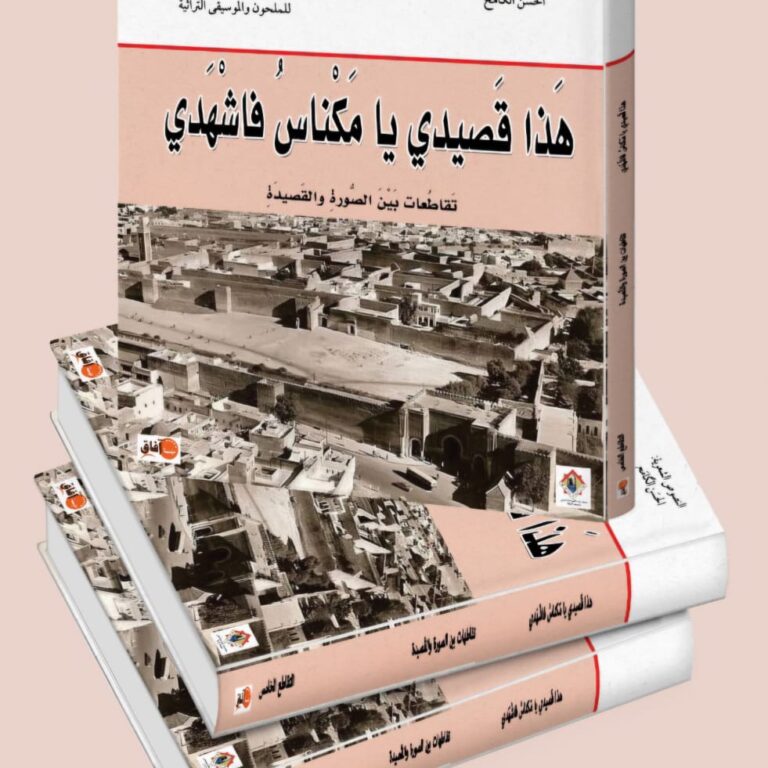خمس أقاصيص... حيث للسَّماء عكَّازٌ
سألَ العُكَّازُ الْمُستلقي على الرَّصيفِ، وَقدْ أشاحَ عنْ وجهِهِ غبارَ نهارٍ مضنٍ طويلٍ، صاحبَهُ الشَّحَّاذَ:كمْ جنيْتَ اليومَ منْ مال؟
أجابَهُ مدهوشًا: لمَ السُّؤالُ اليومَ، وَأنتَ رفيقي وَرفيقُ ساعِدي اليسرى، من ثلاثينَ عامًا، ولِمَ لَمْ تطرحْهُ قَبْلًا؟
ردَّ العكَّازُ، بعضُهُ خجلٌ وَبعضُهُ الآخرُ حَيْرَةٌ: أنتَ، يا صاحبي وَصديقي، شارفْتَ النِّهايةَ، وَأنا ما زلتُ قادرًا على الخدمةِ وَالعطاءِ، وَيُقلقُني غدي، بعدَ رحيلِك. فإِلى أينَ سأَؤولُ؟ أوْ إِلى مَنْ؟ لوْ توفِّرُ لي، مِمَّا جَنَيْتَ، ما يَقيني هذا الهمّ.
أجابَهُ الشَّحَّاذُ عاتِبًا: أَوَتقلقُ… وَتسألُ؟ مَنْ قالَ لكَ إِنِّي لمْ أفكِّرْ، أكثرَ منْكَ، في غدِك؟…
قاطعَهُ العكَّازُ: أظنُّ أنَّكَ ستهَبُني لزميلِ مهنةٍ لكَ، أوْ لجمعيَّةٍ خيريَّةٍ، أوْ قدْ يفاجئُكَ الرَّحيلُ – وَيفاجئُني – فتتركني وحيدًا على رصيفٍ ما، يتناقلُني أهلُ الأرضِ و…
فصاحَ الشَّحَّاذُ في وجهِهِ: ألهذا الحدِّ سئمْتَ قدرَك؟
ردَّ العكَّازُ، وَقدْ عفَّر الحزنُ جسدَهُ: لَمْ أسأمْ قدري، وَلستُ أُنكرُ صداقتَك… لكنَّ بي سأَمًا منْ أهلِ هذهِ الأرضِ، أنا الَّذي خَبِرَهُمْ جيِّدًا، وَما بي إِلَّا تعبٌ منْ أثقالِهِم.
فَأَطلقَ الشَّحَّاذُ تنهيدةً طويلةً، وَعَلَتْ فمَهُ ابتسامةٌ، كشحَتْ غيومَ شاربيْهِ الكثيفيْنِ، وَلحيتِهِ الجَعِدَةِ، وَقالَ لهُ: اطمئنَّ. سأَمُكَ سأَمي. لذا اخترْتُ لكَ قمَّةَ جبلٍ، أوصيْتُ بأنْ تُشَكَّ في أعلى نقطةٍ فيها، لتسندَ السَّماءَ… حينَ تتعبُ السَّماء!

اخترْتُ لكَ قمَّةَ جبلٍ، أوصيْتُ بأنْ تُشَكَّ في أعلى نقطةٍ فيها، لتسندَ السَّماءَ… حينَ تتعبُ السَّماء!
خذ عينيَّ… يا أبي!
بعد يوم مدرسيٍّ طويل ومتعب، أعقب إجازة، هي الأخرى طويلة ولكن ممتعة، أصرَّت على أن نسير معًا على الطَّريق، مساءً، غير آبهة ببرد أو صقيع أو رياح أو حتى مطر أو شبح ثلج.
صغيرتي التي ترفض أن أناديها أو أكتب عنها بهذه الصِّفة، لأنَّها تظنُّ أنَّها وُلدت كبيرة، تعرف، في قرارة نفسها، أنَّني نادرًا ما أرفض لها طلبًا. تُقنعني ببسمة، أو بقطبة جبين. تُحرجني بمنطق طفوليٍّ لا قدرة لي على مقارعته، أو بحجَّة خياليَّة أشبه بصورة في قصيدة تولد في البال. تدفعني، مكرهًا أوَّلًا وراضيًا دائمًا، إلى قبول ما أظنُّه في غير أوانه أو غير مناسب.
أحسست، لوهلة، ونحن نمشي ذاك المساء، يدًا بيد، متحدِّيَيْنِ الصَّقيع بإيقاع سيرنا السَّريع وبمعطفينا وقبَّعتي الصوف، أن بؤبؤي عينيَّ سيتجمَّدان ويقعان من مكانهما. عبَّرت لها عن شعوري هذا، من دون تذمُّر.
نَظَرَتْ إليَّ مبتسمةً بحنوٍّ أين منه حنوُّ أمٍّ على وليدها. شدَّت على يدي، ومن غير كلام، قادتني وراءها، تفتِّش عن بقعة ماء لتجتازها، موقنة أن حذاءها سيردُّ الأذى عن قدميها، عِقْدَي الياسمين. وحين لم تُثْنِها تحذيراتي المتواصلة، انصعت إلى نزوتها الطُّفوليَّة تلك، كمن يجرع، بعد جلسة سكر، ثمالة الكأس الأخيرة.
عدنا إلى المنزل، وقد سبقتنا إليه سعادتها. هي أنجزت فرض نزوتها، وأنا يغمرني شعور بالرِّضى، وينتابني إحساس أنَّني أرى، ولكن بلا بؤبؤين.
حان وقت النَّوم. أوت إلى فراشها. انحنيت أقبِّلها، فعانقتني كأنْ بعد طول غياب. قبَّلتني باسمة وهي مغمضة، كمن يقول: أنا سأنام الآن، وإلى أن أصحو غدًا…
خذ عينيَّ يا أبي.

الباص
أقلَّهُ الباصُ إِلى حيثُ يُريد.كانَ يُريدُ الانتحار. وَانتحر.
لمْ يوقِفوا الباص. فقدْ بقيَ يعملُ، على الخطِّ نفسِهِ، منتظِرًا راكِبًا يوصِلُهُ إِلى حيثُ يُريد.
***
الهِواية
كانَ يهوى السَّيرَ في الشوارعِ، وقراءةَ لافتاتِ المحالِّ، وَملصقاتِ الجدرانِ، وَأسماءِ شهداءِ الحربِ، وَقدِ اتَّسعَتْ ذاكرتُهُ لآلافٍ آلافٍ منْهُم. يعرفُ أينَ سَقطوا. متى سَقطوا. وَإِلى أيِّ حزبٍ كانوا يَنتمون.
وَبهوايتِهِ هذهِ، كانَ يهربُ منْ نفسِهِ المحاصَرةِ دومًا بصدى أزيزِ الرَّصاصِ، على متراسٍ متقدِّمٍ
جعلَهُ منزلَهُ شبهَ الدَّائم… إِلى أنْ أفاقَ مرَّةً، قبلَ المعتادِ، على أصواتِ الشَّوارعِ تُناديه.
وَراحَ فيها يجولُ يجول. وَيقرأُ اسمَهُ مذيِّلًا… صورةَ آخِرِ الشُّهداء.
***
الشَّهيد
حملَ الشَّهيدُ حقائبَهُ، وَانتظرَ، على ميناءِ موتِهِ، مركبًا يُقلُّهُ إِلى نومِهِ الأبديِّ.
ظنَّ أنَّهُ سيكونُ وحيدًا. فإِذا بالمركبِ يعجُّ بأصدقاء، بأصحابٍ، بأترابٍ، بأعزَّاء.
سألَهُم: … وَمَنْ بقيَ إِذًا في الوطن؟
أجابَتْهُ طفلةٌ بينَهُمْ: شهداءُ آخَرون!
حبيب يونس للصفا نيوز