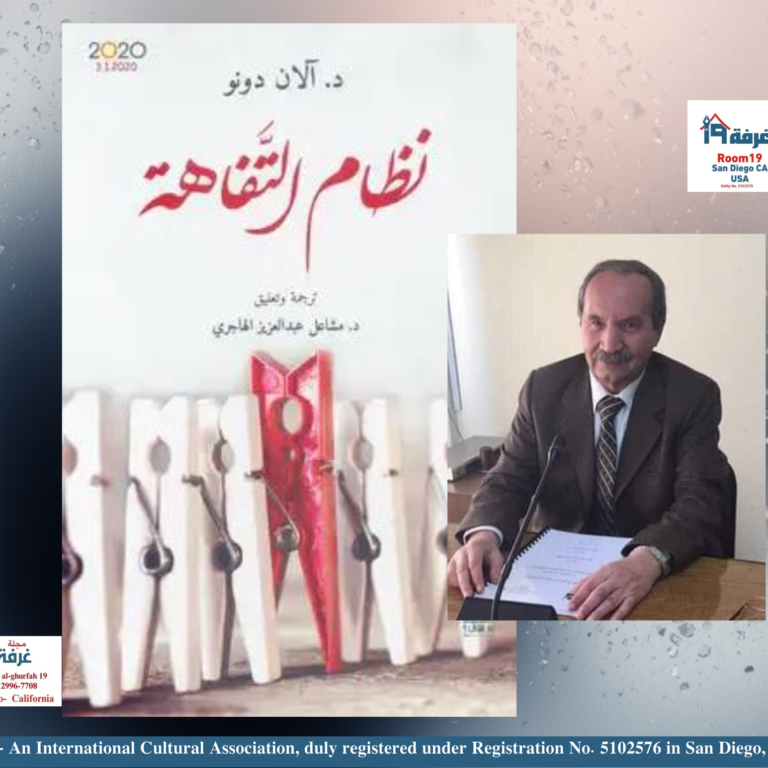لوحة اليوم زياد أكواريل مقاس 37 بـ 24 سم. 2016 ريشة الفنانة التشكيلية اللبنانية الصديقة خولة طفيلي

لم يكن زياد الرحباني مجرّد موسيقي أو شاعر أو كاتب مسرحيّ، بل كان ضمير مدينة. كان آلة تسجيل حادّة ترصد ارتجاف الشارع، ونبض المقهى، وهمس العشّاق، وصراخ الغاضبين،وألم الجائعين.
رحل زياد، نعم، لكن بيروت لن تتوقّف عن تنشّق عطر البخور الذي يتضوّع بين أرجاء حروفه.. ستبحث في أرصفة الحنين عن ظلال صوته، ستبحث في الغبار المتراكم فوق البيانو عن نوتةٍ ناقصة، وفي الهواء عن ضحكته الساخرة وهي تعاكس المستحيل …
ولد زياد في حضن الفن، لكنه تمرّد مبكرًا ، خرج من عباءة فيروز من دون أن يُسقطها، وصاغ لغته الخاصّة التي لا تُقلِّد أحدًا. كتب للبسطاء، للمنسيّين، للّذين يشربون قهوتهم على عجل قبل أن يذهبوا إلى اللّاجدوى. عرّى المجتمع، وعرّى ذاته، فلم يهادن. في السياسة، كما في الفنّ، كان مشاغبًا محترمًا، فوضويًّا نبيلاً، يحمل بيروت على كتفيه ويضحك.
بيروت الآن يتيمة، ليس لأنّ زياد كان آخر الرومنسيّين، بل لأنّه كان آخر الواقعيّين الذين جعلوا من الألم أغنية، ومن السخرية موقفًا، ومن العبث مشروعًا جماليًا.
في غيابه، تصمت المقاهي قليلًا، تغيب النكتة عن “النّهفات”. وتتوه الموسيقى في زحام الضجيج الرقميّ، تبحث عن شيء يشبهها، عن بوصلة كانت تتبعها في مسرح زياد وحواراته ومونولوجاته الباقية.
رحل زياد… لكن من قال إنّ الصوت يموت؟ هو فقط يختبئ في ذاكرة المدينة، في جدران مسرح بابل، في دفاتر العشّاق، في ليلٍ لم يعد يشبه ليلنا، في حلم ينتظر مَن يوقظه.
زياد، غيابك ليس فراغًا. إنّه امتحان لمدى قدرتنا على الإصغاء لما تركتَ من خلفك: مدينة تبحث عن صوتها، فلا تجده إلا فيكَ.
سنبكيك ،لكنّنا سنسمعك دائمًا لأنّ من يشبهك لا يموت ،بل يتوارى خلف نغمة ،أوغيمة،أو ضحكة حزينة، أو جملة تُقال كلّما اشتدّ الوجع:
” هيدا مش بلد …هيدا كافيتيريا مقطوعة الكهربا!”
“البلد ما بيشبهنا …نحنا منشبهو؟”