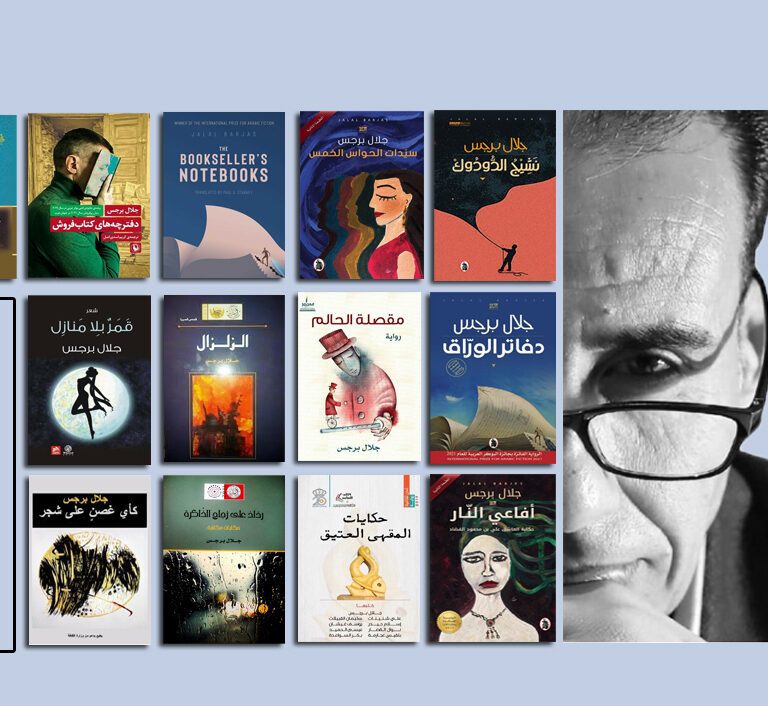غزلان التواتي
….استقدم والدي القابلة لمرافقة أمي. كانت امرأة قصيرة، حنطية يميل لونها إلى السمرة، خدّاها عظيمان، عيناها ضيقتان غائرتان، أنفها أفطس مبالغ في الفطس. ضخمة الجسد، تضحك كثيرا كاشفة عن آخر سن بقي في فمها. تتكلم بصوت مرتفع، شعرها أسود فحمي تساقط معظمه، بينما يقع ثدياها على بطنها الممتلئ، تقسمه إلى نصفين بشريط أسود عريض لا تخلعه ولا تستبدله، وجهها يلمع بلا غضون. لا تستطيع تحديد عمرها، كأنّما جزء من جسدها شاخ والآخر بقي شابا. لم يسبق أن مات طفل على يديها؛ جعلها هذا منافسة للمستشفى والأطباء. كانت بعض نساء الدوار يفضلنها على الذهاب إلى القابلات المتعلمات، “الخبرة تسبق العلم” هكذا يقلن، لها لكل مشكلة مهما كانت حل سريع وضحكة لا يُستَغْنَى عنها. لكن أمي كانت عسيرة الولادات
حمل أبي عدّتها المعتادة، الشمع والخيط، وربّما مقصا لم تعقمه منذ آخر استعمال، أو رّبما استعملته لغرض آخر كقطع الخيط لفتح كيس دقيق من الخيش أو قص خرق تستعملها في النسيج وربّما جز صوف خرافها. من يهتم للتعقيم! وعلى الأرجح لم يكن مقصا، بل موس حلاقة من النوع القديم يركب ويخلع من أداة الحلاقة
في سيارة جارنا البيجو 404، ركب أبي إلى جانبه، ووضعا المرأتين خلفهما في العربة المغطاة. أمي مستلقية على ظهرها تحت رأسها وسادة يابسة كأنّها جلد جيفة ملئت ترابا، تفترش لحافا ورديا مزروعا زهرات سوداء، كان فستانا فضفاضا تلبسه صيفا قبل أن يتحوّل إلى لحاف، ضمت إليه قطع أخرى من سراويل وفساتين لم تعد ممكنة اللبس، وعليها رداء ذو مربعات خضراء وبيضاء كان بشكير أمها المتوفية منذ سنوات؛ أمّا القابلة فجالسة -رغم وزنها- مقابلة أرجل أمي، على علبة حليب حديدية مغطاة بخرقة من الكتان الخشن حتى لا تبرد أردافها
اتجهت السيارة غربا نحو مستشفى المدينة الأقرب إلى الدوار وهي تبعد بمئة كيلومتر. الطريق طينية محفرة، تصعد جبلًا. كان الجار يسوق كأنّه يدفع السيارة بجسده إلى الأعلى يزفر مثل من يحمل جبلًا على ظهره. يتعاظم غيضه كلّما تعالى أنين أمي، فيطلق الشتائم بصوت مرتفع، لكنّه من باب الأدب يخاطبها بصيغة الجمع “ألا يمكن أن تلدوا نهارا؟” ثم وبصيغة المفرد إلى أبي ” لا أرى جيدًا ليلًا والطريق صعب، لماذا لا تلد زوجتك نهارا؟” يتمتم أبي “لكنه أمر الله؟” أمر الله ههه، يهز الجار رأسه
لو انحرفنا عن الطريق، سوف لن يكون أمر الله، بل ستكون أنت وزوجتك السبب. أضاف “هذه الطريق متعرجة محفرة يصعب المرور منها نهارا، أمّا الآن والثلج يهطل لا يمكنني رؤية شيء، ولا أن أسرع قلها تصمت”
وبعد مسير مسافة ساعة ونصف، وسط الأحراش، الغابة المظلمة، المثلجة خرجتُ إلى الدنيا، وضعتني أمي قبل الوصول إلى المستشفى. قامت القابلة بربط الخيط جيدًا حول سرّتي وقطعت على مسافة منها
تروي أمي هذه الحكاية كل مرة بتفاصيل جديدة تتذكرها أو تخترعها؛ فمرة كانت تلبس عباءة سوداء، ومرة حمراء وفي أخرى زرقاء نيلية. مرة كان الثلج يقطع الطريق، ومرة كان يشرع بالكاد في النزول، بينما في مرة أخرى مغايرة تماما كان الجو باردا جدا، هطلت نهار ذلك اليوم أمطار لكنّها لم تثلج أبدا، ولا تعلم من أين أتى أبي بحكاية الثلج تلك، رغم أنّها هي من ذكرت الثلج مرارًا. مرة كان أبي يصرخ فيها أن تصمت، ومرة يتجاهل عتاب صاحب السيارة، ومرة لم يكن والدي حاضرا تلك الليلة
أمّا القابلة فقد قامت بعملها في الطريق، ولكن في هذا بعض الشك أيضًا، ربّما عندما رجعوا إلى البيت، لأن ضوء الشمعة خافت والطريق محفر والهواء يدخل من تحت غطاء العربة ولا يمكن للقابلة القيام بذلك لأنّها ضعيفة النظر أصلًا. ومرة لأسباب أخرى لم تقطعه كأن تكون قد نسيت الخيط أو المقص أو الموس! أمي لا تردي أي آلة استعملوا لفصلنا عن بعض. أمّا في أخرى فأحضرته وكان خيطًا أخضرًا لأنّها في الصباح وجدته طويلا متدليا من سرتي فقطعت الزائد منه. تكركر أمي ولا أفهم لما قد يضحكها شيء مماثل؟
الأمر الوحيد الذي لم يتغير في روايتها هو غيض جارنا وشتائمه بسبب السياقة ليلا في شهر شتوي شديد مثل فيفري. أمّا أبي فلا يعلق أبدا عن هذا اليوم، وكأنّه كان غائبا. ينتظر أمي حتى تكمل قصتها ثمّ يلتفت إليَّ بود ويقول
– هكذا جئتِ إلى الحياة في ليلة غاضبة
– كل الناس يولدون بطريقة ما في ليلة ما، الفرق أن البعض ينسى والبعض مثل أمي
لوحة للرسام الروسي اليا ريبين