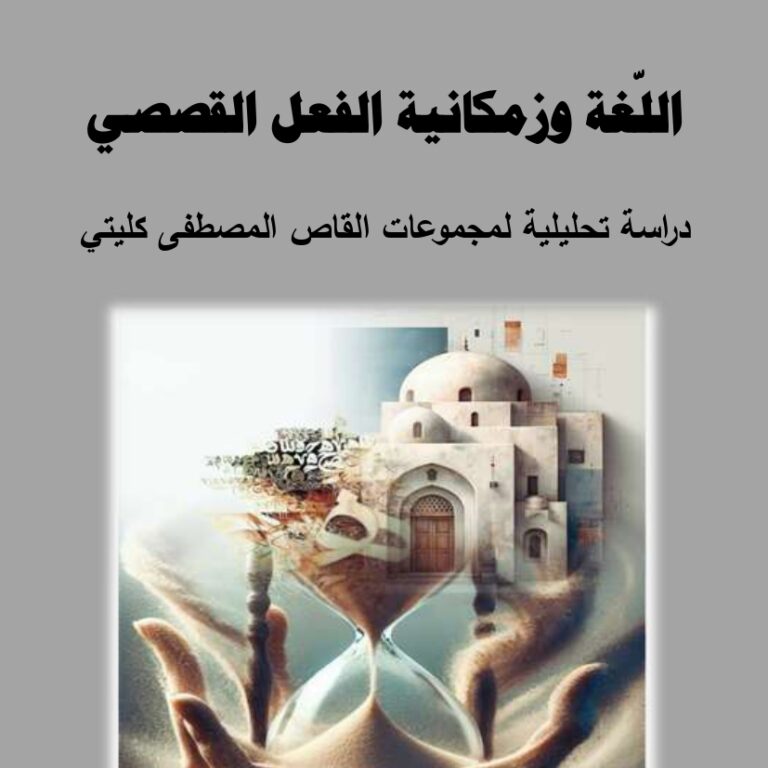عنوان الكتاب- في نبض العالم- سيرة الأعمى وقد رأى كلّ شيء
ضمن كتابهِ الشِعريّ الأحدث “في نبض العالم: سيرة الأعمى وقد رأى كلّ شيء”، الصادر عن دار الشؤون الثقافيّة العامة في بغداد؛ ينظر الشاعر عبد الزهرة زكي مليًّا إلى كل ما يحيطُ به من الموجودات، يتأمّل وبحنكةٍ أدقّ التفاصيل الحميمة، حتى تلك المُهمّشة، أو المتناهية في الصغر، ينظرُ لا ببصره فحسب، بل ببصيرته أيضًا؛ يقول: “في الحديقةِ الحسّية/ تتنزّه حواسُّ الأعمى./…/ تستيقظُ أنوثةُ الشجرةِ/ كلما مرّ برفقٍ على أوراقها/ حنانُ كفٍّ من أعمى”.
يكتبُ عبد الزهرة زكي (من مواليد بغداد 1957)، وهو يتقمّص دور “الأعمى”، سيرة حياة مُتخيّلة؛ يكتب بمنتهى الحذر والإدهاش. ثمّة “قائمة المؤلفين العميان”، “أثر المؤلف الأعمى هو بصره وبصيرته”، “ما لا تراه العيون”، “الورّاق الأعمى”، “ناظر القلب”، “ليس بأعمى”، “الحبّ دليل الأعمى”، “عُميًا ومُبصرين”، “نزهة الحواس”، “مبتكر حروف العمى البارزة”، “أبصرهُ”، “حرية الأعمى”، “أبصر توثّب أعياد الطبيعة”، “ذاكرة الأعمى”، و”بلاغة المُبصرين”، وغيرها من المفردات والعبارات التي تخصّ ذلك الجانب/ الحاسّة من الحياةِ، حياتنا.
الأعمى الذي يرى!
من المتعارف عليه أنَّ الأعمى تمنحهُ الطبيعةُ مجموعة حواسٍّ أخرى إضافيَّة، عدا التي اعتدناها، فإن كانت الحواسُّ لدى الفرد الطبيعيّ خارجيَّةً وتستقبلُ كل المعلومات الواردة من المحيط، فإنَ للأعمى حواسًّا داخليَّة يستعيضُ بها عن تلك التي في الخارج، تدلُّه وتُرشدهُ إلى حيث لا يمكن لبصيرٍ أن يذهبَ ويرى، وهذا ما استهلّ به الشاعرُ واستدلَّ به في بداية الديوان: “كلَّما زادَ الإنسانُ تبصّرًا في أحواله وأحوال العالم كوفئ بالعمى”، من كتاب: “عين الشمس” لـ د. عبد الله إبراهيم، لذا من الممكن أيضًا الاستدلال على البصيرة لدى الأعمى في أكثر من مكانٍ داخل العمل الشعريّ، حيث نقرأ ما بين السطور المكتوبة دلالاتٍ عدَّة على استكشاف الأعمى لما حوله، مفرداتٌ تشي بأنَّ كل شيءٍ واضحٌ أمام تلك العينين اللتين يخالُ للمرء أنَّهما لا تريان سوى السَّواد، ولكنهما في الحقيقة تريَان كثيرًا دفعةً واحدة، كعدسة كاميرا تسجُّل بدقَّةٍ عالية، ووتيرةٍ أعلى، وبلا كَللٍ.
اختار الشَّاعر في هذا الديوان العملَ على الدلالات بالنسبة للأعمى: “في العمقِ من أيِّ ركودٍ ثمة ما يتحرّكُ ويتغيَّر. هذه إشاراتُ نهارٍ جديد. مع تكرارِها كلَّ صباح فإنَّها قد لا تعودُ تثيرُ الانتباه. لكنّها تظلّ إشاراتٍ لها من القدرةِ ما يكفي لرجلٍ مثلي ليلمسَ من خلالها الشمسَ، شمسَ يومٍ جديد كلَّ صباح”.
حتَّى أنَّ حاسَّة الشمّ بها تغيّر مثل باقي الحواسّ الأخرى، وتكون على غير هَديها كما لدى المُبصرِ: “أستنشقُ ملءَ الصدرِ روحَ المطر، رائحتَه”. حيث تغدو الروائحُ أرواحَ تهيمَ على وجهها حول الأعمى وتمسكُ بيديه لتدلّه على الدروب بكل يُسرٍ.
أصواتُ الروائح
ثمة سرياليَّةٌ ما تموجُ فوق الكلمات داخل هذا العمل الشعريِّ ومفاصله كأمواجِ بحرٍ عاتيةٍ، ولكنّها لطيفة في الوقت ذاته، وكأنَّنا نتلّمسُ أبعادًا أخرى للمُعتاد البديهيّ، أو بمعنىً آخر، نستكشفُ أمورًا جديدة غير مألوفة. وهذا هو الشِّعرُ بعينه، أن تدفعنا القراءةُ إلى التفكُّر بالقلبِ والعاطفة، وليس بالعقل، أو بالمنطق الغالب والسَّائد.
أن تكون للأصواتِ روائحَ يُستدلُّ من خلالها على معنى الصَّوتِ ومكانه، هذا هو الشِّعرُ الذي يَهِبُ القدرةَ للأعمى أن يشتمّ الأصواتَ على أنَّها روائحُ: “إنّه خدرٌ له من الصفاءِ والسكون ما كان يجعلُني أسمعُ صوتَ تنفِّس أزهار الأوركيد غافيةً في أوانيها، ومعه أشمُّ صوتَ سقيطِ الندى على البَتَلات في الخارج، حتَّى لتَلمَس يداي الهواءَ، الهواءَ الحيَّ في الغرفةِ الدافئة”. كثيرةٌ هي النصوص ـ داخل هذا العمل الشعري ـ التي تعالجُ المُعتاد والبديهي بصورةٍ مقلوبة، ولكنها الصورةُ الأصحّ على ما يبدو لعالم الأعمى، والتي يمكن لنا بيسرٍ أن نطبّقها “وهي مقلوبة” على عالم المُبصرينَ أيضًا، فالصورةُ التي في المرآة ترى صاحبها، عوضًا عن أن يرى الصورةَ هو! باعتبارها نَسْخًا لملامحه، ولكن الملامح “الأصليَّة” على الوجه هنا، فيها نقصٌ في العينين/ العدستين، فتغدو الصورةُ هي الأصل عوضًا عن صاحبها، وبعبارةٍ موجَزة أن ترى الصورةُ بعينين تُبصران ملامحَ معدومةِ البَصر: “صورتهُ على المرآةِ التي أمامه لا يراها، لكنَّها تراه. تحدُّق الصورةُ في الأعمى الذي أمامَها، في الحطامِ الذي خلفَ ظهرِه، في رمادِ سنواتٍ تبعثرت ما بين الحطام، وفي لهبٍ تحتَ الرمادِ يكابرُ حتَّى أنَّهُ لا يريدُ أن يخبو”.
يكادُ أن يكون كتاب “في نبض العالم: سيرة الأعمى وقد رأى كل شيء” للشاعر عبد الزهرة زكي دليلًا للأعمى في حياته، أو لعلّها كـ “سيرةٍ” فعلًا هي سيرة الأعمى/ كلِّ العميان، رحلةٌ يمتزجُ فيها النثرُ مع الشعرِ بأريحيةٍ تامَّة، ومن دون أي غرابةٍ في الأمر، أو نشازٍ ما، يوميَّاتٌ ونظريَّاتٌ شعريَّة تعالجُ العمى بمنطقٍ شعريٍّ/ نثريّ غيرِ مألوف، يستقي، كما يشيرُ في نهاية الكتاب، من تجاربَ لأشخاصٍ من الأساطير، أو من حياتنا الرَّاهنة، ممن عاشوا تجربة العَمى، لتكون بمثابةِ وثيقةٍ، أو سيرةٍ ذاتيَّة لكل تلك التجاربِ الممزوجةِ مع تجربةٍ تخيليَّةٍ ـ ربَّما أيضًا ـ قد عاشها الشاعرُ ليتسنَّى له التماهي مع الحالة، ومن ثمَّ معالجة هذا الإحساسِ، وتدوينه شعريًّا.