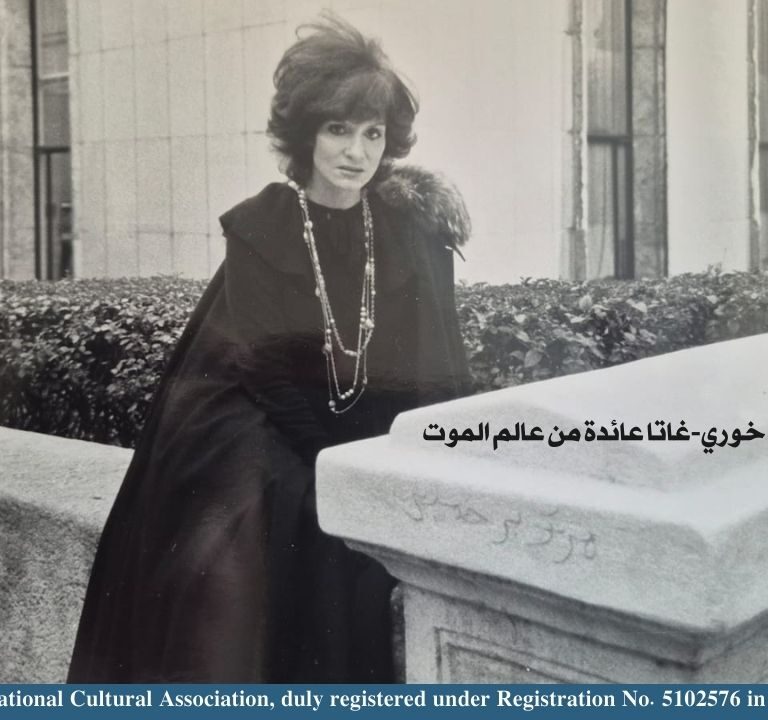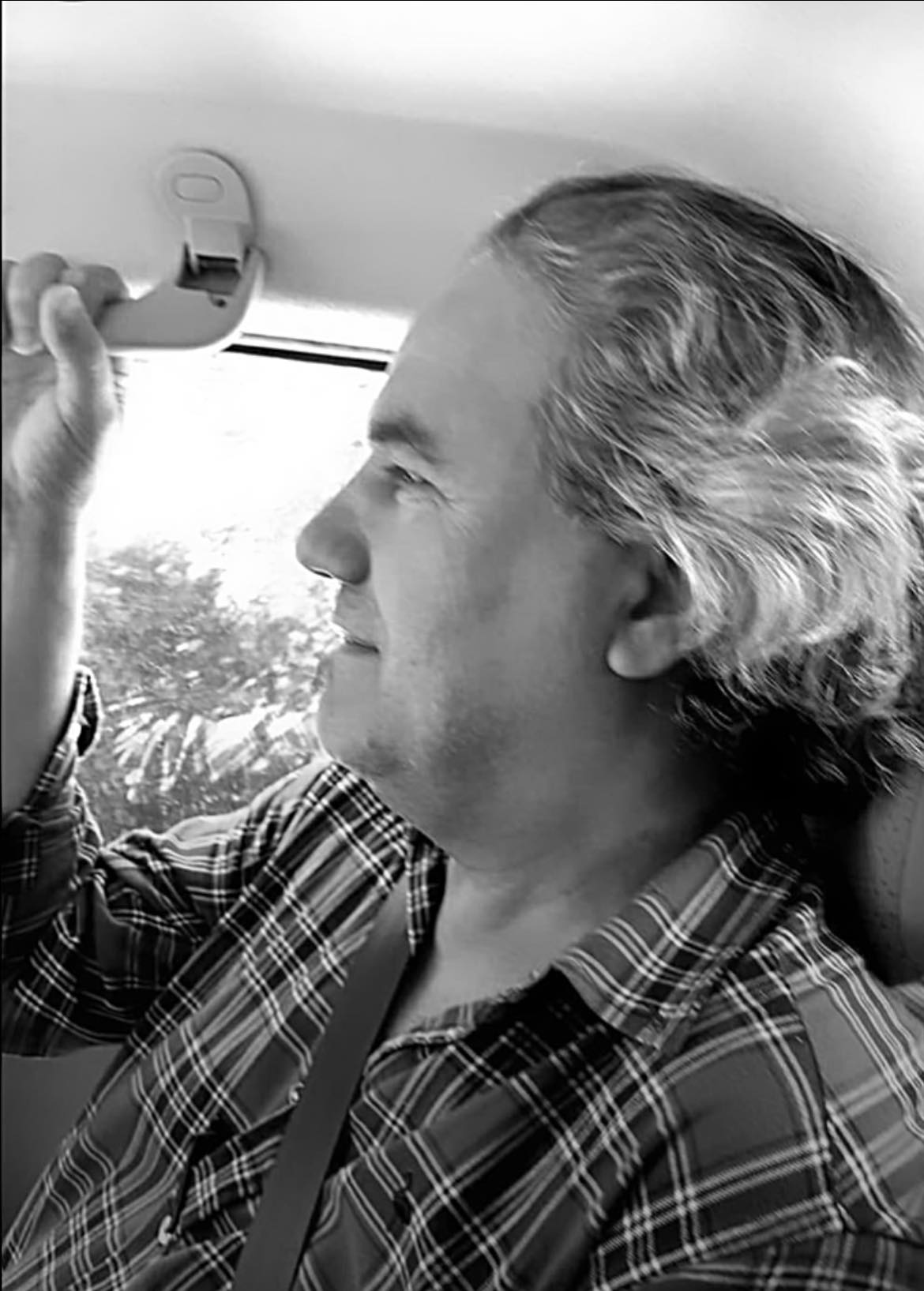
أمين الزاوي: هذا زمن نهاية الرموز الأدبية... كتابا ونصوصا؟
قطار يخفي قطاراً!
خلال هذا الوقت اللاهث الزاحف بعنف على كل شيء جميل في الإنسان والطبيعة، يبدو أن الآداب هي الأخرى لم تسلم من شرور جنونه، إذ أضحت الكتابة موسمية، مهددة بحس الاستهلاك السريع وبالنسيان الثقافي القاتل.
ثقافياً، لكل جيل رموزه الأدبية والفنية. وفلسفياً، يعد الرمز الثقافي الركيزة الثابتة لكل أمة، فهو الأسمنت الذي يربط ويقوي الذاكرة الجماعية ويجعلها حية ومتجددة.
لا وجود لأمة من دون رموز محلية وعالمية.
إن التاريخ البشري، تاريخ الأمم والحضارات، مسبوك ومشبوك بسلسلة من الرموز الثقافية والأدبية، منها ما هو موسمي ومنها ما هو دائم أو أبدي، سواء تعلق الأمر بالمبدعين أو بالنصوص الإبداعية.
أما الرموز الموسمية الأدبية فهي تلك التي تعيش لفترة محددة، وتعد مرجعية لجيل أو جيلين على أكبر تقدير.
في حين تتميز الرموز الأدبية الأبدية بقدرتها على أن تكون عابرة للأجيال، وبذلك فهي تمثل ما يمكن أن نطلق عليه اسم نواة السلسلة الناقلة للقيم بين الأجيال المتباعدة زمنياً، وبين الأمم المختلفة ثقافياً وعقائدياً ولغوياً، وهي أيضاً الجسر الممتد ما بين الأنا والآخر.
الرموز الأدبية هي ما يولد الاطمئنان الثقافي لدى الشعوب، داخل منظومة من الثقافات المتعددة والمختلفة والمتعايشة والمتصارعة في الوقت نفسه.
وباستمرار، تتعرض الرموز الأدبية للهجوم من قبل أنظمة سياسية أو سلط دينية ثيوقراطية أو سلط لغوية أو أيديولوجية، فتُشوه بالتخوين أو التكفير. ولإضعاف أمة ما، يبدأ باغتيال رموزها الأدبية، كما تغتال نخبها من رجالها ونسائها وكما تحرق أشجار غاباتها.
لكن لنتساءل، من يا ترى يقف خلف معجزة الولادة المعقدة للرمز الأدبي؟ العبقرية الشعبية؟ عبقرية الكاتب؟ أم كلاهما معاً؟
الرمز الأدبي ليس تفاهة يومية أو تسلية عابرة، ولا هو نزوة فكرية ساذجة، إنه نبوءة تاريخية للأمة وثمرة من ثمار عبقرية نخبها وشعبها.
وما نلاحظه على المستوى الثقافي والأدبي، أنه وحتى منتصف القرن الـ20 كانت الرموز الأدبية تعيش فترة زمنية طويلة، أي إنها كانت تعمر على المستوى الثقافي والسياسي وبصورة مرئية وملموسة. كانت هذه الرموز تورث من جيل إلى آخر في انسجام وهدوء ونقاش جاد. وكانت بعض النصوص الأدبية وبعض الكتاب يصلون إلى مرتبة التقديس من قبل أجيال ثقافية متعاقبة.
كان المتنبي وهوميروس وطه حسين وأحمد شوقي وابن رشد ودانتي وسرفنتيس وغيرهم، ولا يزالون، يسكنون ذاكرة جيلنا وذاكرة الأجيال التي سبقتنا، ولا تزال هذه الأسماء ونصوصها ومساهمتها ونضالاتها الثقافية والسياسية تبهرنا وتطرح علينا وأمامنا أسئلة كثيرة.
وهذه رواية “نجمة” لكاتب ياسين المنشورة عام 1956 لا تزال حاضرة في راهن الأدب، وبعد 70 عاماً على صدورها لا تزال تقرأ وتعاد قراءتها بشهية ثقافية وجمالية عاليتين، إنها من النصوص التي لا تصدأ.
حتى منتصف القرن الـ20، كانت الروايات – الرمز، والكتب – الرمز بصورة عامة، تعيش زمناً أطول من عمر مؤلفيها، يرحل الكاتب فتظل رواياته حية بين القراء والدارسين. أما اليوم، فنحن نعرف صورة الكاتب أكثر من معرفتنا لأعماله! إنه عالم زائف.
قرأنا جيلاً بعد جيل ثلاثية نجيب محفوظ المنشورة في بداية خمسينيات القرن الماضي، بنشوة أدبية مثيرة ومتعة فكرية رفيعة. ولا تزال الثلاثية حاضرة على الساحة الأدبية كرمز أدبي حي في الذاكرة الجماعية، مؤثر في الكتابة واللغة.
صحيح أن الروايات – الرمز هي في الغالب روائع أدبية، لكن من يمنحها الحياة الطويلة والطاقة المتجددة والنور الأسطوري هم القراء والنقاد والإعلام.
روايات مثل “البحث عن الزمن المفقود” لبروست و”مدام بوفاري” لفلوبير و”جيرمينال” لزولا و”البؤساء” لفيكتور هوغو، و”الحرب والسلم” لتولستوي و”الجريمة والعقاب” و”الإخوة كارامازوف” لدوستويفسكي و”النبي” لجبران خليل جبران لا تزال يعاد طبعها، وتدرس وتقرأ بنهم وبرغبة متجددة، ولا تخلو منها مكتبة عائلية أو عمومية.
أما ما ينشر اليوم من روايات فإنها تشبه الـ”فاست فود”، والوجبات السريعة ثقافياً تُستهلك بسرعة فائقة وتُنسى بسرعة فائقة أيضاً.
ومنذ سبعينيات القرن الماضي، نشهد ولادة أدب مصنع بمنطق سوق السلاسل الاستهلاكية! وإنها لظاهرة ثقافية أدبية تتزايد كمية وتتعاظم سطوة.
الناشرون في كل مكان يطبعون آلاف الروايات بكل اللغات، لتُنسى بعد أيام أو بعد أشهر في أحسن الأحوال الصحية الثقافية! المواسم الأدبية تتكاثر ومعارض الكتاب تنتشر، ومعها تتعدد وتتكاثر مقابر الروايات والكتب أيضاً!
عمر الرواية المعاصرة الناجحة لم يعد يتعدى بضعة أشهر، والرواية المحظوظة تعيش موسماً واحداً! إننا أمام مسرحية ثقافية أدبية عبثية، إذ فيها تدفن الرواية رواية أخرى، ليأتي من يدفن هذه الأخيرة ولن تكون سوى رواية أخرى تخرج للتو من المطبعة، وهلم جراً!
أصحاب مكتبات البيع المحترفون، المشرفون على أكبر وأشهر مكتبات البيع في العالم، لا يبقون على الكتاب معروضاً في الواجهة وفي الرفوف الأمامية إلا لبضعة أيام، يحدث بعض الاستثناء للروايات المتوجة بالجوائز الكبيرة فتبقى لبضعة أسابيع، ثم يُخلى المكان لكتاب آخر جديد.
أعتقد أنه على رغم وجود بعض روايات جميلة نشرت خلال الأعوام الأخيرة، فإن لا واحدة منها استطاعت أن تتحول إلى الرواية – الرمز. إن آخر الروايات – الرمز العالمية والتي لا تزال صامدة وتؤثر في قراء العصر الجديد هي “مئة عام من العزلة” لغابرييل غارسيا ماركيز.
إن روايات اليوم، على رغم نجاح بعضها في المكتبات، وعلى رغم أرقام المبيعات العالية المسجلة، وعلى رغم الضجيج الإعلامي، فإن عمرها ينطفئ بسرعة وسريعاً توضع في درج النسيان الثقافي.
وفي هذا السباق الأدبي المحموم والمسكون بحس الاستهلاك، من منا يتذكر أسماء الحاصلين، قبل عامين أو عام، على جائزة “نوبل” للأدب أو “غونكور” أو “سيرفانتس” أو “بوكر”، أو “بوليتزر”.
قطار يخفي قطاراً!
بسرعة يتلاشى اسم الكاتب المعاصر من الساحة الأدبية، يختفي، يسقط كأوراق شجرة تعيش خريفاً يدوم الفصول كلها، مهما تعددت الجوائز المحصل عليها والتكريمات التي حظي بها، ويختفي الحديث عن أعماله أيضاً، يحدث كل ذلك بسرعة مذهلة في ظرف أسابيع قليلة، فترى الكتاب الذي ملأ الدنيا وشغل الناس يوضع على رفوف مكتبات مهجورة يغطيها الغبار، ليسقط فجأة من ذاكرة القراء.
حين تجد جيلاً بلا رواية – الرمز، بلا كاتب – مرجع، فاعلم أنه جيل محكوم عليه بفقدان الذاكرة، والحلم، والمناعة
المصدر: