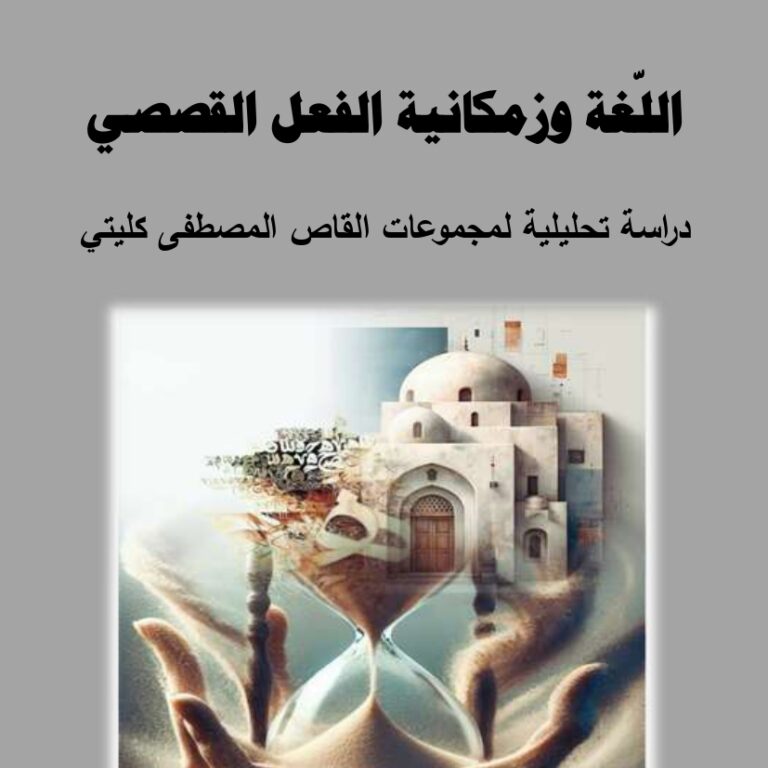1-
 التعرية .. الحَجب .. أهداف متتامة
التعرية .. الحَجب .. أهداف متتامة
إذا كنّا نتفق مع الكاتب (عبد العالي اليزمي) بأنّ”الجسد كان وما يزال، سواء في واقعيته أم في تعاليه، محور الفنون، وكان معايشة يومية. وتدرَّجَ في الخضوع إلى رياء مزدوج: سواء عندما يُستر أم عندما يُعرَّى. فهو يستر رياءً عندما تستره كل المؤسسات، ويُكشف رياء أيضا عندما تكشفه الكتابة (قصدًا)، فتسقط في دائرة ردّ الفعل؛ إعادة إنتاج الجسد” فإننا نتّفق مع رأي آخر بدا لنا وجيها إلى درجة كافية، وقد طرحه أحد الكتاب ويتمثّل في أنّ رؤية المؤسسة الاستهلاكية الإعلانية للجسد تتماثل أو الأدقّ تتكامل مع رؤية المؤسسة الدينية له، فالأولى تفترضه هدفا يجب أن يُعرّى من خلال البصَريّ: صور الإعلانات والفيديو كليب ونحو ذلك من الإشهارات المماثلة، بينما تعتبره المؤسّسة الدينية هدفا بصَريا لكنّه يجب أن يحجب هذه المرة، وهو ما وضعه الناقد فاروق يوسف في حقل التطبيق حينما كان يرى أنّ للجسد “صورته التي تخدع. سواء أحضر عاريا أم محتجبا فإنّ ما لا يرى منه يضعنا على الطريق التي تؤدي إليه… العري من جهة يقابله الحجب، وما بينهما يقف الجسد متسائلا وعاصفا وممتنعا” دارسا نموذجين لوجهي هذا التعامل مع الجسد، فكان في إمكان المصوّرة الفوتوغرافية الإيرانية شادي قدريان، بنسائها القابعات خلف حُجُب أن تجيب عن أسئلة نساء الفرنسي باسكال رونو العاريات، والعكس صحيح أيضا. فـإنّ “نظرات المصور الفرنسيّ باسكال رونو لا تسيل على الجسد الأنثويّ مثل رغبة عابرة بل تحرثه بشهوات عارمة حتى ليبدو بعدها ذلك الجسد كما لو أنه قد استـُدرِج إلى منطقة نائية من صفائه. جسد مصفّى يستعيد سحر النظرة الأولى التي ألقاها على الكون، يوم كان كلّ شيء مشدودا إلى البداية المبهمة… كانت شفافية النظر لدى رونو تعكس ما يحدثه مرأى جسد في عينه من تأثير بصري يكون ممتنعا عن الظهور في جسد آخر، رغم أنّ كلّ هذا العري لا يقع صدفة، بل هو جزء من آلية التعرّف التي يودّ الفنان تجريبها”.
بينما لا تصوّر المصوّرة الفوتوغرافية الإيرانية شادي غديريان التي ولدت في طهران عام 1974 وما تزال تعيش هناك، نساؤها عاريات بل تدثّرهن بما تلقي عليهن المؤسسة الدينية المهيمنة من أغطية تقود المتلقّي إلى المسكوت عنه في إعمال غديريان، وهو الجسد العاري المغطّى بــاحتفال وحشيّ، كما يصفه فاروق يوسف، ويستنتج أنّ لا باسكال رونو عرّى نساءه، ولا شادي غدريان حجبت نساءها. كان عري نساء رونو حجابا لأجسادهن، وكان حجاب نساء قدريان فكرة عري متطرفة.
إنّ تجربة أخرى في التصوير الفوتوغرافي يمكن أن نعدّها تجربة جمعت المتنين السابقين في تجربتي باسكال رونو وشادي افرين غديريان، عندما تبني المصورة الفوتوغرافية تانيا جراماتيكوفا Tanya Gramatikova تجربتها من أجساد، إذا حاولت أن تسترها فليس أكثر من ستر يكشف عما تحته ليكون كأستار النصّ التي تريد أن تقول ما تحذفه، وبذلك يكون الأمر الحاسم في الصورة ليس ما يظهر بل ما يكشف عما يختفي، وبذلك تهيمن هذه المصورة الفوتوغرافية على تفّاحتي الفرنسي باسكال رونو والإيرانية شادي غديريان بيد واحدة (تجربة واحدة)، ففي تجربة هذه المصوّرة الفوتوغرافية يتجسّد الجسد بطريقة مواربة تحمل الفكرة ونقيضها في وحدة غريبة ومقلقة فيما يخص تعاملها مع الجسد الإنسانيّ؛ حتى أنها تتّخذ الموديل ذاته لتكشف عنه حجبه مرة، ولتدثّره بتلك الحجب تارة أخرى، باحتفال يكرّس الجسد، في بعده الشيئيّ وفي ماديته على الأقل .. موطنا للدلالة.
تسقط تانيا جراماتيكوفا تعاملها مع الجسد، باعتباره سطحا مليئا بالمعنى الكامن، على كلّ سطوح المحيط، فهي تتّخذ الجدران، والأزقة، وموجودات المحيط باعتبارها نصوصا مكتظّة بمعنى مخبأ وذا أفق محيطيّ، فكانت تصوّر الأزقّة الضيّقة ذات الجدران العتيقة باعتبارها عيّنة تصوّر الجزء الظاهر من جبل الجليد: مدينة غاطسة ومغطّاة بقدر لا حدود له من عري المعاني الخبيئة التي أوحت بها المصوّرة دونما إفصاح.
2-
الجسد بعدا متيرياليا
إنّ ما يهمّنا كتشكيليين في علاقتنا هنا بالجسد هو العلاقة الشيئية (المتيريالية) به؛ وذلك حينما يتحوّل الجسد بيد الرسام إلى علاقات لونية متفجرة، أو يتحول بيد النحّات إلى كتلة مادية تتواشج وتتناغم علاقتها مع عنصر الفراغ المتاخم لها: فقد كان اهتمام الرسّامين بالجسد البشريّ اهتماما يسمو على اليوميّ ويرتقي إلى أن يكون نبعا دائما للإبداع وهو ما انتهى إليه الرسّام فرنسيس بيكون الذي أنفق كلّ حياته الفنية “يلتهم بريشته وجوه وأجساد من يرسمهم وكأنّه ينجز قداسا بدائيا، محوّلا كلّ موتيفاته الفنية إلي قرابين ووسطاء حالات من العنف الفنّيّ… للتدليل علي أنّ الإنسان منذ وجوده في الحياة وهو يتلذّذ بصناعة الفاجعة، وكلّما ازداد إحساسه بالذنب ازداد إلحاحه على الانتحار في الحياة أو من أجل الحياة هاربا منها إلي حدّ الاستسلام أو مقبلا عليها إلى حدّ الغطرسة” (سعيد بوكرامي)، كلّ ذلك يجري عبر وسط مؤثث بتقنينات لونية مفضلة عند بيكون: يهيمن فيها اللّونان الأحمر والأصفر، أو تهيمن عليها خلفيتُها السوداء، فكان يضع أهمّ أهدافه التقنية في تأثيث المشهد اللونيّ للتّعبير عن الحقيقة الداخليّة لتلك الكائنات التي تمارس صراخها الأبديّ من خلال: خربشات سطح اللوحة (=الجلد البشري)، أو استثمار الموتيفات “الفوتوغرافية التي تقدم ضبابية الوجه” حينما كان يستخدم الصور البشرية الظلّيّة (النيجاتيف)، أو في توظيف اطر الأقفاص الحديدية التي تطـْبـِق بفكيها على الكائن؛ وهو الأمر ذاته الذي وظّفه الرسام محمد مهر الدين في ستينات القرن الماضي وسبعيناته حينما كان أبطاله ممثّلين في عرض مسرحيّ يؤدّون فيه دورهم في حفلة تعذيب منظمة تجري أمام مرأى الجميع؛ وبذلك تتجسّد في ذلك الجسد (نصوصية) تجعله قادرا على تدوين تاريخ النفي الذي مورس ضده، فكان تأريخا للعقوبة وتدوينها، تلك العقوبة المستحقّة والمطروحة سلفاً.. إنّها عملية تشييء للعذاب في الجحيم من خلال نفينا في الحياة الأرضية، فكان تأريخ الجسد تأريخا لتدوين الفكر، فمنذ بدء ظهور الشهوات المرتبطة بالجسد كانت العقوبات مهيّأة له.
إنّ تحوّل الجسد بيد الفنان إلى بعد شيئيّ مادّيّ ملموس يلخّص عبقرية المبدع هنا، فقد استطاع رودان أن يجعل من الكتلة التي تمثّل الجسد البشريّ ليس إلا “معجزة تركيبية تداعب الفراغ… كونه قد اهتمّ بالفكرة الفلسفية وراء الخامة الذي يقوم بتشكيلها”، لقد كرّس حياته لقراءة الجسد الإنسانيّ، وهو ما حقّقه حينما أنجز عمله المشهور ( بوابة الجحيم) الذي استغرق في تنفيذه عشرين عاما، وزيّنه بآلاف الوجوه بعد أن قضى ستّ سنوات درس فيها أعمال الفنان الكبير (روبنز) وأُغرم بتقنيته الحركية في التصوير.
إنّ تحوّل الجسد إلى وجود مادّيّ كان المشكلة الأساسية التي بنى بها النحت العراقيّ والنحت المصريّ بتجلياتهما القديمة والحاضرة (جسدهما)، وكما في تجربتي الرائدين جواد سليم ومحمود مختار، لم تخرج موضوعات وميدان اشتغال تلك النحوت عن المشخص بل وتحديدا الجسد الإنسانيّ وتضاريسه إلا عند قلّة من النحاتين وأهمّهم عبد الرحيم الوكيل، وهو ما كرّس له وفيُّه النحّات هيثم حسن جهده كله ولكن بأهداف مختلفة عمّن سبقوه، فقد كان السابقون يهدفون إلى اختبار طواعية الجسد الإنسانيّ، وتحديدا جسد المرأة عبر طواعية المادّة التي هي هدف يمرّر عبره اختبار طواعية الجسد، كما يختبر قسم منهم كفاءته في المهارة التشريحية في الجسد الإنسانيّ، بينما شقّ هيثم حسن لنفسه، في آخر المعارض المهمّة للنحت العراقيّ، برزخا مختلفا حينما حاول اختبار الطاقة التعبيرية لموادّ حديثة ولكن من خلال الموضوع الأزليّ: الجسد الإنسانيّ (المرأة)، فكانت تجاربه تلك على الجسد الإنسانيّ تقطيعا وتحزيزا وتلوينا ما هي إلا صفحات متتالية ومتتامة في اختبار مادته الصناعية الجديدة. وإذا كان النحّاتون الآخرون يظهرون، موقفا محايدا من المادّة، فإنّ هيثم حسن لا يخفي موقفه المنحاز من مادّته التي يعتبرها موطنا للدلالة وليس وسيطا لها كما يبدو لنا.
3-
التعرية.. صلة بالواقع، ونبوءة بالموت
لا يقتصر مفهوم التعرية، في الفنّ، على الجسد الإنسانيّ، فقد كرّسه شاكر حسن آل سعيد من خلال (التعرية الشيئية) باعتباره مفهوما أوسع من علاقة النظر بالجسد، فكان يعدّه بمثابة “العدّ التنازليّ من أجل الوصول إلى معنى (الصفر) بالمفهوم الرياضيّ” معتبرا العمل الفنيّ، وهو على مكانته الأولى، يمثل قيمة صفر، لأننا حين نقبله كسطح تصويريّ مجرد فذلك لأنه لم يصل إلى (نقطة الصفر) بعد، حيث لم يزل خاماتٍٍ بطورها غير المتشكل، وذلك يعني أنّ التعرية الشيئية في مفهومها الرياضيّ تكمن في ما قبل حالة (الصفر) في التعبير الفنيّ، فهي عملية حفريات آثارية، أي هي (الإزالة) القصدية للمظهر التراكميّ للطبقات الاثارية من أجل المعرفة، وهي معنى معاكس (للحدس) بالتراكم.
إنّ التعرية مفهوم كونيّ، فالطبيعة تتعرّى بفعل مؤثراتها، وعشتار تتعرّى بفعل قوانين العالم السفليّ، وهكذا تظهر معالم التضاريس السلبية أي (المتقعّرة) لا (المحدودبة) كنتائج لهذه التعرية) كالأخاديد وشقوق الأرض(، مما يجعل التعرية بمثابة المحور الأول في الكشف عن (تشيؤ) العمل الفنّيّ الذي يمكن عده مرجعية في احتكام النقد إلى اللوحة (لذاتها) دونما احتكام للفنّان أو الجمهور، وبذلك يجد (الناقد) آل سعيد (التبرير) الفكريّ لمنجز (الرّسام) آل سعيد في بحثه في التحريز والشخبطة والتخديد (من أخدود).
إنّ للتعرية والتراكم جوانب فعل في الإنسان وإن لم يذكرها آل سعيد، لكنّ المتلقّي يستشعرها باعتبارها مسكوتاً عنه، وهو ما استشعرناه في تجربة آل سعيد في الرسم، وفي الكتابة بدرجة ما، فإنّ عمله في أيامه الأخيرة كان محاولة دائمة لإجهاض فعل (التعرية) التي يتعرّض لها شخصياً بفعل تقدّمه بالعمر 😊 تراكم الوهن الجسديّ وما يحدثه في (كمّه) الثقافيّ)، أي في تطوره الثقافيّ الذي كان يطوّره في كلّ مقال ينشره، وبذلك اعتبر، وبشّر بفكرة أنّ الفن (ونحن نقصد بالفنّ لأهدافنا هنا الرسم والفوتوغراف) في جوهره هو مفهوم متيريالي (شيئية اللوحة باعتبارها سطحا تسكنه الألوان)، ولم يكن يعني في النهاية إلا بحثا في استخدام المادّة على سطح، فقد اعتبرها “فنا يكتشف (ذاته) في السطح التصويريّ”.
وإذا كانت الشيئية تكشف عن جوهرها في سطح الجسد (الجلد) فهي كذلك تكشف عن ذاتها في أيّ سطح آخر ضمن المحيط، وهو السبب الذي دعاه إلى استقراء الحيطان الرثّة في الأزقة الشعبية باعتبارها سطوحا تمتلك مسوغات اعتبارها لوحة، وهو ما فعلته الفوتوغرافية تانيا كراماتيكوفا، حيث يتوفّر لتلك السطوح وجود شيئيّ يسوّغ اعتبارها عملا فنيا، أي جزءا من نسق الرسم دونما حاجة إلى: وجود صانع محدّد، ونيّة مسبقة عند ذلك الصانع، بإنتاج لوحة تنتمي للفنّ، أي لنسق ما، فكان يتّخذ الجدار جسدا (بمقام الجسد مقابل الجثّة)، باعتباره جسد اللوحة النابض بالحركة في سكونه، والنابض ربما بالوجود كواقعة شيئية بماديتها أولا، وبتقنياتها؛ وبذلك يتّخذ الجدار مقام العمل الفنيّ بعناصره المادية المختلفة ممّا يجعل الفنّ نشاطا يتعلق بالسطح التصويريّ في مبدئه ومنتهاه.