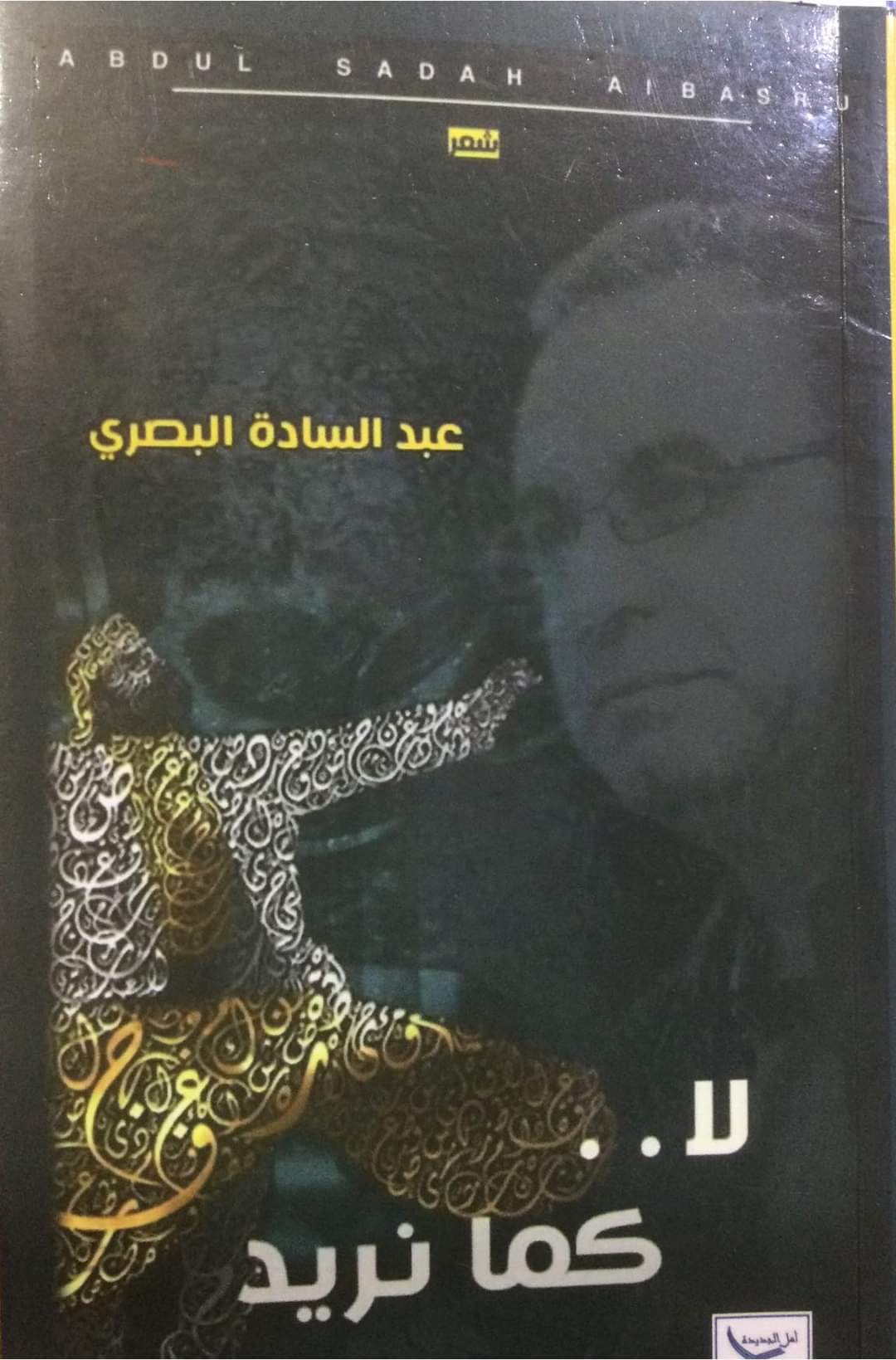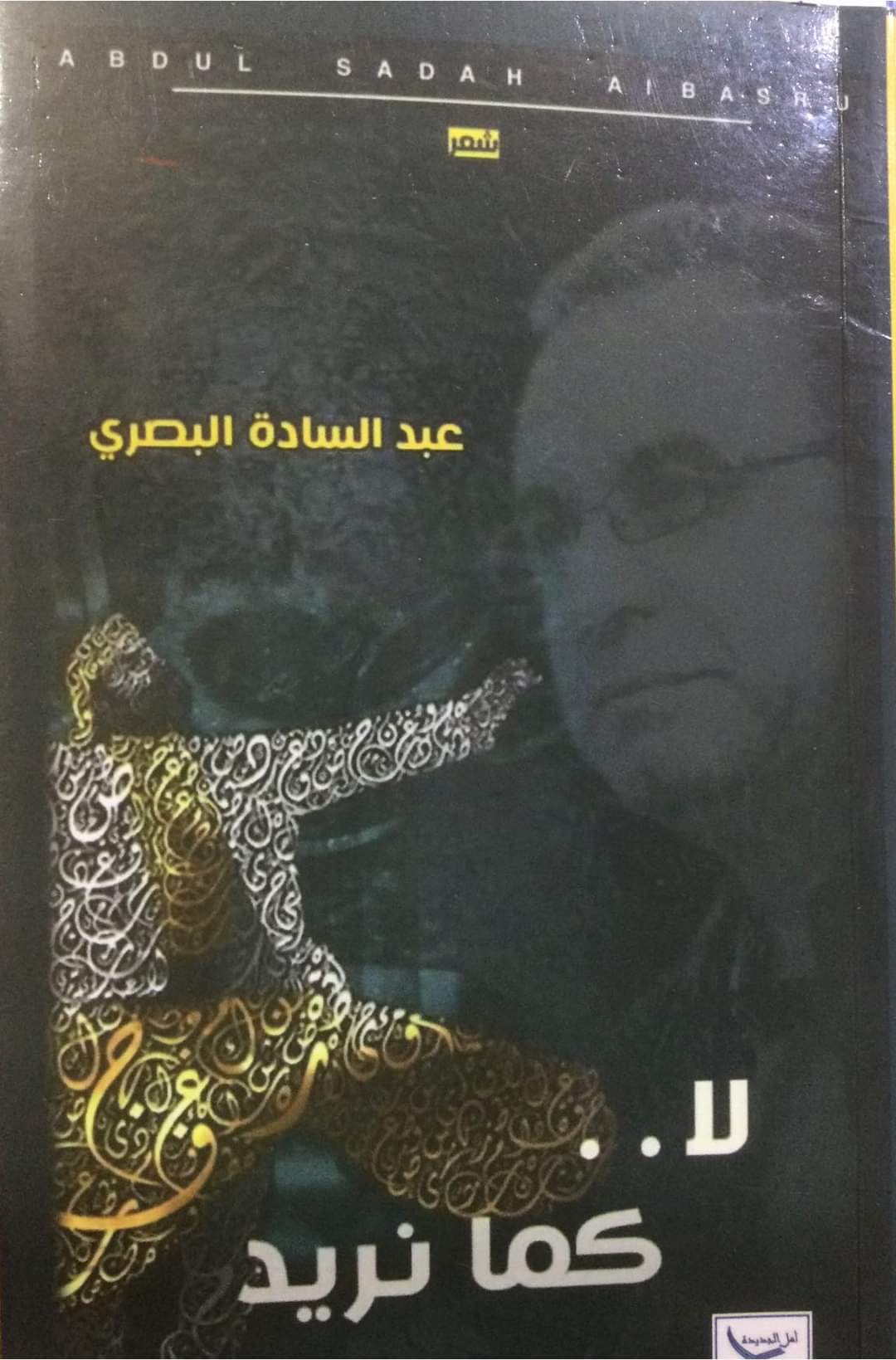

ثامر سَعيد
في كتابه الشعري ( لا .. كما نريد ) يجترحُ الشاعر عبد السادة البصري عتبتين رئيستين قبل أن يمنحنا فرصة الإستشراف على عوالم المتن , أولاهما العنوان الذي يفتتحه بحرف النفي (لا) والذي يستخدم كما معروف للتبرئة أو كما يسميه النُحاة ( لا : النافية للجنس ) حيث يُصنف كأداة نحتية تدخل على الجملة الاسمية وهي نافية للمجموع , ويُقصد بها أيضاً التنصيص على استغراق النفي كله . بمعنى آخر : هي الدالة على نفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها على سبيل الاستغراق حيث لا سبيل إلى الاحتمال أو الاختيار قطعاً . فنفهم من هذا إن كل ما أرادهُ الشاعر وما تمناه في حياته كإنسانٍ لم يتحقق ولا أقول كشاعرٍ فأحلام الشعراء جدُ شاهقة ولا يمكن أن تتحقق
وبما أنه من جيلٍ عانى الكثير من الخسارات والهزائم وجَهَ المعنى بصيغة الجمع ( كما نريد ) ولم يقلْ ( كما أريد ) ليشمل هذا المعنى أقرانه كلهم الذين عاشوا تلك السنوات المكتظة بالفقدِ والنكوص والتهميش وإطفاء الأمنيات ومنهم أقرانه من الشعراء
أما العتبة الثانية فهي عتبة تجنيسية للكتاب ( قصيدة من الحياة اليومية ) , عتبة تشير إلى القصيدة القابلة من تفاصيل الحياة وهي تجمع بين المنظور والمتخيّل وليس كما يتوهمه كثيرون بأنها تسجيل وثائقي مسطح تشبه ما يكتبه الموثّقون في دفاتر مذكراتهم , قد تحمل هذه القصيدة أشياءَ كثيرة تحاكي الذات لكنها في الوقتِ عينه قد تتسلق جدار الشعر كشجر اللبلاب لتطلَّ على حدائقه فتمنحنا الكثير من الدهشة حين تتصدى للمألوف فتجعله داهماً وللقبيح فتُصيّره بهياً ساحراً , وهذه هي وظيفة الشعر التي حين نفشل في إتقانها نخرجُ من فردوسه منبوذين منكسرين . لذا يتحتم على الشاعر الذي يتصدى لهذه القصيدة أن يتجاوز السطحي والمباشر إلى الشعري المتأجج , ولا أقول هنا أن نُغرق تفاصيلها ( القصيدة اليومية ) بالترميز الشائك والتأويلات المتعبة فهي لا تحتمل ذلك , هي لقطةُ حياةٍ سريعة عليها أن تمر بأناقة ورشاقة بعد أن تغمرنا بعطرٍ شاهقٍ يستمر طويلاً وأن لا تكون كحبة عنبٍ تذبل بعد أن نقطفها بساعاتٍ قليلةٍ
رهطٌ كبيرٌ من النقاد الذين كتبوا عن القصيدة اليومية كانوا قد توقفوا عند البيان الذي نُشرَ في العدد الخامس من مجلة الكلمة 1975 لشعراء سبعينيين ( غزاي درع الطائي \ خزعل الماجدي \ عبد الحسين صنكور ) حين اتفقوا على أن ( كتابة القصيدة اليومية , تحويل الحلم الفردي إلى حلم جماعي ) لتكون حسبما أرى بعيدةً عن المذكرة الشخصية المدونة قريبةً من الهم الشعري الشاسع . وهذا لا يعني إن هذا النمط الشعري جاء وفقاً لاكتشاف هؤلاء الشعراء فحين نتوغل عميقاً في الهيكل الشعري العربي نجد الكثير من هذه القصائد منذ العصر الجاهلي حتى الفترة المظلمة وما بعدها , ولا أريد الخوض كثيراً في إثبات ذلك كي أترك فسحة أكبر للكلام عن كتاب البصري الصادر عن دار أمل الجديدة – دمشق 2021 ويكفي أن نتذكر عنترة بن شداد وهو يلتقط من معمعة الحرب لقطة شعرية ( لحظة ) لابتسامة حبيبته (عبلة ) من التماع السيوف الذي تبرق كبريقها , أو مناجاة الحمداني للحمامة النائحة على شباك سجنه حين وقع أسيراً , أو يوميات الحسن بن هانئ التي سطرها شعراً في قصر الخليفة وقبله عمر بن أبي ربيعة حين ينتظر هطول الليل وينام الناس ليقصد خيمة حبيبته ( نُعْم ) ولم يستطع رؤيتها وهو الذي طالما تعرّف على وجودها في خيمتها من رائحتها , أو حسد السياب لديوانه الذي تحمله الجميلات على صدروهن ولا ينظرن إليه هو أو ينشغلن بشخصهِ , وبعده سركون بولص وهو يتحدث عن كركوك وأبقارها النائمة في ظل المصفى تجتر الأشواكَ لتمخض الحليب , حيث نلاحظ الإشارة الخفيّة لحياة الناس في ذلك الوقت هناك وليس لأبقارهم أو عن ليل نيويورك المزركش بمصابيح النيون الفاقعة والتي تشبه كدماتٍ مطلية بالمساحيق في وجه عاهر أو بيروت التي تخرجُ من فمه سوداء محترقة على البحر , وغيره كثيرون
كل هذه اللقطات الشعرية هي قصائد يومية من تفاصيل الحياة المُعاشة لكنها صٌنفتْ وفقاً لأغراض شعرية شائعة كالغزل أو الرثاء أو البكاء على الأطلال أو الخمريات أو غير ذلك
وليس هنالك من نصٍّ شعري كُتبَ بعيداً عن المؤثرات الثقافية والسياسية والعاطفية والاجتماعية والتاريخية , حتى الشطحات التي تُنتجُ من تجليات نفسية خاصة كالتجليات السوريالية أو الصوفية , فهي ثقافة أيضاً لكنها ثقافة مجنحة عاصفة لا تخضع إلا لأمزجة أصحابها المختلفة عن المألوف والشائع , والمكان واحدٌ من هذه المؤثرات الثقافية فهو يحفرُ أوشاماً عميقةً في نصوصنا وهو الذي يسكننا ونسكنه كل العمر ويسهم في تشكيل تجاربنا كلها , والشاعر عبد السادة البصري ابن مدينةِ ( الفاو ) النازحُ عنها قسراً بسبب الحرب الطاحنة والتي تتميز عن كل مدن العراق بإطلالتها على البحر و اكتظاظها بغابات النخيل والحناء والمشمش وقوارب الصيادين الآتية من أعالي الموج بأصناف السمكِ والمواويل , وطيبة أهلها ووداعتهم لذا مازالت إلى الآن تذكِره بأولئك القرويين البسطاء وتفاصيل حياتهم التي لا نجدها في المدن الكبيرة ( القرويون المعجونون بطين الأرض \ الحالمون بنهاراتٍ مشمسة دوماً \ الناثرون وردَ طيبتهم على الطرقات \ العابقون برائحة الأرض بعد المطر \ لمّا تزل لياليهم سَمَراً وحكايات \ وصباحاتهم عشقاً وعملاً \ القرويون مازالوا يسكنونني !! ) , نصُّ مجردٌ تماماً من الفخامة اللغوية والألاعيب الشعرية المقصودة والترف الكلامي الفائض , يلتقط لك صورة حياتية سريعة ويضعك أمام خاتمة جميلة تشي لك دون لف أو دوران بأنه رغم تحولات المكان والزمان مازال مربوطا بذلك الجذر ( الفاوي ) في نهايات تراب الوطن كحبل سري لا يمكنه التخلي عنه فهو حبل الحياة (( القرويون مازالوا يسكنونني ! ))
في الموروث الشعبي للبصريين قد تصادفكَ الكثير من المصطلحات والتي تتداولُ هناك في أقصى الجنوب ولا يعرفها سواهم في مدن الوطن الأخرى , تطفحُ من الخصوصية الجغرافية والمناخية لهذه المدينة التي تشتبك فيها كثيرٌ من الثقافات البعيدة بسبب انفتاحها على البحر وما وراء البحر من ثقافاتٍ ولغات , من هذه المصطلحات ما هو محلي مطلق ومنها ما هو هجين , وهي كثيرة لو استثمرها شاعرٌ ما يمكنه تأثيث الكثير من القصائد اليومية بمتعةٍ مضافةٍ , فهي كالبهارات التي تعطي طعم الكلام لذاذاتٍ محببة . من هذه المصطلحات الغريبة (( الباحورة : وهي شدة الحرارة والرطوبة صيفاً , والبارح : ويقصد بها نوعاً من الرياح ينتظرها الناس هناك تهبُّ ليلاً ليتمتعون بنومٍ هانئ على أسقفِ البيوت أو باحاتها , ومرطبانة الخلال : وهي أيام الصهد الشديد التي تُنضج التمور , ومقيّلين : المأخوذة من وقت القيلولة, وعصّارة التمر : وهي أيام أشد حرارةً من مرطبانة الخلال تأتي بعدها حيث يستوي التمر في أعذاقةِ تماماً ويسيلُ عسله في السلال أو تحت ظلال السعفِ ))
( عندما كنّا … \ نستحمُّ بماء أجسادنا \ من شدّة الحرِّ \ تقول أمي : \ لا عليكم … إنها مرطبانة الخَلال \ وفي آب اللهّاب … \ تتقشرُ بشرتنا \ نحن أبناء الفلاحين \ نقضي اليوم مقيّلين في النهر \ لنرطّب أجسادنا \ لحظته… \ توبّخنا أمي قائلةً : \ أتهربون من عصّارة التمر ؟! \ وبين الترطيب والعصر تمرّنت أجسادنا \ صرنا نقيس حرارة هذا الصيف من ذاك \ ونسمّي الطقس بأسماء سكنت ذاكرتنا … \ يا لذاكرتنا كم من الأسماء والأحداث قد خزنتْ \ وما نزال نستحم بماء أجسادنا ؟! ) .عودة الشاعر إلى البواكير حيث القرية المتطرفة بكل شيء ( المكان القصي الذي جعلته الكثير من السلطات منفىً لمعارضيها , المناخ , الفراديس الباذخة , الطيبة , الكرم , فطرة الأشياء , البرزخ بين ماءٍ وماء , وأشياء كثيرة ) . والأم التي توبّخ الأبناء بعد أن تشعر أنهم ضعفوا أمام نواميس الطبيعة الخشنة التي تصنع الرجال الذين تنتظرهم يكبرون كأسلافهم . نحن ندرك إن الكثير من تلك النواميس قد تغيرت بعد أن تطورت الحياة بين زمن قرية الشاعر وهذا اليوم لكن النصَّ يخبرنا أن لا شيء قد تغير ( كنّا نستحمُّ بماءِ أجسادنا \ ……… \ ما نزالُ نستحمُ بماء أجسادنا ) , هذه الحقيقة الصادمة تجعلنا مذهولين في بلد من الطبيعي أن يكون يومه أفضل من غدهِ مثلما يحدثُ في بلاد الله الأخرى لكن متوالية الخراب التي أنتجتها سياسات حمقاء فعلتْ عكس ذلك
كثيراً ما أقول : أن القصيدة مثل الكأس تتركزُ لذّتها في ثمالتِها ولا أقصدُ هنا إن الشراب الذي قبل الثمالة فيها ليس بالضرورةِ أن لا يكونَ لذيذاً وإلا كنّا قد امتنعنا عن شرابه فلا نصل إلى ثمالتهِ لنستمرئها , لذا حين يُقفلُ النص الشعري بخاتمةٍ ذات طاقة شعرية كثيفة تنفجرُ أمامك كبرقٍ خاطفٍ هائلٍ بجملةٍ واحدةٍ أو اثنتين أفضل كثيراً من النص الذي يختمُ بنهاياتٍ باهتة فمباراة الملاكمة التي تنتهي بالضربة القاضية أكثراً إمتاعاً من تلك التي تنتهي بالتعادل أو جمع النقاط . في نصوص ( لا .. كما نريد ) اهتم الشاعر في بعض النهايات فكانت موفقة مثل ما انتهتْ به نصوص ( القرويون – أتعلم – تداعيات – بؤس – خواء – سيناريو – ساهم ,,, وغيرها ) لكنه اكتفى بنهاياتٍ خبرية بسيطة لنصوص أخرى , ففي نص ( كل صباح ) يبدأ ب ( وأنت تنهضُ من نومِكَ \ أصغِ إلى موسيقى العنادل … \ وهي تعزفُ ألحانها على سدرةِ البيت ) مفتتح رومانسي يتحول إلى مشاهدَ تراجيدية قاسية تصور لك أيام العيد في زمن الوباء اللعين كورونا ( دعْ عينيك تغازلان الرصيف \ ودندن بأغنية خاوية ) وينتهي بخاتمة جوابية بسيطة جداً ( لأن العيد محبة \ والمحبة فرح \ والفرح حياة ) , كلنا يعرف إن العيد محبة والمحبة فرح والفرح حياة لكننا نبحث عن الدهشة والمخالفة والصدمة في القول الشعري , تتكرر مثل هذه الخاتمة في نص ( فرحة العيد ) ( عليَّ أن أطردَ شبح الطائفية والبغضاء والفرقة من كل النفوس \ وأجعل الناس تعيش السلام والسعادة والفرح دائماً ) هذه الخاتمة وضعت انسيابية السرد في حرجٍ كبير حين ابتعدتْ عن الشعري لصالح التقريري المباشر
وتستمر شجرة التفاصيل اليومية تمدُّ أغصانها في فضاء هذا الكتاب فتأخذنا في لقطات سريعة , نتجول في البصرة , بصرة التاريخ والحاضر : ( الميناء- شط العرب- الأنهار اللا منتهية- القطارات- الخشّابة- الشعر- النثر- الفلسفة- المعتزلة- الحسن البصري- أخوان الصفا- الأحلام والخراب ) ثم تصل إلى بغداد ودجلة وحاناته الممتدة مع شارع أبي نؤاس وميسان والمَجر وتعودُ بنا إلى مقهى الأدباء في العشّار وتخوتهِ وأرجيلاتهِ وحكاياته التي تشبثتْ بعمق في تضاريس الذاكرة
لم ينحدر عبد السادة البصري من عائلة برجوازية ليحظى بحياةٍ مترفةٍ خالية من الانكسارات والهزائم كما ذكرتُ في مطلع هذه الكتابة كي يبتعد عن قاع المدينة وشخوصها المهمشين المظلومين , فهو ابن عاملٍ يساري بالفطرة وأم بسيطة تحمل ما تحمل من حكمة القرويات بالفطرة أيضاً , لذا نراه يكتبُ دائماً عن ( الحاملين همومهم دون أن يسأل عنهم أحد , الشغيلة , عمال مكابس التمور والميناء , الطواشات , المشردين , الراحلين بلا حقائبَ للأمنيات , الأطفال الذين يبيعون علب المناديل في تقاطعات الطرق أو الذين ينظفون زجاج السيارات الفارهة بأجورٍ بخسةٍ وظروفٍ تخدشُ طفولتهم دائماً , المواطنين بلا وطن ) مصرّاً على أن يكون الناطق الرسمي بأسمائهم بصوتٍ عالٍ وعدم السكوت عن مظلوميتهم , مستفيداً من وصايا أبيه ( وأنا أخطو أولى خطواتي \ في الكتابةِ .. \ رسمتُ على حائطِ بيتنا \ نهراً وشجرتين وعصفوراً \ حاسبني أبي بشدّةٍ قائلاً : \ حينما تريد الكتابة والرسم \ فابدأ على الورق \ احفرها بإزميل المحبة \ لأن المطر يغسلُ الحيطان \ فيضيعُ جهدكَ \ منذ تلك اللحظة \ وأنا لا أكتب إلّا بحبر المحبة ) . قد يأخذنا هذا النصُّ إلى سؤال : لماذا رسمَ نهراً وشجرتين وعصفوراً ( نهراً واحداً .. عصفوراً واحداً لكن شجرتين اثنتين ) ؟ . والإجابة هي أنه لمْ يردْ لهذا العصفور أن يبقى سجيناً في قلبِ شجرةٍ وحيدة , منحه حريةً أكثر كي يحلقُ في فضائين , والكتابة أو الرسم بإزميل أكثر ثباتاً سيما إذا كان إزميلُ محبة
في نصٍّ آخرَ ( كل ليلة ) تتجلى وصايا الأم وحكمتها الفطرية ( لا تترك ظهركَ عارياً \ ستصاب بالبرد \ فتمرض ! \ فألتفّ بلحافي وأغطّ بنومٍ عميق \ لكني حين كبرتُ \ عرفتُ سرَّ كلامها .. \ لم تقصد الهواء البارد \ بل طعنات الآخرين ) , هذا النصّ هو لقطة يومية أخرى تمنيتُ لو ختمه بهذه الخاتمة دون الاستغراق بالمقطع الأخير ( يا أمي الأرض مليئة بالأفاعي ..\ والعقارب تدخل حتى أفكارنا \ ولا نمتلك غير الطيبة , والتسامح علاجاً \ لأنفسنا ! ) فهو كما نسميه حصيلةُ حاصل
يعتبر عبد السادة البصري من الشعراء المأخوذين باقتناص اللحظات ليس في كتابه هذا فحسب بل في كل كتبه التي نشرت له من قبل فهو شاعر القصيدة اليومية . ومن يقترب من شخصيته كثيراً يجده مكتظّاً باليوميات لانغماره في تفاصيل الحياة ولا يشبه العابرين على حافاتها بهدوء أو المنزوين في غرفها المغلقة