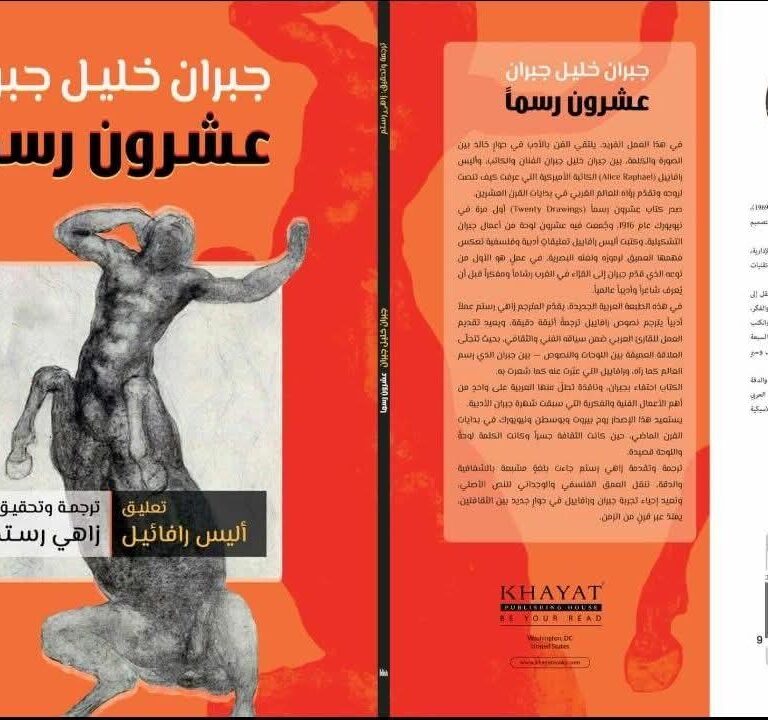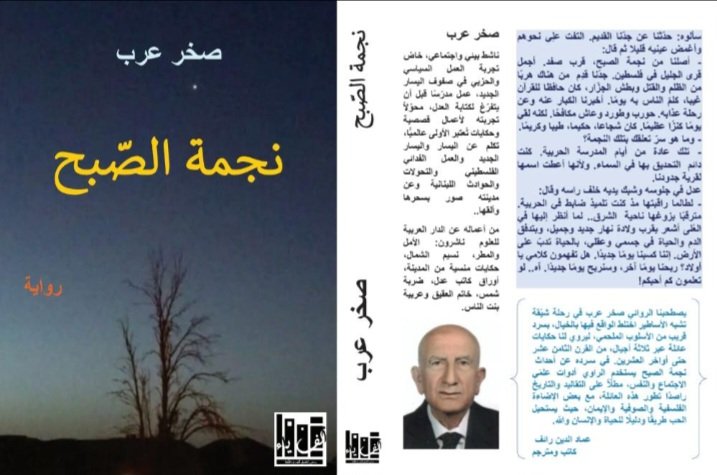متابعة: عبد الله الفرياضي
أصدرت المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، المملوكة للناشر الأردني ماهر الكيالي، أحدث أعمال الفيلسوف والروائي إبراهيم الكوني، الموسوم “ذاكرة العدم: الشهادة في حق الإنسان الهِجري”. حيث واصل الكوني، بلغة تجمع بين البلاغة والعمق الرمزي، استكمال معالم مشروعه الفلسفي القائم على التصدي النقدي لخطايا “الإنسان الحضري”، ذلك الكائن الذي أنتج الأزمة الأنطولوجية التي ترزح تحت وطأتها الحضارة المعاصرة. وللخلاص من هذه الأزمة نحت الكوني مفهوم “الإنسان الهجري”، مقدما تجربته الروحية بوصفها التجربة الوحيدة القمينة بتمكين الإنسان المعاصر من استعادة توازنه الأنطولوجي.
صحيفة الأعمال
تخبرنا النصوص المقدسة، بما فيها أساطير الأولين، بأن كل فرد لا محالة سيجد أمامه يوم الحساب صحيفة أعماله. لكن ماذا لو قررت المشيئة العلوية أن تنشر للإنسان صحيفة أعماله، لا من حيث هو فرد، بل من حيث هو نوع ضمن جنس الحيوان؟ هذا هو السؤال الذي سيقفز رأسا إلى ذهن من يفرغ من قراءة كتاب “ذاكرة العدم”، ذلك لأن هذا الكتاب يبدو وكأنه صحيفة للوجود الإنساني في عموميته، وذلك بالنظر إلى ما تصدّى له من تأريخ فلسفي لمسار الوجود الإنساني منذ نقاء البداءة إلى خطيئة الحضارة، ذلك المسار الذي يبدو أنه لا يسير نحو “القيامة” على نحو أفقي مستقيم، ولكن على نحو دائري مكرور، يكاد فيه الإنسان لا يفعل شيئًا غير إعادة إنتاج الخطايا الموروثة عن الأسلاف.. آدم، وقابيل.
سبيل الانعتاق
في هذا الكتاب، الممتد على 220 صفحة، توفق الكوني في الاشتغال على استثمار الثنائيات الضدية المؤطِّرة للوجود الإنساني منذ الصرخة الأولى إلى الشهقة الأخيرة، لا سيما ذلك التقابل الذكي بين المفهومين الناظمين للمتن في مجموعه: الاستقرار/الترحال، منظورًا إلى هذا التقابل كآلية لتشخيص أزمة الوجود الإنساني واجتراح سبيل الخلاص منها في الآن ذاته. ليبرز أن الخلاص لا يُنال بالارتماء في حضن الاستقرار ولا بالانقياد لأوهام الحضارة وقوانينها المقيِّدة، بل بالتحرر من أوصاب التوطين وأغلال التملّك، واعتناق شريعة الهجرة بما هي مقام روحي ووجودي يعصم الكائن من أسر الزمان وسجن المكان. فالهجرة، حسب منطوق الكتاب، ليست مجرّد ترحال في الأرض، وإنما هي وقفة أنطولوجية يستعيد فيها الإنسان فطرته البريئة الأولى، ويتطهّر من رجس المدن وفساد العمران، ليعود إلى الصفاء الأول، حيث الطبيعة معبدٌ، والعدم فردوسٌ مفقود. ومن ثم يغدو الخلاص فعل اغترابٍ واعٍ عن زيف الواقع، وارتقاءً إلى ذروة الحرية، حيث يتجذّر الكائن في الفراغ، لا ليذوي، بل ليشعّ بالمعنى، وليقف في وجه الوجود بضمير يقظ وفعل حرّ.
ترياق الأسطورة
يخبرنا الكوني في “ذاكرة العدم” أن من مثالب تجربة الاستقرار أنها حكمت على الإنسان بالانتقال من المجتمع الرعوي، البارّ بالطبيعة والمنصت لندائها بخشوع، بما هي طينه الأولى وأمه التي أنجبته، إلى المجتمع الزراعي الذي أرسى فيه علاقة آثمة مع تلك الأم، حين اغتصبها بالتقنية. فكان أن غدا الإنسان قنًّا وطاغوتًا في آن واحد، وانمحى في غمرة ذلك عن وعيه سره اللاهوتي الأصيل، ليُطوَّق بأسمال الإيديولوجيا. لذلك قرر أن لا سبيل لهذا الكائن العاقّ لانتشال نفسه من حضيضه الآسن، سوى أن يتلمّس أطياف هويته الهجرية الأولى في تجاويف الأساطير الخالدة، عبر استنطاق ذاكرته المصابة بلوثة النسيان، حتى يتهيأ له من جديد أن يعتنق الميثولوجيا دينًا.
غير أن طول المسافة الفاصلة بين نقاء البداءة وسقطة الحضارة يجعل استيعابه لشتات أساطير الأولين، وبالتالي استعادة هويته الأصيلة، أمرًا دونه خرط القتاد. وهو الأمر الذي يجعل من إيجاد وسيط قادر على تجاوز البياضات التي خلفها النسيان أمرًا محتوما.
وساطة اللغة
يخبرنا “هايدغر” أن اللغة هي المسكن الأصيل للكينونة، والمقام الذي تأوي إليه لتمارس لعبة الانكشاف والانحجاب. وضمن هذا السياق أكد الكوني في كتابه الجديد أن الكينونة لا تُشرق إلا إذا عبرت إلى اللغة. فاللغة هي الباب الذي يفتح على سرّ الوجود، وهي الستر الذي يحفظه، وهي الشرط الذي يتيح للمستور أن يُبدي وجهه.
ولما كانت المعاجم ليست سوى مقابر تراكم في بطونها رماد الأمم، واحتشدت بين سطورها أشباح العصور المتعاقبة، كما قال نيتشه، فإن الكوني قد توفق في انتهاج مقاربة دياكرونية وأنثروبولوجية – لسانية عابرة للغات لاستنطاق الحقيقة من بطون تلك القواميس، وذلك لعلمه أن معاجم لغات العالم أجمع ليست في واقع الأمر إلا “طِرسًا” لسانيا للغة واحدة، هي الأمازيغية: لغة اللاهوت والتكوين، التي بدونها لن يستطيع الإنسان فكّ شيفرة كينونته الحقيقية.
إنجيل الإنسان الهجري
الواضح أن المطلع على كتاب “ذاكرة العدم”، سيكتشف أن الكتاب لا يقدم نفسه كمجرّد كتاب يُقرأ، بل كصحيفة كونية تُستَقرَأ؛ صحيفة تضع الوجود الإنساني برمته في ميزان السؤال. فهو لا يكتفي بتشخيص خطايا الحضارة، ولا بالتنقيب في أطلال الذاكرة المثخنة بالنسيان، بل يفتح للإنسان أفقًا رحبًا ليتأمل ذاته بوصفه كائنًا آثمًا، ضلّ عن بداءته النقية حين استسلم لوهم الاستقرار وفتنة التملّك وطاغوت السلطة. وبذلك يكون إبراهيم الكوني قد رسم في هذا السِّفْر الأسطوري معالم درب خلاص يتوسّل الهجرة شريعةً، والأسطورة ترياقًا، واللغة وسيطًا بين الكينونة وسرّها، ليذكّرنا أن الإنسان لا يفتأ يعود إلى خطيئته الأولى ما لم يستعد ذاكرة النسيان ويستأنف البدء من جديد. ومن ثم يغدو الكتاب دعوةً إلى ارتقاء الوجود في مدارج العبور من أسر الزمان والمكان إلى فسحة المطلق، حيث الهجرة مقام خلاص، والعدم ذاكرة مكنونة، والأسطورة دين جديد للروح التائبة.