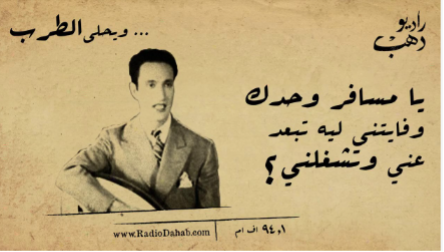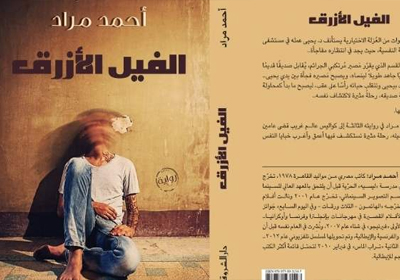الدكتور سعيد عيسى
أغنية “الأطلال” ليست مجرّد عملٍ طربيٍّ خالد لأم كلثوم، بل نصٌّ ثقافيٌّ عميقٌ يمكن قراءته كمرآةٍ أنثروبولوجيّةٍ للوجدان العربيّ في لحظةٍ مفصليّةٍ من تاريخه، عند التقاء الحلم بالانكسار، والرومانسية بالواقع. كتبها الشّاعر الطبيب إبراهيم ناجي، ولحّنها رياض السّنباطي، وقدّمتها أمّ كلثوم عام 1966، في زمنٍ كانت فيه الأمّة العربية تعيش ذروة الحلم القوميّ الناصريّ، قبل أن تهوي إلى جرح الهزيمة. في تلك اللّحظة التي سبقت الانكسار، وُلِدَت الأغنية كأنّها نشيدٌ جماعيٌّ للحبّ والحنين والفقد، صرخةٌ جماليّةٌ في وجه واقعٍ يوشك أن يبدّد المعنى.
الطَّلل في التّراث العربيّ ليس مجرّد بقايا حجارةٍ أو ذكرى، بل رمزٌ مركزيٌّ في الوعي الجمعيّ. فمنذ المعلّقات السبع، كان الشّاعر يقف على الأطلال ليستعيد الحبيبة والقبيلة والذّات، وليعلن أنّ الذّاكرة أقوى من الفناء. حين عادت أم كلثوم إلى هذا الرّمز في منتصف القرن العشرين، كانت تُعيد تفعيله داخل مدينةٍ حديثة، القاهرة بدل الصّحراء، الميكروفون بدل القصيدة، والجمهور الجماعيّ بدل الشاعر الفرد. تحوّل الوقوف على الأطلال من طقسٍ فرديٍّ إلى طقسٍ جماعيٍّ، ومن حنينٍ شخصيٍّ إلى بكاءٍ على أطلال الحلم العربيّ نفسه.
في كلمات “الأطلال”، يتداخل الحبّ بالفلسفة، والعاطفة بالتّحرّر. حين تغنّي أم كلثوم “أعطني حرّيتي أطلق يديّا، إنّني أعطيت ما استبقيت شيّا”، فهي لا تتحدّث عن امرأةٍ محبوبةٍ فقط، بل عن ذاتٍ تبحث عن خلاصها من القيود الاجتماعيّة والسّياسيّة والرّمزيّة التي تحاصرها. الحبّ في الأغنية يصبح استعارةً للحرّيّة، والرّغبة في الانعتاق العاطفيّ تتحوّل إلى توقٍ للتحرّر الوجوديّ. بذلك، تصبح الأغنية طقسًا رمزيًّا لمجتمعٍ يعيش بين التّقاليد الصّارمة وأحلام التّحديث، بين الحنين إلى الماضي والرّغبة في تجاوزه.
على المسرح، كانت حفلات أمّ كلثوم أقرب إلى الطّقوس الجماعيّة. الجمهور لا يستمع فحسب، بل يدخل في حالة اندماجٍ وجدانيٍّ معها. تتردّد الجمل اللحنيّة بين صوتها وصوت الحاضرين، كما لو أنّ الأمّة بأكملها تشارك في غناء الحنين ذاته. هذا الاندماج هو ما يسميه علماء الأنثروبولوجيا “الاندماج الجمعيّ” – اللّحظة التي يذوب فيها الفرد داخل الجماعة عبر الطّقس. صوت أمّ كلثوم كان أداة هذا الاندماج، والسّنباطي هو المعماريّ الذي بنى له هيكلًا موسيقيًّا قائمًا على التدرّج، يبدأ بالهدوء المتأمّل ثم يتصاعد حتى يبلغ ذروة الانفعال، قبل أن يعود إلى التّسليم. اللّحن هنا ليس زخرفًا بل بنيةً دراميّةً تُعيد إنتاج دورة الوجدان العربيّ: من الشّكوى إلى البكاء، من الغضب إلى الصّفاء.
ولأنّ الفنّ في ثقافتنا مرتبطٌ دومًا بالأمومة والاحتضان، تجسّد أمّ كلثوم في “الأطلال” صورة الأمّ الكبرى – تلك التي تُبكي الجميع وتغفر للجميع وتضمّهم في صوتها. لم تكن تغنّي للحبيب وحده، بل للأمّة، للإنسان الذي فقد وجهه في مرايا الحداثة السّريعة. صوتها يحمل مزيجًا نادرًا من السّلطة والعزاء، من القوّة والدّمع. في لحظة الغناء، كانت تبدو كأنها تقيم طقسًا مقدّسًا، تعيد فيه للأمّة توازنها المفقود عبر التّطهير الوجدانيّ.
الأغنية تمثّل أيضًا مفارقة الحداثة العربيّة نفسها. فهي تنتمي إلى الشّعر الكلاسيكيّ في لغتها وصورها، لكنها تُقدَّم بأدوات المدينة الحديثة، فتخلق تصالحًا هشًّا بين الماضي والمستقبل. هذا التّهجين بين التّراث والحداثة هو ما يمنح “الأطلال” خلودها؛ إنها تذكّرنا بما كنّا عليه، لكنها تُغنّى بأصواتٍ من حاضرٍ لا يشبهه. في كلماتها، يستعاد التّراث، وفي موسيقاها تُعبَّر الحداثة عن نفسها.
من هذا المنظور، يمكن القول إنّ “الأطلال” هي وثيقةٌ أنثروبولوجيةٌ عن الوجدان العربيّ في القرن العشرين. فهي لا تحكي قصّة حبٍّ بقدر ما تكشف عن البنية العاطفيّة لمجتمعٍ يعيش على تخوم الفقد، فقد المعنى، فقد الجماعة، فقد الحلم. لقد صارت الأغنية مع مرور الزّمن مرثيةً مزدوجةً – للحبيب الغائب وللوطن المفقود، للذّات وللأمة.
حين نقف اليوم أمام “الأطلال”، لا نستمع إلى أغنية حبٍّ فحسب، بل إلى مرثيّة حضارةٍ تتذكّر نفسها عبر الغناء. الطّلل الذي غنّت له أمّ كلثوم لم يكن بيتًا من حجرٍ انهار، بل زمنًا كاملًا مضى. وربما كان هذا هو سرّ خلود الأغنية، فهي تضع المستمع في مواجهة أنقاضه الشّخصيّة والجماعيّة، وتمنحه في الوقت نفسه عزاءً نادرًا – عزاء الصّوت الذي يُعيد ترتيب الألم في شكل جمالٍ.
“الأطلال” ليست فقط تحفةً موسيقيّةً، بل طقسٌ جماعيٌّ لاستعادة الذات. إنّها الأغنية التي حوّلت الحنين إلى طاقة بقاءٍ، والحبّ إلى استعارةٍ للهويّة، والصّوت إلى ملاذٍ روحيٍّ لأمةٍ تبحث، منذ قرونٍ، عن باب الخروج من أنقاضها.