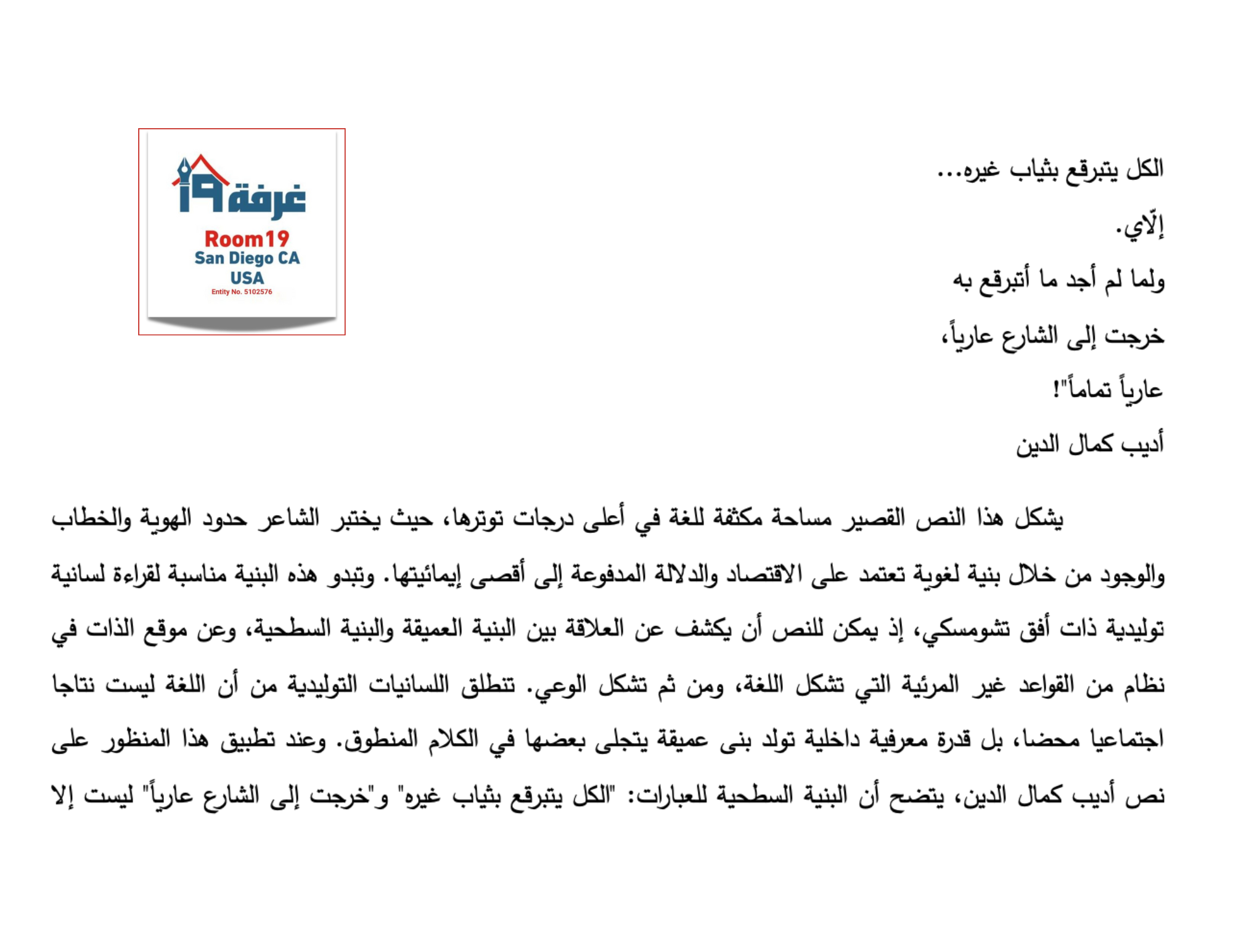
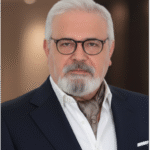
أ.د. إسماعيل نوري الربيعي
الكل يتبرقع بثياب غيره…
إلّاي.
ولما لم أجد ما أتبرقع به
خرجت إلى الشارع عارياً،
عارياً تماماً!”
أديب كمال الد
يشكل هذا النص القصير مساحة مكثفة للغة في أعلى درجات توترها، حيث يختبر الشاعر حدود الهوية والخطاب والوجود من خلال بنية لغوية تعتمد على الاقتصاد والدلالة المدفوعة إلى أقصى إيمائيتها. وتبدو هذه البنية مناسبة لقراءة لسانية توليدية ذات أفق تشومسكي، إذ يمكن للنص أن يكشف عن العلاقة بين البنية العميقة والبنية السطحية، وعن موقع الذات في نظام من القواعد غير المرئية التي تشكل اللغة، ومن ثم تشكل الوعي. تنطلق اللسانيات التوليدية من أن اللغة ليست نتاجا اجتماعيا محضا، بل قدرة معرفية داخلية تولد بنى عميقة يتجلى بعضها في الكلام المنطوق. وعند تطبيق هذا المنظور على نص أديب كمال الدين، يتضح أن البنية السطحية للعبارات: “الكل يتبرقع بثياب غيره” و”خرجت إلى الشارع عارياً” ليست إلا تمظهرات لعمليات ذهنية أعمق تتعلق بالبحث عن هوية لغوية خاصة. فالجملة الأولى تحمل بنية عميقة تنطوي على فرضية ضمنية تقول إن المجتمع ينتج خطابا موحدا، صيغته في المستوى السطحي هي استعارة “يتبرقع بثياب غيره”. هذه الاستعارة ليست مجرد تصوير اجتماعي، بل نظام لغوي يشي بأن الفاعل لا يظهر بصفته الذاتية، بل بصفته مشتقة من الآخر. هنا يعمل الشاعر عبر آلية تشومسكية أساسية: إسقاط القواعد الكونية على نص شعري، إذ تتكشف البنية العميقة التي تعني أن الهوية اللغوية ليست أصلية بل موروثة أو مقلدة. وعندما يعلن المتكلم “إلّاي” فإن هذه الكلمة القصيرة تكسر القاعدة. فإذا كان الجميع يتماهى مع خطاب خارجي، فإن المتكلم يجد نفسه منزوعا من هذه القدرة، عاجزا عن توليد صيغة لغوية تمنحه قناعا. في القراءة التوليدية، هذا يعني أن المتكلم يعاني من خلل في مستوى القواعد العميقة، أو بالأحرى يعمل على تعطيلها طوعا كي يخرج من النظام التواصلي. إن فعل الخروج إلى الشارع عاريا يصبح إذاً فعلا لغويا يعبر عن رفض البنية السطحية التي يفرضها المجتمع، والعودة إلى بنية عميقة أولى هي العري.
التحويلات التوليدية من القناع إلى الانكشاف
ترتكز النظرية التوليدية على مفهوم التحويلات التي تنقل الجملة من بنيتها العميقة إلى بنيتها السطحية. ويكشف النص عن سلسلة تحويلات دلالية يمكن تحليلها في ضوء هذا الإطار. في المستوى الأول، لدينا بنية عميقة مفادها أن الإنسان بحاجة إلى تمثيل لغوي يعبر عن وجوده. لكن هذا التمثيل في المجتمع المعاصر متأت من الآخر لا من الذات. وفي المستوى الثاني، تفشل عملية التحويل لدى المتكلم نفسه. فهو لا يمتلك المادة اللغوية اللازمة لصناعة صورة اجتماعية. ولذلك تقول الجملة: “ولما لم أجد ما أتبرقع به”. هذا الفشل ليس فشلا اجتماعيا فقط، بل هو تعطيل في آلية توليد الجملة نفسها، لأن التبرقع هنا هو عملية توليد خطاب، لا عملية ستر جسدي. وتأتي المرحلة الأخيرة من التحويل حين ينقلب هذا النقص إلى فعل وجودي جذري: “خرجت إلى الشارع عارياً”. هنا يقوم الشاعر بما يشبه التحويل العكسي، يعود من البنية السطحية الاجتماعية إلى البنية الأصلية التي تسبق اللسان، البنية التي يرى فيها تشومسكي إمكانا معرفيا بدئيا. فالعري في هذا المستوى هو عري لغوي، عودة إلى ما قبل القواعد، إلى المادة الأولية للذات. وفق تشومسكي، الجملة ليست مجرد كلمات بل تمثيل لبنى منطقية عميقة تتصل بالذهن. وفي ضوء هذا الفهم، فإن تكرار كلمة “عارياً” مرتين يحمل قيمة نحوية ودلالية تؤكد أن المعنى المطلوب ليس الوصف الجسدي بل المعنى الذهني. التكرار هنا يخلق ما يمكن تسميته في التوليدية “تأكيد البنية العميقة”، أي أن الجملة السطحية ليست كافية للتعبير عن الحالة العقلية، فيتم تكرارها لتكشف عن عمق أكبر لا يظهر إلا عبر إعادة القول. إن هذا التكرار لا يشكل زخرفة بل هو آلية لغوية تنقلنا من المعنى الاجتماعي للعري، وهو النقص، إلى معناه الوجودي، وهو الامتلاء بالذات. ولذلك يبدو المتكلم أقل خضوعا للقواعد الاجتماعية، وأكثر قربا من مشروع تشومسكي الذي يميز بين القدرة Performance والاستعداد Competence. فإذا كانت القدرة هي ما يفرضه المجتمع من طرائق للتعبير، فإن الاستعداد هو طاقة داخلية قادرة على إنتاج صيغ لغوية حرة. والعري هنا ليس إلا إعلانا عن الاستعداد الأصلي الذي يسبق اللغة المفروضة.
البنية العميقة للقناع في ضوء الاستعارة
تعد الاستعارة أحد المظاهر التي يمكن قراءتها في ضوء اللسانيات التوليدية باعتبارها شكلا من أشكال التحويل. في الاستعارة الأساسية للنص، “الكل يتبرقع بثياب غيره”، نجد أن التبرقع ليس زينة بل عملية لغوية فيها يختفي الفاعل الحقيقي خلف فاعل آخر. وهنا يمكن تطبيق مبدأ تشومسكي القائل بأن البنية العميقة لا تتطابق دائما مع البنية السطحية. فالبنية العميقة لهذه الاستعارة هي: “الكل يتكلم بكلام غيره”، أو “الكل يشتق هويته من خطاب خارجي”. وبالتالي يصبح التبرقع عملية لغوية بامتياز، تتعلق بتوليد هوية لغوية شكلية. أما المتكلم فلا يجد خطابا خارجيا يلبسه. هنا يتفرع السؤال: هل عجزه عن التبرقع يدل على نقص في القدرة اللغوية؟ أم أنه تعال عن هذا النظام؟ في ضوء التشومسكية، يبدو أن الشاعر يمارس نوعا من الرفض الواعي لما يسميه تشومسكي “القواعد المعيارية” التي تفرضها الثقافة، لصالح العودة إلى “القواعد الكونية” التي تتيح للذات إنتاج خطاب أصيل، حتى وإن كان عاريا.
الشارع بوصفه بنية سطحية للفضاء اللغوي
يحضر الشارع في النص باعتباره مكانا لا مكان، فضاء للظهور، لكنه أيضا فضاء للامتحان. فهو في القراءة التوليدية بنية سطحية لمستوى أعمق هو “العالم”، حيث تختبر الذات خطابها أمام الآخر. ولذلك فإن الخروج عاريا إلى الشارع يعني الخروج من بنية عمق فردية إلى بنية سطح عامة، دون محاولة إخفاء هذه البنية العميقة وراء القناع. ويكشف هذا الفعل عن مفارقة مهمة: فالعري الذي يظهر به المتكلم في السطح هو نتاج البنية العميقة الأصيلة التي لم تستطع الثقافة أن تحولها. إن الإطار التشومسكي يجعلنا نقرأ الشارع بوصفه مرحلة من مراحل إنتاج الكلام. فاللغة تنتقل من ذهن المتكلم إلى المجتمع. وهنا، ينتقل المتكلم من عريه الداخلي إلى عريه الخارجي. يركز تشومسكي في كتاباته السياسية على أن اللغة قد تتحول إلى أداة هيمنة. وبما أن الشعر هو أحد أشكال المقاومة اللغوية، فإن نص أديب كمال الدين يقدم نموذجا لهذه المقاومة من خلال رفضه للتبرقع. فالجميع يتبرقع بثياب الآخرين، أي يخضع لمنظومة خطابية جاهزة. أما المتكلم فيصنع تمرده عبر الانسحاب من هذه المنظومة. إن فعل عدم العثور على ثياب لغوية هو أيضا رفض لارتداء ثياب السلطة الرمزية. ولعل التناقض بين الفاعلين “الكل” و”إلّاي” يؤسس لبنية صراعية بين لغة الجماعة ولغة الفرد، بين الكلام الموروث والكلام المبتكر. وعلى الرغم من أن الفرد يخرج عاريا، فإن هذا العري ليس ضعفاً، بل هو إعلان عن استقلال لغوي ومعرفي.
التوليد الشعري والاقتصاد اللغوي
يبرز في النص ما يمكن وصفه بالاقتصاد التوليدي، حيث يعتمد الشاعر على كلمات قليلة لتوليد شبكة من المعاني. وهذا قريب من مبدأ تشومسكي الذي يؤكد أن البنى العميقة قد تكون بسيطة جدا، ولكنها من خلال التحويلات تنتج عددا غير محدود من الجمل. بناء على ذلك، تصبح الجملة القصيرة “إلّاي” مثالا على البنية العميقة المختزلة التي تفصل المتكلم عن الجميع. فهي جملة ذات كلمة واحدة لكنها تحمل بنية توليدية كاملة تتضمن: أنا موجود، أنا مختلف، أنا خارج النظام اللغوي العام. ومن هذه النقطة تتولد الجملة اللاحقة: “ولما لم أجد ما أتبرقع به”. ثم تليها الجملة الختامية التي تشكل تتويجا للتحويل: “خرجت إلى الشارع عارياً”. ترى النظرية التشومسكية أن العقل اللغوي يولد قواعد مشتركة بين البشر جميعا. لكن التباين يظهر في استعمال هذه القواعد في مستوى السطح. والشعر هنا يتدخل ليعيد كتابة هذه البنية العامة بطريقة فردية. ولذلك فإن الشاعر يعيد إنتاج اللغة من الصفر، وكأنه يعلن أن الكلام الذي يتداوله الناس ليس لغته، وأن عليه أن يبتكر لغته الخاصة، ولو كانت عارية من الزينة. إن النص كله إعادة ولادة لغوية، تبدأ بالرفض وتنتهي بالانكشاف. وهذا الانكشاف هو جوهر العملية التوليدية، إذ يكشف عن العلاقة بين الذات واللغة بوصفها علاقة داخلية لا مستعارة. إن قراءة نص أديب كمال الدين من منظور تشومسكي تكشف أن العري ليس موقفا اجتماعيا فحسب بل هو موقف لغوي عميق، يحطم القوالب الخطابية ليفتح المجال أمام بنية داخلية أصيلة. فالجميع يرتدي لغة غيره، بينما يختار المتكلم أن يظهر بلغته الأولى، اللغة التي تسبق التبرقع، اللغة التي تخرج من العمق إلى السطح دون وسيط. وهكذا يصبح النص تمثيلا شعريا لفكرة تشومسكية جوهرية: أن الحرية تبدأ من اللغة، وأن التحرر من قيود الكلام السائد هو أول أشكال العراء، وأعظمها.
تعريف موجز؛ الأستاذ الدكتور إسماعيل نوري الربيعي، أكاديمي متقاعد، وندسور أونتاريو، كندا




