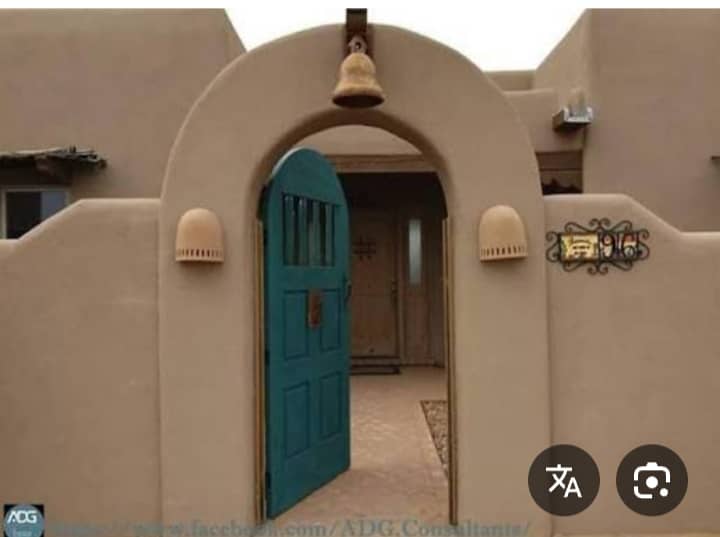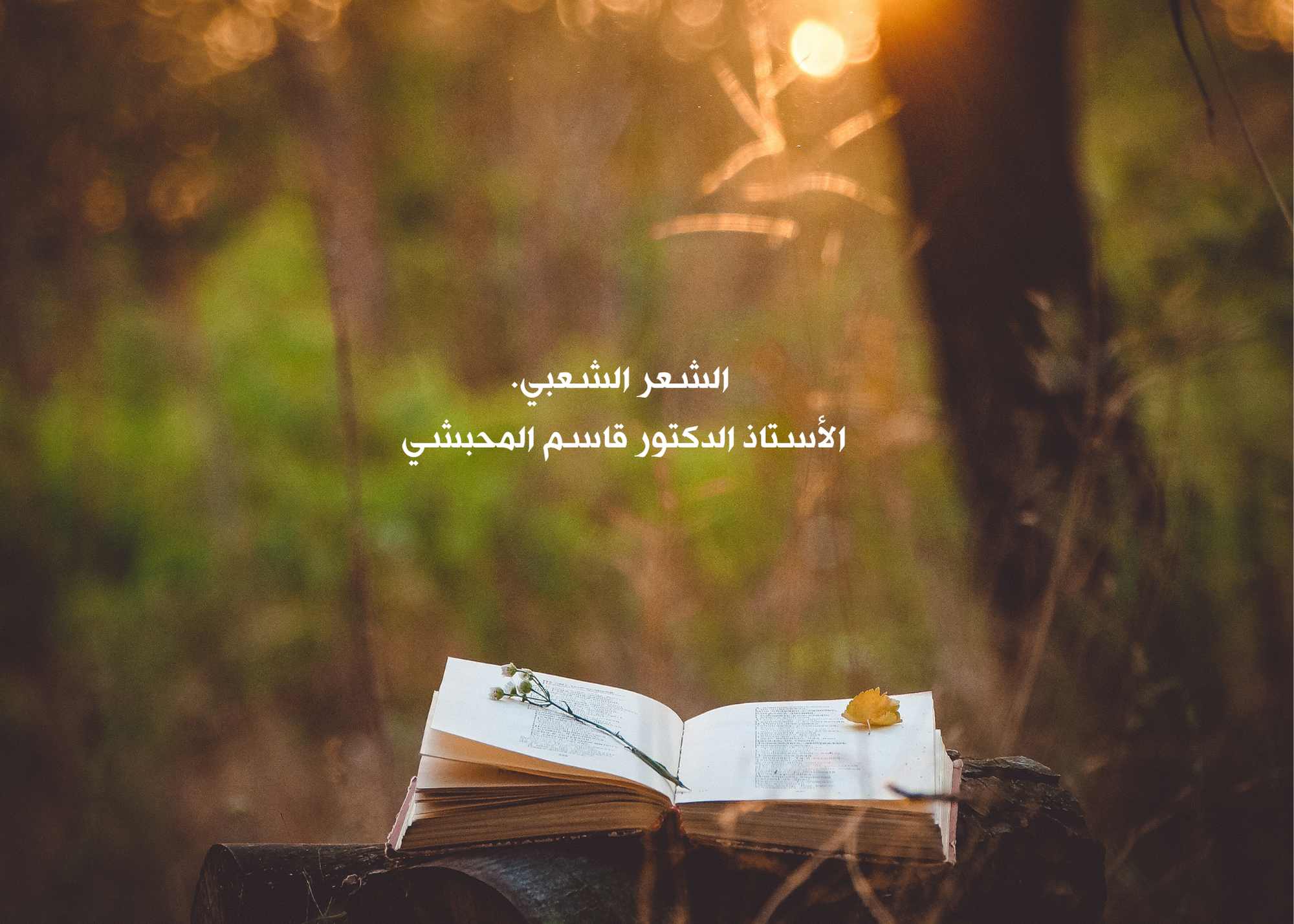

يعود اهتمام بالشعر الشعبي إلى مرحلة الطفولة المبكرة حيث كان الشعر هو الأفق الثقافي الشائع في مجتمعي المحلي واتذكر أنني كنت أدندن واحاول النسج على منوال الشعراء الشعبيين. وحينما تعرفت على الصديقي الباحث في الشعر الشعبي اليافعي دكتور فلاج مللر، استاذ الأدب الشعبي في جامعة ميشيغان ورافقته لمدة عام كامل زاد اهتمامي بنظرية الثقافة الشفاهية
والشعر الشعبي. وحتى البارحة كنت اعتقد إن المجتمع اليمني هو اكثر الشعوب العربية انشغالا بالشعر الشعبي فاذا بالدكتور خير الله سعيد يكشف عن حضور خصيب للشعر الشعبي في العراق في اكثر من ثلاثين نمط ونوع. كانت محاضرة ثرية فيما يشبه التغذية الراجعة بالنسبة لي. إذ جعلتني اتذكر ما سبق وفكرت به عن الشعر ووظيفته فالإنسان، بما هو كائن يحس ويشعر ويدرك وينفعل بالعالم، هو كائن شعري في جوهره، لأنه يمتلك تلك القدرة الفريدة على محاكاة الطبيعة وتمثلها وجدانياً عبر الإيقاع والرقص والرسم والموسيقى والكلمة. فالشعر ليس محاكاةً فنية فحسب كما رأى أرسطو، بل هو تجربة وجودية تتجاوز حدود اللغة إلى أعماق الكينونة. صحيح أن أرسطو ردّ الشعر إلى غريزتين طبيعيتين — المحاكاة واللذة — واعتبره تعبيراً عن ميلٍ فطريٍّ في الإنسان منذ الطفولة، إلا أن هذا التفسير العقلي لا يستوعب كل أبعاد الشعر بوصفه انفعالاً ميتافيزيقياً يتجاوز المحاكاة نحو الخلق والتجلّي فبعض النقاد حصره في الوزن والقافية، ومنهم من رآه ميتافيزيقا اللغة والوجود وانا اراه حالة وجد إبداعي للكائن الإنساني مرهف المشاعر فالشاعر، في لحظة التجلّي الشعري، لا يكون مجرد ناقل أو محاكٍ، بل كائن يبعث من رحم اللغة، فينيقاً يتجدد في كل قصيدة، و«نرجساً» يعانق ذاته في سيل الكلمات.
إن الشعر، بهذا المعنى، ليس جنساً أدبياً فحسب، بل حالة من الحضور الوجداني، حيث يتقاطع الحضور بالغياب، واللغة بالدهشة، والوعي باللاوعي. وإذا كانت أولى لغات الجسد هي الرقص، فإن أولى لغات الوجدان هي الشعر. فالشعر تمرينٌ روحيٌّ، ووسيلة لتحرير الداخل من فائض المشاعر والذكريات والأحلام. إنه صوت الكائن في لحظة تعرّيه أمام العالم، دعاءٌ للفراغ، حوارٌ مع الغياب، تجلٍّ للملل واليأس كما هو انبثاق للفرح والدهشة ففي القصيدة تتكاثف الأضداد: المقدّس والمدنّس، الجماعي والفردي، الشعبي والنخبوي، فالقصيدة ليست تمثيلاً لوجهٍ محدّد، بل قناعٌ جميل يخفي نقص الوجود، كما لو كانت دليلاً على تلك «العظمة غير الضرورية» التي تميز كل عمل إنساني. إن الشعر بوصفه ابداعاً إنسانيا لا يُختزل في الوزن والإيقاع أو في المحاكاة؛ فهذه أدواته الخارجية، أما جوهره فسرٌّ عصيٌّ يسكن في داخل الذات الشاعرة ويتقد لحظة هجوسها الخاطف التي يسميها البعض «الانزياح الإبداعي» أو «المخاض الشعري» هي التجربة الأصيلة التي لا تُكتسب بالتدريب ولا تُستحضر بالإرادة، بل تُباغت الشاعر من حيث لا يحتسب: في ساعات الفجر، أو على حافة النوم، أو أثناء السفر، أو في مواجهة الجمال. إنها لحظة انقداح الروح اشبه ببرقٍ داخليٍّ، إذا لم يُمسك بها الشاعر تلاشت كما تتلاشى مياه النهر التي لا تعود. ولهذا فإن الشاعر محكومٌ بـ«شيطانه»، بتلك اللحظة المتمردة التي تفرض نفسها عليه دون إذنٍ أو اختيار. وكما يرى برقاوي، فإن الشاعر يرسم باللغة أعماق اللاشعور، محولاً المكبوت إلى دلالات شعرية، ومتجاوزاً اللغة العادية نحو لغة من «الانزياح»؛ أي نحو علاقة جديدة بالأشياء لا وجود لها في الواقع لكنها بنت الواقع.
ففي كل تجربة شعرية، يتأسس الوعي الجمالي على فعل الخروج من المألوف، على إعادة خلق العالم من خلال اللغة، لتصير القصيدة ليست وصفاً للعالم بل عالماً آخر يولد من رحم الحياة واللغة والذاكرة. وبهذا المعنى يعد الشعر الشعبي تعبير حيّ عن الوجود الجماعي والفردي في آن واحد. هو لحظة يتجلّى فيها الإنسان البسيط والحسّاس، القادر على اختراق المألوف، وتحويل الأحداث اليومية إلى تجربة وجدانية، حيث تصبح اللغة وسيلة للحضور والتواصل الروحي، لا مجرد أداة نقل، كما عبّر عنها هايدغر في سياق الوجود. فالشاعر الشعبي لا يروي العالم فحسب، بل يعيشه ويخلقه من جديد، فيحوّل الواقع إلى فضاء شعوري متجدّد، تغذّيه الذاكرة الجمعية والخيال الشعبي والموروث الثقافي لكنه وسيلة الثقافة الشفاهية ونطولوجيا للروح الجماعية، يحرّر الإنسان من قيود الزمن اليومي ويجعله يرى العالم بعين الكينونة، بعين تتجاوز المألوف إلى ما هو أعمق، كما قال باشلار عن الخيال الشعري: ليس هروبًا من الواقع، بل تأسيسًا جديدًا له في فضاء اللغة والرمز والتجربة الحية وهنا تكمن أهمية الشعر الشعبي في بعده الثقافي إذ هو ليس ترفًا فنّيًا أو تزيينًا لغويًا، بل وظيفة وجودية وثقافية، تذكّر الإنسان بأصله الأول: حين كانت الكلمات تعني أكثر من مجرد أدوات، بل كانت معاني حياة. هو تمرين مستمر على استعادة الاندهاش، وعلى مقاومة الصمت الروحي، وعلى البحث عن المعنى في عالم متسارع، حيث تتضاءل قدرة الإنسان على الشعور والتأمل وفي زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يظل الشعر الشعبي كما اوضح الدكتور خير الله سعيد في محاصرته عن الشعر الشعبي العراقي البارحة في غرفة 19 الثقافية إذ اشار إلى أن الحاجة إلى الشعر الشعبي تزداد فهو آخر ما يذكّر الإنسان بأنه كائن يتجاوز المألوف نحو الممكن، والعادي نحو العجيب، واللغة نحو ما قبل اللغة. إنه صلاة جماعية وفردية في آن واحد، ومغامرة الروح في فضاء مفتوح من التساؤل والخلق، حيث يولد الإنسان من جديد في كل بيت شعري، كما يولد الفينيق من رماده، حاملاً وهج الأسئلة الأولى التي لم تفقد بعدُ براءتها ولا ألمها، وذاكرة أجداده الحية، وحلم مجتمعه المستمر
شهادة من غرفة ١٩ مع التقدير للأستاذة إخلاص فرنسيس