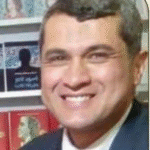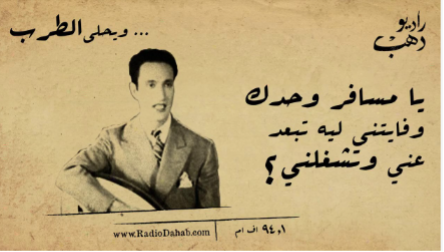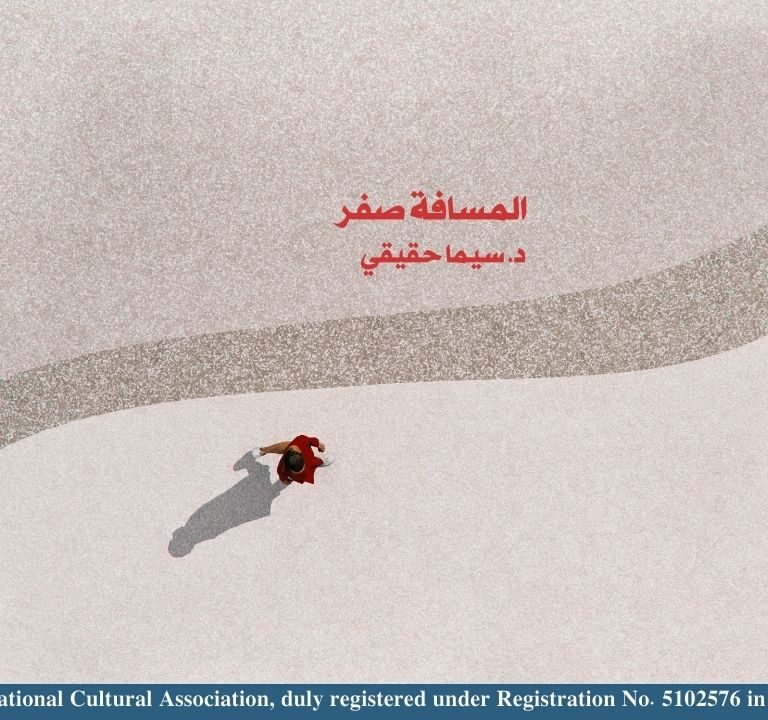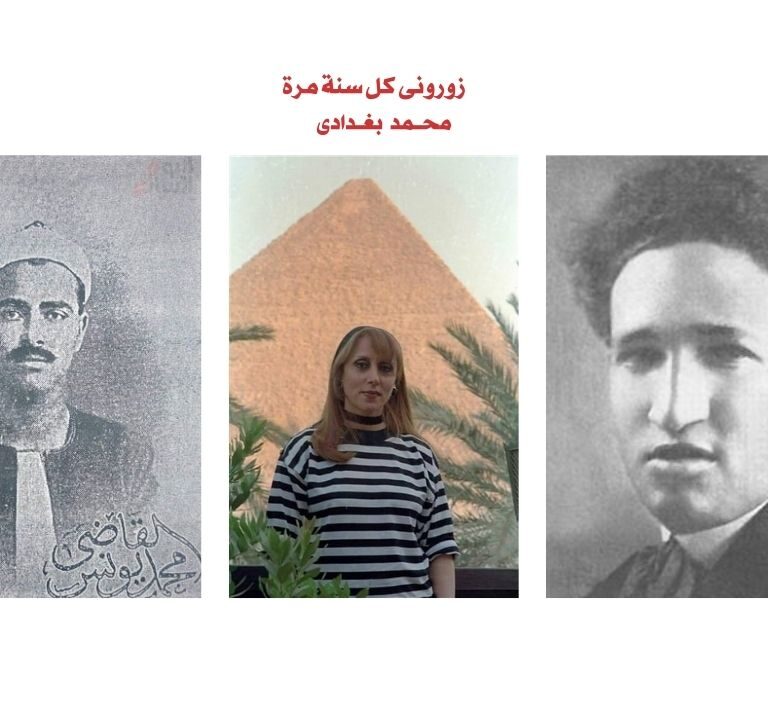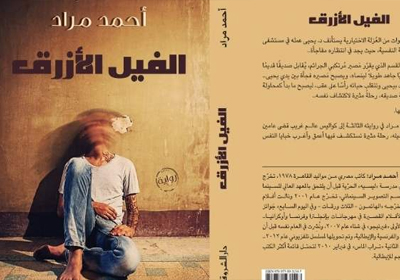
قراءة في تجربة الروائي المصري أحمد مراد بين الصورة والنص والسلطة الثقافية
تعودتُ السباحة ضدّ التيار، حتى وأنا على مشارف نهايات عمري غير المجدي وغير المجيد كناقدٍ وكاتبٍ ظلّ يراهن على جوهر الفن لا على صفقاته. أقول هذا وأنا أتابع المشهد الأدبي المصري الذي بات يموج بأسماءٍ كثيرة تُكتب وتُنسى بسرعة الضوء، غير أنّ بعض الأسماء تفرض حضورها لا بسطوة الإعلان، بل بقدرة الفنّ على أن يخلق أثرًا لا يُمحى. ومن هؤلاء أحمد مراد.
تختلف أو تتفق مع نوعية الروايات التي يكتبها أحمد مراد، لكنك لا تستطيع أن تنكر أنه ظاهرة أدبية متفردة، خرجت من قلب الواقع المصري لتعيد تعريف العلاقة بين الأدب والسينما، بين الصورة والكلمة، وبين الفن والسوق.
فمراد، كما قال أستاذي الكبير عبد الوهاب داود: “ليس كوهين يُعاد إنتاجه في المعامل الغربية، ولا نَكِرة سقطت صدفة على مائدة الكتابة، ولا أرزقي يتهم الباحثين عن المعلومة بأنهم همج.”
هو كاتب صاحب مشروع، ومبدع من طراز خاص تشهد له أعماله المتنوعة والمتماسكة فنيًا وبصريًا، كما تشهد له لغته المشحونة بالإيقاع والضوء والظل، التي لا تنفصل عن تكوينه الأصيل كفنان تشكيلي ومصور محترف.
من العدسة إلى الورق
درس أحمد مراد التصوير السينمائي في معهد السينما، وعمل مصورًا قبل أن يكتب روايته الأولى «فيرتيجو» عام 2007، التي كانت بمثابة إعلان ولادة كاتب يرى العالم بعدسته قبل أن يصوغه بالحروف.
في أعماله التالية، من «تراب الماس» إلى «الفيل الأزرق» و**«1919»** و**«لوكيميا»** و**«أرض الإله»**، تتجلى روح المصور والرسام بوضوح.
شخصياته ليست مجرد أسماء على الورق، بل كائنات تتحرك أمام الكاميرا الذهنية، في لقطات قريبة ولقطات عامة، في مونتاج سردي بارع يتقاطع فيه الضوء بالعتمة، والعقل بالغريزة، والتاريخ بالأسطورة.
الرواية كلوحة متحركة
تبدو روايات مراد وكأنها لوحات ضخمة تتحرك بالحبر والخيال.
ألوانه السردية كثيفة، وملامحه التعبيرية حادة، وأسلوبه في بناء المشهد يعتمد على اقتصاد الجملة وتوتر الإيقاع. لا غرابة في ذلك، فهو فنان تشكيلي بالأساس، يقرأ العالم من خلال الظلال والفراغات، ويؤمن بأن الجمال يمكن أن يُصنع من الفوضى.
وفي الوقت الذي يتهمه فيه البعض بالميل إلى “السينمائية الزائدة”، فإن هذه السينمائية نفسها هي ما منحت السرد المصري الحديث أفقًا جديدًا من الرؤية البصرية والتشويق المعرفي.
الواقعية المظلمة.. أم الإنسان في لحظته الحرجة؟
يرى كثير من النقاد أن مراد يمثل جيلًا جديدًا من الروائيين الذين جمعوا بين الوعي السردي والذكاء التجاري، لكنه في الوقت ذاته كاتب يبحث في أعماق النفس البشرية، عن تلك اللحظة التي يفقد فيها الإنسان توازنه الأخلاقي والنفسي، ليواجه ظله في المرآة.
في «الفيل الأزرق» مثلًا، لم يكن الجنون سوى استعارة للغوص في قاع الذات، وفي «تراب الماس» تحوّل القاتل إلى ضميرٍ جمعي يبحث عن العدالة المفقودة في مجتمع مشوه.
مراد بين الأدب والسياسة
جاء تعيين أحمد مراد في مجلس الشورى خطوة رمزية تحمل دلالاتٍ تتجاوز الشخص ذاته، فهي تعني اعتراف الدولة بمكانة الأدب في صياغة الوعي العام، واحتفاءً بجيلٍ من المبدعين الذين نجحوا في الوصول إلى الجمهور دون وسطاء.
لكن هذه الخطوة لم تمرّ بهدوء، فقد أثارت موجةً من الجدل داخل الأوساط الثقافية، بين من رأى فيها تتويجًا مستحقًا لمشروع كاتبٍ شقّ طريقه بالكفاءة والموهبة، وبين من اعتبرها ترضيةً أو محاولةً رسمية لاختراق المشهد الأدبي الحرّ.
في خضم هذا الجدل، ظهرت أصواتٌ معارضة تُعبّر عن قلقٍ مشروع أحيانًا، وغير مبرَّر أحيانًا أخرى؛ فبعض المثقفين يخشون من تسييس الثقافة وإخضاعها لسلطة الدولة، فيما يرى آخرون أنّ رفض تعيين كاتب بحجم أحمد مراد لا يقوم على أساسٍ موضوعي، بل على خلفيات أيديولوجية أو نزعات نُخبوية تنظر بعين الريبة إلى أيّ نجاحٍ جماهيري خارج دوائر الصالونات الأدبية المغلقة.
غير أنّ هذا الرفض — في جانبٍ منه — قد يُفَسَّر بوصفه أثرةً ثقافية أكثر منه موقفًا مبدئيًا، إذ يشعر بعض رموز الأدب الكبار بأنّ تجاهلهم في مثل هذه التعيينات إغفال لتاريخهم ومكانتهم، خاصةً حين لا يُختار أسماء بحجم إبراهيم عبد المجيد — عميد الروائيين المصريين في وقتنا هذا — أو غيره من الرموز التاريخية التي تغرّد خارج سرب وهوى الحكومة في كثير من المواقف.
وهنا يختلط الحق بالانفعال، والنقد بالخذلان، لأنّ المسألة في جوهرها ليست مفاضلة بين الأسماء بقدر ما هي تحوّل في رمزية الاختيار: بين واقع آني حاضر بكل قيمه، وتاريخ بكل ما كان يحمله من قيم وأحداث مفصلية فارقة.
ورغم ما بين الموقفين من اختلاف، فإنّ تعيين أحمد مراد يظلّ — في الجوهر — اختبارًا لعلاقة المثقف بالمؤسسة: هل يمكن للأديب أن يكون قريبًا من دوائر القرار دون أن يفقد استقلاله؟ وهل تستطيع الدولة أن تُنصت إلى صوت الفن لا أن تستخدمه؟
وجوده داخل المجلس، في هذا السياق، إضافة نوعية حقيقية، لأنه يفتح الباب أمام الحوار بين الثقافة وصناعة القرار، بين الخيال والواقع، بين ما يُكتب وما يُنفَّذ، ويعيد الاعتبار لدور المبدع بوصفه شاهدًا ومشاركًا في آنٍ واحد.
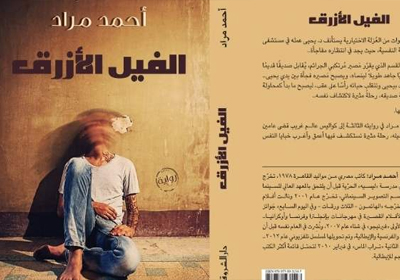

نبذة عن أعماله
فيرتيجو (2007)
رواية الجريمة الأولى في مسيرته، تدور حول مصور صحفي يكتشف مؤامرة كبرى في أحد الملاهي الليلية الراقية بالقاهرة. تحولت إلى مسلسل تلفزيوني عام 2012 من بطولة هند صبري.
تراب الماس (2010)
رواية تجمع بين التشويق والتحقيق الفلسفي في مفهوم العدالة والفساد. تحولت إلى فيلم سينمائي عام 2018 من إخراج مروان حامد وبطولة آسر ياسين ومنة شلبي.
الفيل الأزرق (2012)
عمله الأبرز، يجمع بين النفسية والماورائية في قالب بوليسي غامض. تحولت إلى فيلمين ناجحين من بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم. 1919 (2014)رواية تاريخية تعود إلى زمن الثورة المصرية ضد الاحتلال البريطاني، وتعيد بناء القاهرة من منظور سينمائي حيّ. تم الإعلان عن تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني قيد الإنتاج.
أرض الإله (2016)
رحلة تأمل في التاريخ الديني والفرعوني من خلال مغامرة بحث في جذور العقيدة القديمة، تجمع بين الأسطورة والبحث العلمي.
لوكيميا (2020)
رواية إنسانية تمزج المرض بالرمز، والموت بالحياة، وتكشف هشاشة الوجود في عالم ينهشه الطمع واللامبالاة.
مراد الفنان
قبل أن يكون كاتبًا، كان أحمد مراد مصورًا ومصمم جرافيك وأغلفة روايات حاصلًا على جوائز دولية.
تخرّج في مدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق سنة 1996، ثم في المعهد العالي للسينما عام 2001 بترتيب الأول على قسم التصوير، ونالت أفلام تخرّجه الهائمون، الثلاث ورقات، وفي اليوم السابع جوائز في مهرجانات بإنجلترا وفرنسا وأوكرانيا.
تكوينه البصري هذا انعكس بوضوح في أعماله الروائية التي تقرأ وكأنها سيناريوهات مكتوبة بالضوء لا بالحبر.
خلاصة القول
أحمد مراد ليس كاتبًا عابرًا، ولا نجمًا مؤقتًا في سماء الرواية المصرية.
هو فنان متعدد الوسائط، يجمع بين حس المصور ودقة السيناريست وجرأة الروائي، وبين وعي الفنان التشكيلي وإيقاع الموسيقي.
هو ابن جيله، يكتب بعيون مفتوحة على المستقبل، ويصوغ واقعه بلغة تليق بعصر الصورة والدهشة.
باختصار، تعيين أحمد مراد في مجلس الشورى مكسب للأدب والأدباء، واحتفاء بقدرة الإبداع المصري على تجديد نفسه في كل جيل.
ألف مبروك لأحمد مراد، وللثقافة المصرية التي أنجبته.
موقع أحمد مراد في خريطة الرواية المصرية الجديدة
في المشهد الروائي المصري الراهن، يقف أحمد مراد في نقطة تقاطع نادرة بين الأدب الشعبي الواسع الانتشار والأدب النخبوي العميق الدلالة. فهو يختلف عن هشام الخشن في النزوع الاجتماعي التقليدي، وعن محمد صادق في الرومانسية الوجدانية، وعن ريم بسيوني في اهتمامها بالتاريخ والهوية، لكنه يجمع من كلٍّ منهم خيطًا ليغزل نسيجًا خاصًا به.
هو كاتب السوق الواسع الذي لم يتخلَّ عن فنه، وصاحب الحس البصري الذي لم يضحِّ بالمعنى من أجل اللقطة.
لقد أعاد مراد إلى الرواية المصرية بريقها الجماهيري، دون أن يتنازل عن الحرفة، وأثبت أن الأدب يمكن أن يكون ممتعًا ومقروءًا ومتفكرًا في آنٍ واحد.
وهذا في ذاته درسٌ نادر لجيله ولمن سيأتون بعده: أن تكون مختلفًا لا يعني أن تكون ضدًّا، بل أن تكون على وعيٍ بما تراه من زاويةٍ أخرى.