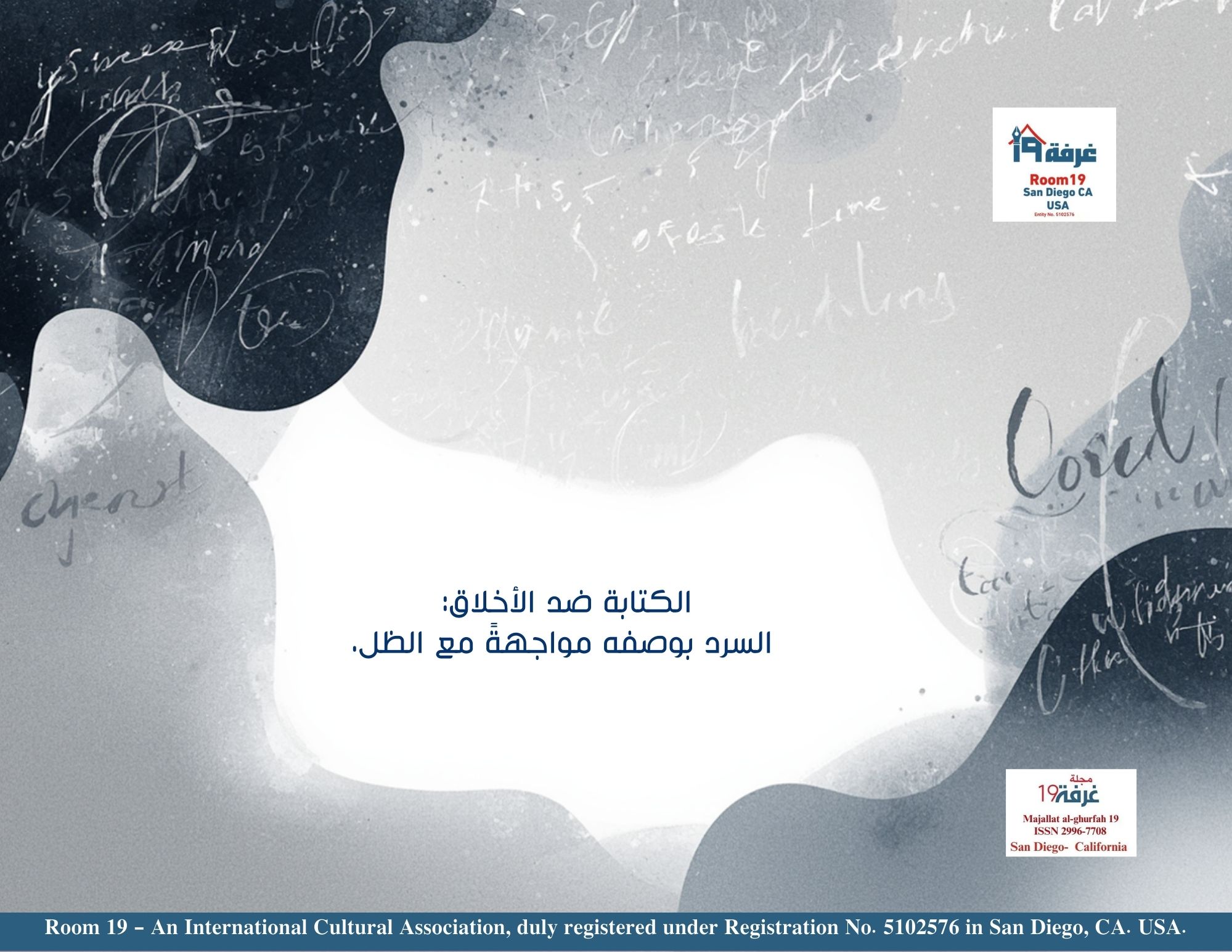

عادل النعمي (كاتب وناقد).
الخطأ الأكبر في الكتابة القصصية… هو الظن بأن الأدب يكتب عن الأخلاق!
عندما تكتب عن الأخلاق, فإن القصة تصبح موجهة، نحو غايات معينة، وتفقد الفرصة بأن تكون القصة هي الحياة نفسها، وأن تكون فيها الأصالة, أن يكون فيها العمق اللازم, الذي يجعلها تتفوق على الدهشة!
الموضوع الحقيقي للأدب: هو الظلمة المكبوتة داخل النفس، لا المثاليات التي نختلقها لنخدع بها أنفسنا، الكتابة لا تُعبّر عن (الخير) بل تغوص في الجانب الذي نتحاشى النظر إليه: الشر، والرغبة، والعدوان، والغيرة، والخوف، والأذى…
في بدء عند خلق الكتابة: دخول الكاتب إلى السرد ليس فعلا واعيا كما يتخيل كثيرون، فالكاتب يمتطي ظهر شخصياته ليعبر عن أفكاره بشكل لا شعوري، وبدون وعي أنه هذه الشخصيات هي أجزاء منه، وهو يجسدها على ظهر الورق ككائنات أراد لها الحياة بعيداً عن القبو الخفي داخل نفسه! فالكتابة ـ في لحظتها الجوهرية ـ ليست صناعة حدث، ولا عرض رأي، ولا مهارة لغوية، بل اقتحام لأعمق مناطق الذات ظلمة.
هناك حيث يتصارع الشك مع الهوية، وتنهض الخيارات الأخلاقية على هيئة امتحانات داخلية: أن أكون أو لا أكون، أن أختار نفسي أو أعتدي على الآخرين، أن أقاوم أو أن أنهار.
السرد بهذا المعنى ليس مجرد حكاية؛ إنه اختبار أخلاقي للمؤلف ذاته ـ وهذا جوهر مقالي النقدي ـ فحين يطلق الكاتب شخصياته في العالم، فإنه لا يمنحها حرية السلوك بقدر ما يختبر عبرها مخاوفه وجرائمه المحتملة، الشخصيات هنا وسائل تحليل للذات، وليست أدوات للإنشاء أو للوعظ.
عند هذه النقطة يتكشف جوهر الحقيقة: القصة ليست حدثا محايداً، بل مواجهة مع “الظل” بتعبير كارل يونغ، والظل هو ذلك الجانب المخفي والمرفوض من النفس، الجانب الذي سبق الأخلاق والقانون والحضارة، حيث لا تحضر إلا الغريزة الأولى: البقاء، والمنفعة، والانتقام، والدفاع عن الذات.
الحضارة جاءت لاحقاً لتقيد هذا الاندفاع، لكنها لم تنجح في إلغائه، فالظل لا يموت، بل يتوارى في اللاوعي الجمعي، ويعود إلى السطح كلما لامس الفرد حدود الخطر أو الإهانة.
هنا تظهر الطبيعة الملتبسة للظل: فهو ليس شريراً بالضرورة، ولكنه غير مهذب! وفي لحظات التوتر القصوى يتحول الإنسان من كائن أخلاقي إلى كائن دفاعي، إذ يصبح الغضب وسيلة للحفاظ على الهوية، ويصبح العدوان دفاعاً عن الوجود، ويصبح الشر محاولة لترميم الذات قبل أن يكون رغبة في الإيذاء… يكفي مثال بسيط: الشخص الذي يصدم سيارتك ثم ينهال بالشتائم لا يفعل ذلك لمتعة الأذى، بل لأنه يحمي صورته عن ذاته وسط فوضى التهديد! في هذه اللحظة تنقطع الحضارة، ويعود الإنسان إلى صيغته الأولى.
لهذا السبب تصبح الكتابة القصصية مسرحاً لعودة هذا النموذج البدائي، فالقاص حين يكتب يضع شخصياته في لحظات اختبار قصوى، حيث تُجبر على الاختيار بين الحضارة والظل، وهنا تتولد الدراما الحقيقية: ليست في الحدث، بل في النقطة الدقيقة التي يتحول فيها الإنسان من أخلاق إلى دفاع، ومن نظام إلى فوضى، من خير إلى شر!
على المستوى النفسي… يظل الظل مخزوناً من الرغبات والغرائز والمشاعر التي يخجل الفرد من الاعتراف بها أو يعجز عن التعبير عنها، ولهذا فهو لا يظهر عبر الجمل المنطقية بل عبر الانجذابات الغامضة، والعنف غير المبرر، والأحلام، والزلات، والشخصيات الثانوية في الأدب، وقد أدركت الأساطير هذا حين جعلت الوحش أو العدو هو الوجه الآخر للبطل: لا بطل بلا ظل، ولا بطولة بلا مواجهة.
من هنا نفهم أطروحة عالم النفس كارل يونغ: المصالحة مع الظل ليست تبريراً للسلوك السلبي، بل اعترافاً بوجوده وتفكيكاً لدوافعه… فالوعي لا يكتمل إلا حين ينظر الإنسان إلى ذاته دون قناع، أما إنكار الظل فلا يؤدي إلا إلى تضاعف قوته في العمق! ومن هذه الزاوية يمكن فهم الكتابة القصصية بوصفها تدريباً على الوعي بالذات، فكما أن الفرد مسؤول عن هويته النفسية، فإن القاص مسؤول عن هوية السرد.
ولكي يتضح هذا النموذج عملياً يمكن النظر إلى روايتي “سيد الفوضى” بوصفها صراعاً مع الظل لا بوصفها رواية تقليدية، فالبطل لا يكتب رأياً ولا يقدم حدثاً محايداً، بل يعبر عبر السرد مقتحماً مناطق النفس التي تكره الأم، وتخشى الهزيمة، وتتوهم المجد، وتعود إلى صيغة الإنسان الأول الرافض للتهذيب الاجتماعي… السرد هنا تجربة أخلاقية قبل أن يكون بناءً حكائياً.
تظهر هذه الحقيقة منذ الجملة الأولى تقريباً:
أنا وشم نزع من جسد، أملك شقاء إبليس، وخيبة الأراضي السبع!
كل شيء يبدو هادئاً وساكناً إلا نفسي! فأنا مجرم تستلقي على صدره ثورة انتقام، يحاول أن يتناساها، ولكن أوجاعه تفيض فتضعفه، ليكتشف أن عيشه كإنسان عادي هو محاولة فاشلة.
هذه ليست مقدمة رواية، بل إعلان مواجهة! البطل هنا لا يتحرك داخل القانون والأخلاق والتعاون، بل داخل منظومة الظل: العدوان، البقاء، الانتقام، والسيطرة.
وعند لحظة الاختبار يظهر القناع الاجتماعي، فعندما يلتقي بالدكتورة لا تُختبر العاطفة بل تُختبر الهوية! الدكتورة تمثل الحضارة: النظام، اللياقة، العمل، أما البطل فيمثل الظل الذي يحاول تقمص القناع دون الإيمان به.
لذلك ينهار الحوار سريعاً، وينفجر البطل بالدفاع لا عن الأخلاق، بل عن الكيان، فالظل في الرواية ليس شريراً بالمعنى، لكنه غير مهذب ـ وإن كان في آخر النص يتحول إلى شر مطلق! أو بتعبير أدق ظل كامل!
في البناء القصصي يقوم النمس ـ وهو شخصية البطل الضد ـ بوظيفة الظل الجمعي: القوة التي ترى في المجد بديلاً عن الأخلاق، وفي الهيبة بديلاً عن النظام، وفي الفوضى بديلاً عن الحضارة، أما العقدة الأصلية فهي الأم، لا بوصفها شخصية بل جرحاً نفسياً جعل النساء رموزاً للسلطة النسائية التي يكرهها البطل… هكذا يتحول الكره من موقف شعوري خاص إلى آلية دفاعية ضد الجنس كله.
هنا تأتي اللحظة الحاسمة: المصالحة لا تحدث! الرواية لا تمنح بطلها هذه النعمة، بل تتركه في مفاوضة جحيمية مع ظله، أمام المرآة لا يرى شكله بل يرى خصمه، والمرآة في الأدب ليست وسيلة رؤية بل وسيلة محاكمة.
في نهاية هذا المقال، يتجلى السؤال الأكبر: لماذا يتجوهر الأدب في موقف إنساني؟ لأن السرد الحقيقي ليس “ما حدث” بل اللحظة التي يتحول فيها الإنسان من أخلاق إلى دفاع، حين يضع الإنسان في موقف يختبر موقفه الإنساني، ماذا يختار؟ فالروايات العميقة لا تُكتب عن العالم، بل تُكتب عن الذات حين تواجه أسوأ ما فيها… والكاتب لا ينجو من هذه المواجهة إلا بالصدق، لأن الأدب العظيم، لا يجمّل الظل بل يجعله مرئياً.
من منظور النقد الأدبي والنفسي، لا تتشكل الهوية دون معركة مع الظل، ولهذا فإن الكتابة القصصية ليست رأياً، ولا بلاغة، بل تجربة داخلية في مواجهة الجزء الذي نخجل منه، وننكره ونخشى ظهوره! والرواية الجيدة هي تلك التي تتيح للقارئ رؤية هذا الجزء دون أن يشرحه الكاتب ودون أن يعترف به البطل.





