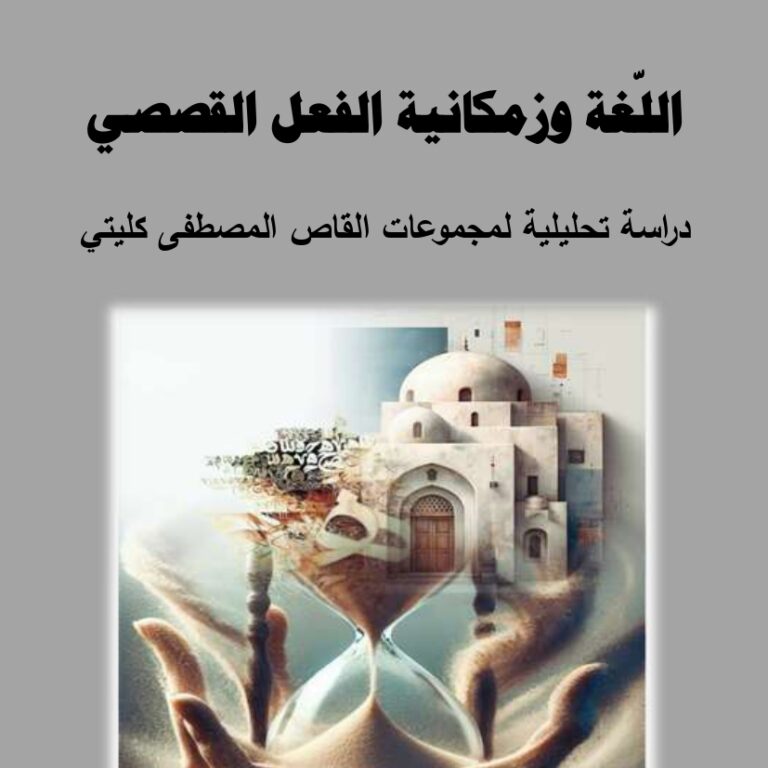الكاتب مروان ناصح
في زمنٍ لم تكن فيه الشاشات تُعلمنا الحياة .كنا نحن أبناء النهر، نتتلمذ على موجه، ونستعير من جريانه معنى الشجاعة. كانت السباحة أول امتحان في مدرسة الطبيعة، لا كتب فيها ولا معلمون،
بل نداء الماء وحده، يشدّنا كما تشدّ الأغنية عاشقها الأول. ذلك الزمن الذي كنا نختبر فيه الخوف بضحكة، ونتحدى المجهول بقلوبٍ صغيرةٍ لا تعرف سوى البراءة والاندفاع. فهل كان الزمن جميلاً حقاً؟ أم أننا نحن الذين كنا جميلين فيه؟
-الطريق إلى النهر… أول سرٍّ نتعلم كتمانه:
كانت الطريق إلى النهر حكايةً قائمةً بذاتها، رحلةَ مؤامرةٍ صبيانية، تُدار بالهمس والابتسام المريب.
نرتدي ما تيسّر من ثيابٍ قديمة، نخبّئها تحت ملابسنا النظيفة، ونمضي على رؤوس أقدامنا نحو المجهول، كمن يعبر إلى حلمٍ ممنوع. كانت كل خطوةٍ نحو الماء إعلاناً صغيراً عن تمرّدنا الجميل، فالأمهات أوصينَ بعدم الذهاب، لكن من يستطيع مقاومة النداء الأزرق الذي يسكن في الأعماق؟
كان النهر نداء الحرية، ونحن صغارُ العشّاق.
-المعلمون الصغار… دروس بلا لوحٍ ولا طبشور:
لم يكن بيننا مدربون ولا شواطئ منظمة، بل أصدقاء شجعان يتناوبون دور المعلم والضحية.
كان أول الدروس جملةً خالدة: “تمسّك بي… ولكن لا تشدّني لتغرقني!”. ومن هناك بدأنا نتعلم سرّ التوازن بين الثقة والخوف، بين الماء والهواء، بين الحياة والمغامرة. ضحكاتنا كانت أداة القياس الوحيدة لنجاح الدرس، وكل رشقة ماءٍ كانت توقيعًا جديدًا على شهادة الميلاد الثانية.
-الغرق الأول… معمودية الطفولة:
كل من ذاق طعم الماء في رئتيه يتذكّر تلك اللحظة المعلقة بين الموت والدهشة. حين ينغلق الصدر على فراغٍ من هواء، وتشتعل العينان بالذعر، ثم تخرج من الماء كمولودٍ جديدٍ يلهث من الفرح والخوف معاً. تقسم أنك لن تقترب ثانية، لكن الغد يأتي… وتأتي معه الرغبة في التحدي من جديد.
كأن الغرق كان درس الحياة الأول: أن تسقط لتتعلم كيف تطفو، وأن تخاف لتتعلم كيف تواجه.
-ملابس منشورة على الشجر… وأسرار تضحك في الشمس:
كانت الملابس المعلقة على أغصان الشجر راياتنا البيضاء، تعلن أننا في حضرة النهر، وأن الطفولة تعقد اجتماعها السري هناك. ضحكاتنا تتقافز كالعصافير، والماء يرسم حولنا هالة من ضوءٍ وحرية.
لم نكن نخجل من عري البراءة، ولا نعرف التفاخر أو المقارنة. كنا سواسية في بهجة الاكتشاف، نضحك كأن العالم خُلق للتوّ تحت شمس الصيف.
-البحر… الامتحان الأكبر:
وحين جاء البحر، بدا كأنه الأب العظيم للنهر الصغير الذي ربّانا. ماؤه أوسع، صوته أعتى، ونبضه لا يهدأ. كنا نقف أمامه في خشوعٍ الصغار أمام المهابين، ثم نخطو نحوه بخطواتٍ مترددة، نغوص لحظةً ونعود، نضحك من الملح في عيوننا، ونتباهى بجرأتنا كأننا عبرنا المحيط. كان البحر مرآةً لنا… يعكس في موجه أول ملامح الرجولة المبكرة.
-سباحةٌ دون أدوات… أجسادٌ تتعلم الإصغاء:
لم نكن نملك عواماتٍ ولا صدريات نجاة، كنا نملك الجسد وحده، والإرادة وحدها، وكانت تلك المدرسة الصامتة أصدق المعلمين. تعلمنا كيف نصغي لأنفاسنا، كيف نتحايل على الموج لا لنغلبه، بل لنصادقه، وكيف نحيا في الماء كما نحيا في الحياة: مرةً مع التيار، ومرةً ضده، لكننا دائمًا نخرج منه أقوى وأكثر نقاء.
-ماذا عن أطفال اليوم؟
يتعلم أطفال اليوم السباحة في مسابح دافئة، تحت إشراف مدربين وحراس سلامة، لكنهم قلّما يعرفون رعشة الماء الأول، ولا نشوة الخوف الجميل، حين يخترق الجسد سطح النهر لأول مرة.
تغيرت الوسائل، تحضّرت الطفولة، لكن شيئًا من سحر المغامرة تسرّب من القلوب، كأن الأمان الكثير أفقدنا لذة الخطر الجميل. ربما لم يكن الزمن جميلاً بقدر ما كانت النفوس أكثر صدقًا وبساطة.
-خاتمة:
قد نكبر، وننسى التفاصيل الصغيرة، لكن هناك دائمًا “موجة أولى” تسكن الذاكرة كنبضٍ خفي.
فيها رعشة الخوف، وارتباك البدايات، وضحكة النصر الطفولي. وحده من تعلّم السباحة في نهرٍ أو بحرٍ، يعرف أن الماء لا يُنسى… كما لا تُنسى الطفولة.
فيا زمن الماء والضحك…
سلامًا عليك، وعلى من كانوا يعمّدون فيك خوفهم ليصنعوا منه حياة.