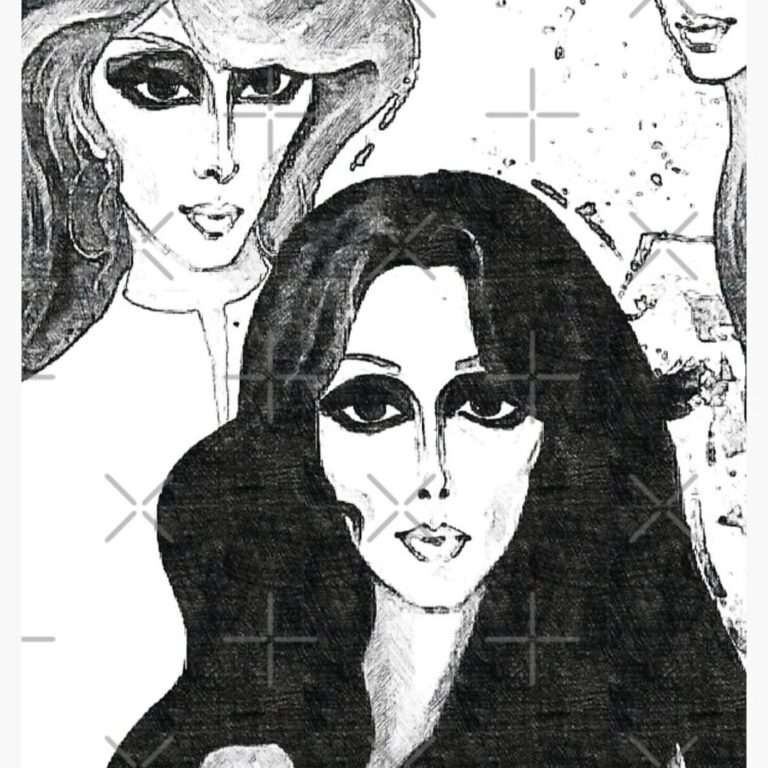د. دورين نصر
نشيج “الدودوك”: إنّ هذا العنوان اللّافت شكّل دافعًا أساسيًّا للغوص في هذا النّصّ، وذلك عبر تتبّعنا لضمير المتكلّم الذي يُحيل بمؤازرة المعنى، على إبراز تمكّن الكاتب من إظهار سيرته الذاتيّة من خلال تكثيف حضور الأنا في الرواية
والواقع، إنّ ما كتبه جلال برجس يشكّل حافزًا لمعرفة كيف تشكّلت وانتظمت تجلّيات الذات في الرواية قيد الدرس. فهل يمكن إدراج هذا العمل في جنس أدبي يحمل عنوان السّيرة الذاتيّة، أو هي رواية انطلقت من السّيرة لتفتح الحدود بين أنواع أدبيّة مختلفة؟ وهل هو يتحدّث عن سيرته الذاتيّة أو عن سيرة أناه المبدعة؟
إنّ هذا الجنس في الأدبي شهد اهتمامًا كبيرًا سواء أكان في الآداب العالميّة الذي أولى هذا النوع اهتمامًا واضحًا وجليًّا أو في الأدب العربي، فخصّصوا له عدّة تعريفات، وإن كانوا حتّى اليوم لم يتّفقوا على تعريف واضح المعالم، ولعلّ السّبب في ذلك يعود إلى اتّصاله بغيره من الأجناس الأدبيّة وربّما أكثر التعريفات دقّة لفنّ السّيرة الذاتيّة هو تعريف فيليب لوجون (Philippe Le Jeune) في كتابه الميثاق الأوطوبيوغرافيّ إذ يقول
“هي حكي استعاديّ نثريّ يقوم به شخص واقعيّ عن وجوده الخاصّ، وذلك عندما يركّز على حياته الفرديّة أو على تاريخ شخصيّته بصفة خاصّة”( ). أمّا جورح ماي (Georges May) فيتحدّث عن المبرّرات التي تقف وراء كتابة السيرة. فيرى أنّ “تَسَلُّط فكرة الزّمن والحاجة إلى معرفة الشخص لنفسه بصورة أفضل، يلعب دورًا مهمًّا”
وفي الواقع، لا بدّ لكاتب السيرة الذاتيّة من أن يفصح عن دوافعه التي جعلته يكتب سيرته. فقد تبيّنا بأنّ الجدّة في هذه الرواية هي التي أثارت عند جلال برجس الوعي الأوّل بالكتابة إذ يقول: “صدفة شعرت فيها بيدين تسحبانَني نحو عوالم الرواية ويردف قائلاً: “روت جدّتي الحكاية بوعي سردي عجيب، وبداية شيّقة، واصفة للمكان والزّمان، وللشخصيّات بمستوى لافت”. وهذا ما يُظهر تأثير فعل حكي الجدّة في النفس. وقد تكون هذه الرغبة في الكتابة رغبة ذاتيّة تنبع من صراع الذات مع وجودها، إذ لا بدّ كما أشار “نورثرب فراي” في كتابه تشريح النّقد، من أن يعيش المبدع في حالة من القلق، وهذا ما عبّر عنه برجس (ص 37): “إنّها سنواتي الأولى، سنوات ذاكرتها مغلّفة بهالة من الضباب، وقد تكون هذه الدوافع خارجيّة تأتي استجابة لدواعٍ فنيّة وثقافيّة تقتضي الحضور الإبداعي لدى المتلقّين”
( ) Philippe, Le Jeune. Le pacte autobiographique, Paris: éd. du Seuil, 1975, p. 13-14 ( )ميشال ماتاراسو، التحليل الأنتروبولوجيّ للسيرة، ديوجين، منشورات اليونسكو،1989،ص 137


إنّ الرغبة الداخليّة قد تكون حاضرة في اللّاشعور لكنّها تستتر في الدّاخل لدوافع أخرى. وهذا يعني أنّ مضمون الحكي يحفّزها إلى الخارج عندما يصبح المضمون أوسع من الوعاء الذي تحمله. قال جلال برجس ص (28): “في الكتابة أشير إليّ” وقال ص (47): “الكتابة فرار من وحش لا تتعب قدماه”، وص (209):”نعم، لقد صارت لي الكتابة وطنًا موازيًا، إن توقّفت عن بنائه سيموت، فأموت. الكتابة وطن لن يكتمل رغم كلّ البيوت التي بنيناها على أرض الورق. إن كتبتُ عن شجرة، فإنّي أشير إلى يدي، وإن كتبتُ عن السّماء فإنّي أقصد روحي، وإن كتبتُ عن البيت، والطريق، والنّاس، والبحار، والبحار، والأنهار، وحتّى عن الذي لم يأتِ بعد، فإنّي أكتب عنّي”
كيف لا يكتب عنه و هو ينتقي من ذاكرته أبرز المشاهد التي كوّنت شخصيّته ويسردها متنقّلاً من مشهد إلى آخر، فتغدو انتقائيّة الأحداث من سمات العمل السّيري لأنّه من الصّعب كتابة كلّ ما تستحضره الذاكرة، فيتمّ رصد أبرز الأحداث وتشخيصها بطريقة فنيّة بما يخدم العمل. وإنّ المشاهد التي اختارها جلال برجس تظهر تعلّقه ووعيه بالمكان منذ كان في السابعة من عمره، كما يتبيّن من خلال الأمثلة الآتية حيث يستهلّ روايته قائلاً: “في السّابعة من عمري حدث لي أمر أستصعب تفسيره للآن”. كان ذلك في إحدى ليالي صيف قريتي “حنينا”، المعادل الموضوعي للوطن الفردوس، هي المكان الأوّل الذي احتضنه وأدّى دورًا بارزًا في مسيرة حياته. يقول ص (51):” كانت حنينا للتوّ تصبح ملاذًا لجدّي من شقاء زمن الترحال وراء العشب والماء، فبنى أوّل بيت فيها من الطين والحجر”.لقد حاول الكاتب أن يرسم لنا البيئة القرويّة البدويّة التي ترعرع فيها
“قرية ينام أهلها باكرًا، حيث تنوس الفوانس ولا يبقى سوى نباح الكلاب، وثغاء الماعز، وخُوار الأبقار…”
هذا ما يُظهر ارتباط الشخصيّة الراوية بالمكان (قبل التحضُّر)، إذًا فالآليّة التقنيّة المُعتمدة هي “التذكّر” لهذه البيئة الرعوعيّة التي تتعارض مع الإسمنت (الحيوان المفترس) الذي يهدّد “بنية العائلة”، ما يحيلنا إلى شترواس في حديثة عن الصراع بين الوحش البدئي والوحش المدني. وفي تصويره للبيئة البداوية يردف قائلاً
“أنا وحيد إلاّ مع صرصار وكلب ينبح”، ما يشير إلى أنّه يرفض الوحدة على المستوى النفسي. وفي وصفه المكان في مستهلّ الرواية، يقول: “غرفة واحدة لكلّ العائلة، وهي سيمياء تشير إلى حالة الفقر المدقع التي تحيق بها. و لكن على الرّغم من ظروف العائلة الصّعبة يبقى الحنين إلى المكان الأوّل الذي وُلد فيه. يقول ص (57): “صياح أمسك بي ودفعني إلى زمن القرية، يوم كان كلّ شيء طازجًا لا تطاله يد الكدر”. إنّه الحنين إلى المكان الأوّل في بداءته، إنّه عهد البراءة والفطرة، حيث هناءة الحياة والعيش الرغد
إنّها مقبّلات الطبيعة ودفء الحياة حيث التقاليد القرويّة والتمسّك بالجذور، إذ يقول ص (59): “عدم جرأتِنا على الخروج على الجذور… ملامسة جذور أخرى ومحاولة عيشها بشكل مؤقّت خطوة ليست فقط تذهب نحو سلامتنا النفسيّة، بل أيضًا نحو سلامة الكتابة”
نستنتج ممّا سبق أنّ جلال برجس على الرغم من تجواله بين بلدان عدّة من بينها :بريطانيا، وأرمينيا ،والجزائر؛ إلاّ أنّه بقي يتوق إلى زمن البراءة، حيث كان متوحّدًا مع طبيعة القرية، ومغتبطًا بها. ذلك الزمن كان برجس يطلبه للبراءة النفسيّة، يرجع فيه إلى عهد الدّهشة الأولى والفطرة ويعانق القرية الفردوس حيث كان يجد نفسه الأصيلة ويلقى جذوره
والواقع، إنّ تعلّق الكاتب بالمكان الأوّل يشكّل جزءًا بارزًا من مسار الذات المتكلّمة. ولعلّ ذاته تقف بين زمنين: زمن الطفولة والزّمن الآني، وكأنّه يسعى إلى استحضار ذكرياته حيث العالم الخصب التلقائي، وهو ما يريده بديلاً لعالمه الحالي. فنلاحظ بالتالي بأنّ الأشياء المختبئة في ذاكرة المتكلّم كان لها حضور قويّ في حياته، وكأنّه يسعى إلى تفتيت الزّمن وتدويره، وتحريكه في كلّ الاتّجاهات، فتتحوّل بعض المقاطع السرديّة عنده إلى ذاكرة. لذلك يأتي السّرد، شخصيّ كثيف، ينجزه الراوي بضمير المتكلّم، أي هو راوٍ وشخصيّة، وهو الروائي كذلك كما أظهرت لنا قفلة الرواية التي وثّق فيها أبرز لحظات الكتابة التي انتقلت من سرد الأحداث والذكريات إلى رفيق وصديق ،حيث يقول ص (219)
“بعد أسبوع من الاستلقاء في السرير، وتلقّي العلاج، بدأت بكتابة الراوية. وحدث أنّ نصف ما خطّطت له غير صالح للكتابة، وأنّ هناك مسارات جديدة خلقت لم أفكّر بها من قبل”