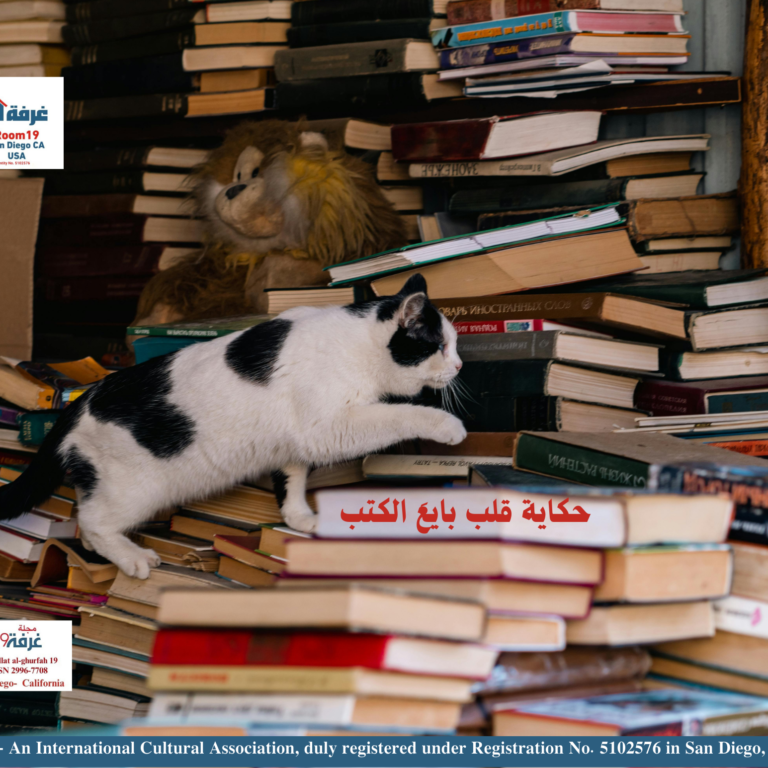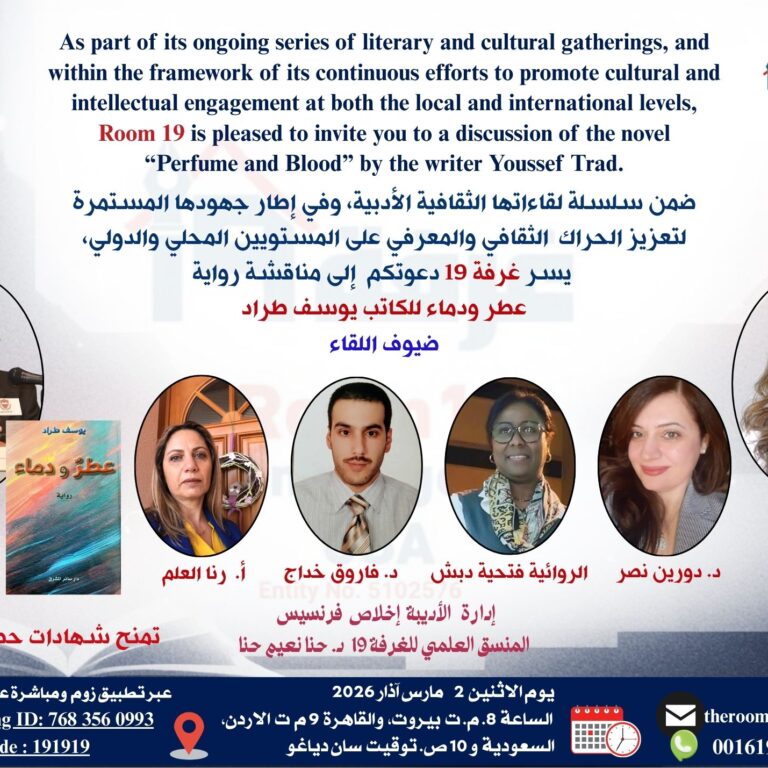موت طوعي أم حياة مستحيلة؟ عن الأدب والانتحار
في التاريخ الأدبي، تتكرر الحكاية ذاتها مع اختلاف الوجوه واللغات: شاعر أو روائي شاب، يكتب كما لو أن الحياة لا تكفيه، ثم فجأة، ينكفئ عن العالم، يختار الرحيل بصمت أو بضجيج، ويترك خلفه أسئلة لا تجف.
لماذا ينتحر الأدباء؟
هل لأنهم أبصروا الحقيقة أكثر من اللازم؟
أم لأن هذا العالم، في قسوته ورتابته، لا يتسع لقلوبهم الهشة والجامحة؟
الانتحار عند المبدع ليس مجرد قرار لحظي، بل قد يكون ذروة التفاعل مع العالم. هو لا يهرب من الألم فحسب، بل يحاول السيطرة عليه، إنه يرفض أن يكون مجرد ضحية، فيختار أن يكون فاعلاً حتى في موته. الموت هنا ليس هروبًا فقط، بل احتجاجًا، وربما حتى “تحريرًا” من سجن الجسد، أو من قيد الواقع.
جمانة حداد في كتابها “سيجيء الموت“ تصف المنتحر بعبارات مشحونة بالشعر والدهشة:
“المنتحر ليس ميتاً عادياً… ضيف مرتبك، وصل متأخراً إلى الحياة ومبكراً إلى الموت. ملاك يتيم نفسه…”
وإذا كان هذا الملاك هو شاعرٌ، فإن الفقد يصبح أكثر قسوة، كأننا خسرنا مرآة كانت تعكس أشدّ لحظات الإنسانية صدقًا وانكسارًا.
لكن السؤال المؤلم يبقى:
هل الإبداع في ذاته مسؤول عن هذا الفناء؟
هل تقود لحظات التجلي القصوى، حين يتلامس الكاتب مع نبعٍ داخلي شديد النقاء، إلى حافة الانهيار؟
أم أن الأنظمة القمعية، والبيئات الطاردة، والعزلة النفسية، هي التي تدفع المبدع إلى هذا القرار؟
ربما هو كل ذلك وأكثر.
فالأدب ليس فقط كتابة، بل مرآة لأعماقٍ لا تُحتمل أحيانًا.
والكاتب الحقيقي لا يكتب من الخارج، بل يخلع جلده في كل نص.
هو معرض أكثر من غيره للتآكل، لأن أدواته هي ذاته.
في حالات مثل سيلفيا بلاث، خليل حاوي، أو إرنست همنغواي، نقرأ نصوصًا كأنها وصايا ما قبل الفقد.
نصوص مكتوبة بالدم، لا بالحبر.
كأن الأدب نفسه كان نوعًا من الإنذار.
لكن هل يجب أن نربط الإبداع بالموت دومًا؟
هل يمكن أن يكون هناك أدبٌ لا يؤدي إلى الفناء؟
ربما، إذا وجد الكاتب متّسعًا للحياة، وإذا وجدنا نحن قدرةً أكبر على الإصغاء، على فهم أولئك الذين يكتبون من الجرح، لا من الترف.
ربما لا نمنعهم من الانتحار، لكننا نمنع أنفسنا من الغفلة.
أن نفهم أن كل قصيدة، كل قصة، كل سطر، قد يكون صرخة استغاثة، أو وداعًا مبطنًا.
وفي النهاية، ليس المهم أن نعرف لماذا انتحر الكاتب،
بل أن نسأل:
ماذا كنا سنفقد لو لم يكتب؟