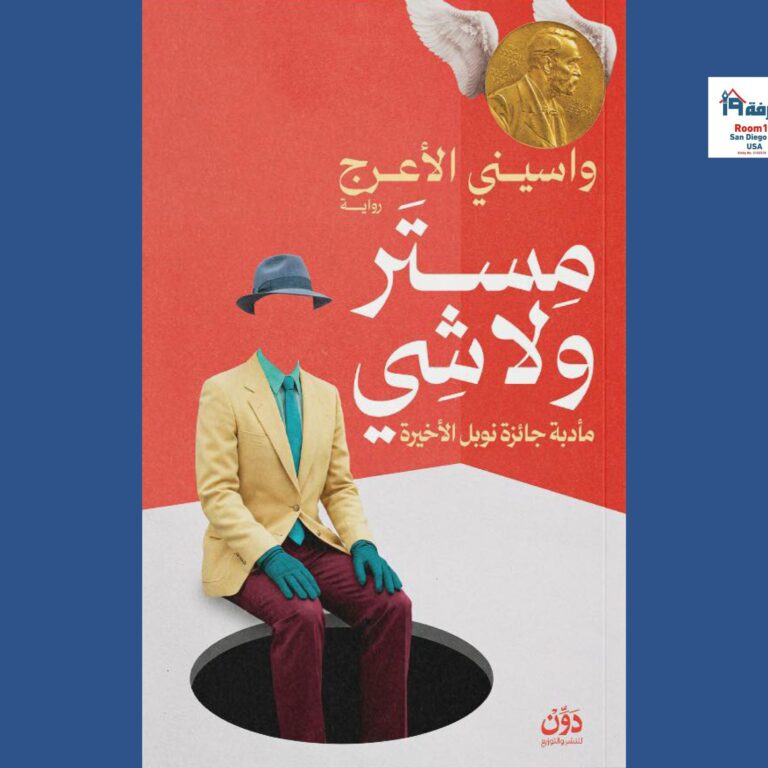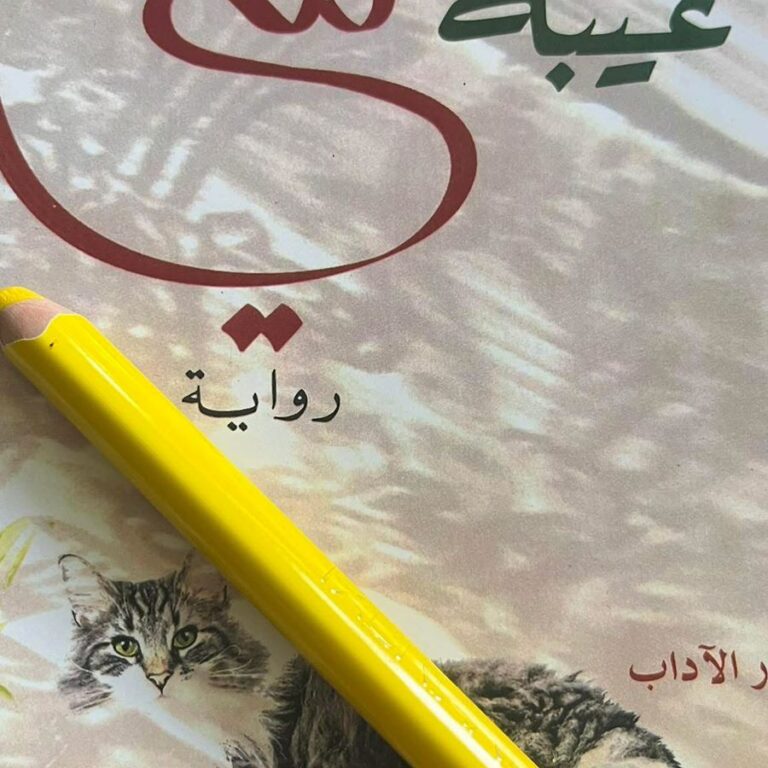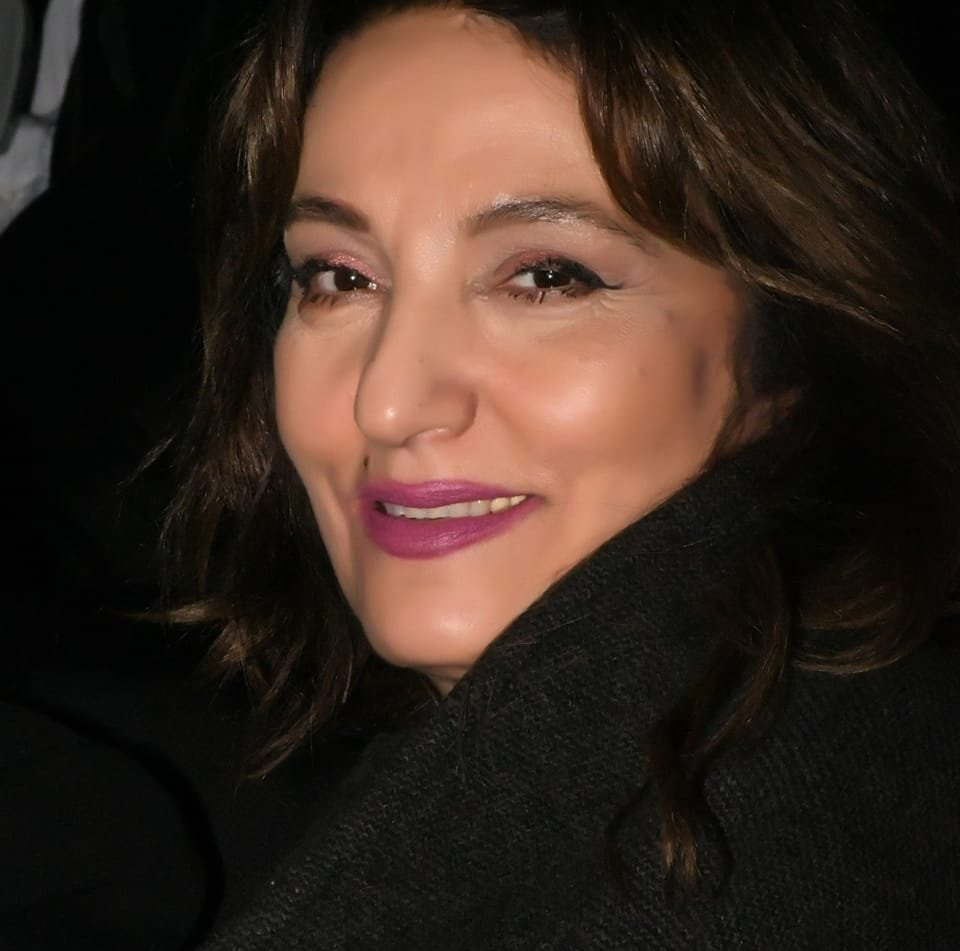
للكاتبة السورية الاسترالية أمان السيد
بقلم الناقدة السورية د. عبير خالد يحيي
تتخذ هذه الدراسة من النص المفتوح «في هذا الصباح غير الجديد» نموذجًا لقراءة ذرائعية تُقارب الكتابة الأنثوية في صورتها الاعترافية التأملية، حيث تتقاطع الذات مع اللغة في مساحة بين الحلم والذاكرة، بين الذنب والرغبة، وبين الوصية الاجتماعية والميلاد الفردي.
يأتي النص بوصفه خاطرة سردية تأملية تتسلّل إلى منطقة التماس بين الشعر والنثر، فينحلّ البناء الفني الصارم إلى تيار وعيٍ متدفّق، يتّخذ من التكرار إيقاعًا داخليًا، ومن الاستبطان حكايةً عن الوعي الأنثوي المتنازع بين الداخل والخارج. هذه الكتابة ليست مجرّد بوحٍ وجداني، بل هي محاولة فنية لتفكيك الإرث القيمي والاجتماعي الذي كبّل المرأة بمفاهيم الطهر والتضحية، وجعلها «أخت الرجال» لا ذاتًا كاملة في وعيها وميلادها.
وتتّسم الكتابة في هذا النص بما يمكن تسميته «الهُجنة الأسلوبية»، أي المزج الواعي بين أكثر من أسلوب تعبيري في مساحة نصّية واحدة؛ فالسرد الاعترافي يتقاطع مع الإيقاع الشعري، والتأمّل الفلسفي يتجاور مع اللغة الحسّية الانفعالية. هذه الهُجنة لا تُعدّ خرقًا لقوانين الأجناس، بل تعبيرًا عن تطوّر الوعي الجمالي لدى الكاتبة، إذ تتجاوز القوالب الجامدة لتُنتج نصًّا مركّبًا يعكس تعدّد مستويات الوعي ذاته. ومن منظور ذرائعي، تُعتبر الهُجنة الأسلوبية مؤشّرًا على نضج التجربة الإبداعية واتساع أفقها الفني، لأنها تُحقّق ما تسميه الذرائعية بالتكامل الجمالي والمعرفي بين القول الشعري والتفكير التأملي والسرد الوجداني.
في المنظور الذرائعي، يمثّل النص وحدة فكرية وأخلاقية وجمالية تتجسّد فيها علاقة المبدعة بعالمها ومجتمعها من خلال المنفعة الجمالية والمعرفية؛ فالقيمة هنا ليست في الحكاية ولا في الصياغة فحسب، بل في المنفعة الوجودية التي تولّدها التجربة حين تتحوّل الكتابة إلى فعل تحرّر ذاتي. الكاتبة لا تكتب لتصف، وإنّما لتستعيد التوازن بين الفن والحياة، بين الأمومة والحلم، بين الحب والوصية.
إن اختيار هذا النص للهُجنة الأسلوبية وللانفتاح الدلالي يعبّر عن وعيٍ نقديٍّ معاصر يخرق حدود الأجناس، ويؤسس لما تسميه الذرائعية “التجاور الجمالي”، حيث يصبح النص بنية مفتوحة على تعدّد التأويلات. ومن خلال هذا التجاور، يتحقّق ما تسعى إليه الذرائعية من ربط الجمال بالقيمة الأخلاقية والنفعية في الآن نفسه، لتتحول الكتابة إلى حركة وعيٍ تُعيد تعريف الذات والأنوثة والحرية.
وسيكون بيان ذلك من خلال دراسة النص بالمستويات الذرائعية التالية:
أولًا: المستوى الفكري والأخلاقي
البؤرة الفكرية:
يقوم النص على بؤرة فكرية محورية هي سعي الذات الأنثوية إلى إعادة ميلادها خارج سلطة الوصايا الأبوية والمجتمعية.
فمنذ الجملة الافتتاحية «في هذا الصباح غير الجديد سأرفس السياسة» نواجه موقفًا فكريًا واضحًا من العالم الخارجي الذي يرمز إلى السلطة والمؤسسات والوصاية الفكرية، مقابل اختيار الموسيقى بوصفها رمزًا للجمال والحرية والذاتية. هذا التناقض بين الرفض والاختيار يُشكّل محور النص: التحوّل من الخارج إلى الداخل، من السياسي إلى الإنساني، من الإملاء إلى الإبداع.
إن الكاتبة هنا لا تتحدّث عن السياسة كمجال عام فحسب، بل كرمزٍ للهيمنة التي تغزو حتى تفاصيل الحياة الخاصة. لذا فإن رفس السياسة يعني تمزيق القناع الاجتماعي المفروض على المرأة، والعودة إلى ذاتها الأصلية – الحالمة، المتأمّلة، المبدعة.
في هذا السياق، يتحوّل النص إلى بيانٍ داخليٍّ لميلاد جديد، عنوانه الحرفي «ميلاد S»، حيث يصبح الحرف رمزًا لذاتها التي تنبثق من رماد التجربة.
المنظور القيمي (الخلفية الأخلاقية):
يؤسّس النص منظومة أخلاقية نقيضة للقيم التقليدية. ففي حين يُصرّ المجتمع على ترسيخ معايير الشرف والوصايا الجاهزة، تعيد الكاتبة صياغة الأخلاق عبر صدق التجربة والرحمة والحب لا عبر الخوف والعار.
يتجلّى ذلك في قولها:
«نحن لا نخاف عليك، فأنت أخت الرجال.. غسّلوني بها، وهم يغسلون أبي، وأمي تغتسل بدموعها…»
هذا المشهد الكثيف يكشف عن الازدواج الأخلاقي الذي يمارسه المجتمع: المرأة يُقال لها إنها قوية وطاهرة، لكنها تُغسل بعار الرجال وتموت معهم رمزيًا. هنا يتبدّى موقف النص الأخلاقي الرافض لهذه المعايير الزائفة، ليقدّم بديلًا قيميًا إنسانيًا: الطهر الحقيقي هو الوعي، والقوة هي الحب، والوصية لا تكون قيدًا بل إرثًا من الرحمة.
الفكر الفلسفي الضمني:
من زاوية ذرائعية، الفكر في النص ليس مجرّد خطابٍ مباشر، بل وعي فلسفي باطني يتجلى في الأسئلة الكينونية:
«هل تراني سأستطيع؟!»
«أني لم أتقن يومًا كيف أوصل الحب لمن أحبهم…»
هذه التساؤلات ليست اعترافات عابرة، بل تجسيد لفلسفة الشكّ الوجودي: كيف نحب؟ كيف نتحرّر؟ كيف نولد من جديد؟
النص هنا يربط بين الحب والمعرفة، بين الفقد والإدراك، ليقدّم موقفًا وجوديًا متفائلًا رغم الألم: فحتى العجز عن إيصال الحب يُعدّ وعيًا به، أي بداية للتطهّر من جهل الذات.
القيم الذرائعية في النص:
1. القيمة الجمالية: تتحقّق في الانسجام بين اللغة والصورة والموقف.
2. القيمة الأخلاقية: تتجلّى في رفض الظلم الاجتماعي واستعادة إنسانية المرأة.
3. القيمة النفعية: في المنفعة الوجودية التي تولد من الاعتراف والتطهّر النفسي؛ فالنص يُعين القارئ على مواجهة ذاته كما واجهت الكاتبة ذاتها.
ثانيًا: المستوى البصري (التصويري)
النص هنا يتّكئ على صورة مشهدية ديناميكية أقرب إلى اللقطات السينمائية التي تتحرك بين الحلم والواقع، بين الماضي والحاضر، وبين الطفولة والنضج.
في الجملة:
«في هذا الصباح غير الجديد سأرفس السياسة»
نرى صورة جسدية عنيفة تختزل فعلًا نفسيًا عميقًا، فالرفس ليس مجرد حركة احتجاج، بل رمز لتمرّد داخلي على قسوة العالم.
إن الفعل الحركي هنا يجسّد لحظة انفصالٍ بين زمنين: “غير الجديد” أي المكرّر الرتيب، وزمن الميلاد الجديد الذي تسعى إليه الكاتبة.
الصورة الثانية تأتي عبر:
«سأجرّب أن أستعير طفلتي، وأحجل…»
المشهد هنا مزدوج: الأم تستعير طفلتها لتستعيد خفّتها القديمة، وفي الوقت ذاته تُحاول أن تتعلّم من البراءة ما فاتها من بساطة الحياة.
الطفلة في هذا المشهد مرآة روحية للأمّ، والحجل (القفز برجل واحدة) استعارة عن العجز الإنساني أمام اكتمال الذات، فالكاتبة تحاول الوصول إلى هدفها رغم نقصانها الرمزي.
أما الصورة الثالثة فهي الأكثر غرابة وجرأة:
«جرّة الحب لدي مشعّرة»
هنا يتحوّل الحب إلى كائن مادي، حسيّ، قابل للمسّ والتأمّل، ولكنه ليس ناعمًا ولا مثاليًا، بل يحمل الشعر كعلامة على الغرابة والبدائية والصدق الفجّ.
هذه الصورة تمنح النص طاقة بصرية نادرة، لأنها تخرج من الجمال المصقول إلى الجمال الخام غير المروّض، أي جمال الصدق لا التجميل.
وأخيرًا، المشهد الجنائزي في نهاية النص:
«غسّلوني بها، وهم يغسلون أبي، وأمي تغتسل بدموعها»
صورة بصرية مكثّفة تجمع بين الماء والدمع والموت والتطهير في آنٍ واحد، وتعمل على غلق الدائرة الدرامية للقصيدة عبر طقس الغسل الذي يتحوّل إلى رمز للتطهّر والميلاد معًا.
النص إذًا يُبنى على سلسلة صور طقسية متوالدة: من رفس السياسة إلى حجل الطفلة إلى غسل الجسد، كأن الأنثى تعبر مراحل الوعي بالجسد والروح في رحلة نحو ميلادها الرمزي.
ثانيًا: المستوى اللساني (اللغوي والإيقاعي)
اللغة في النص مزيج من البساطة التعبيرية والعمق الإيحائي، فهي تتحدّث بلسانٍ يوميٍّ ظاهريًا، لكن تحت السطح تتشكّل طبقات من الانفعال والتأمل.
- الإيقاع الداخلي: يتحقق الإيقاع عبر:
- التكرار الطقسي لعبارة:
«في هذا الصباح غير الجديد»
هذا التكرار يمنح النص بعدًا إنشاديًا يشبه التلاوة أو الطقس الشعائري، فيتحوّل إلى محور إيقاعي يربط الفقرات ويؤسّس للمناخ التأملي.
- التوازن التركيبي بين الجمل الطويلة القصصية والجمل القصيرة الانفعالية مثل:
«لكن هل تراني سأستطيع؟!»
هذا التناوب يولّد موسيقى داخلية متقطعة تشبه تنهّدات الوعي الأنثوي.
2. الحقول الدلالية
حقل الأمومة والحب: (طفلتي – رحمي – أمي – حمل – حب – بكرهما).
حقل المقدّس والطقس: (صومعتي – تعبدت – ابتهلت – غسّلوني).
حقل الموسيقى والفن: (الموسيقى – الحلم – الجميلة الحالمة).
هذه الحقول تتداخل في نسيج لغوي يربط المقدّس بالإنساني، والفن بالأمومة، مما يجعل النص نشيدًا أنثويًا متكامل النغمة والرمز.
3. البنية الصوتية
تسود أصوات المدّ (الألف والياء) في نهايات الجمل:
«حالمة مثلي»، «لأصل إلى هدفي»، «أني لم أتقن يومًا».
هذا التمدّد الصوتي يعكس حالة الارتخاء التأمّلي والبوح الهادئ، ويقابلها نغمة قاسية في الأفعال الحركية القصيرة: «أرفس، أحجل، أغتسل»، لتتحقق جدلية الموسيقى الداخلية بين الشدّة واللين.
4. اللغة الانفعالية
يغلب على النص أسلوب الاعتراف الموجوع:
«وأنا ألوم نفسي على فكرة، مجرد فكرة»
الجملة قصيرة متقطعة، مليئة باللوم، وتكشف عن تيار وعي مفعم بالندم والتمزّق، ما يمنح النصّ نبرة نفسية شديدة الصدق.
وهكذا، نجد النص يبني جماليته على لغة حسية مشهدية تجمع بين الإيقاع الداخلي والصورة الحركية، وعلى توليد بصري متدرّج يحرّك القارئ من الرفض إلى البوح إلى التطهّر.
هو نصٌّ يتكلم بصور، ويُفكر بإيقاع، ويبوح بلغةٍ تشبه النفس حين تتأمّل نفسها في المرآة.
ثالثًا: المستوى الديناميكي (الحركة الداخلية والبنية الشعورية)
في النص حركة خفيّة تسير من الخارج إلى الداخل، ومن الجسد إلى الوعي، ومن الفعل إلى التأمل.
تبدأ الكاتبة بفعلٍ جسديٍّ عنيف:
«سأرفس السياسة»
وهو إعلان صدامي يرمز إلى رفض العالم الملوّث. هذا الفعل يشحن النص بطاقة انفعالية تشكّل نقطة البدء في الدينامية الشعورية.
لكن سرعان ما تتحوّل الطاقة من الخارج إلى الداخل:
«سأجرّب أن أستعير طفلتي، وأحجل…»
تتراجع الذات من المواجهة إلى التجربة الذاتية، فتسلك طريق الاستبطان.
الحركة هنا انتقال من الفعل الثوري إلى الفعل التأمّلي، وكأنّ النصّ يقول: الثورة تبدأ من الداخل، من إصلاح علاقة الذات بذاتها.
وفي الفقرة التالية، تتحول الطاقة إلى إدراكٍ ومعرفة:
«أكتشف أن جرّة الحب لدي مشعّرة…»
هنا تنفتح الذات على وعيٍ ساخرٍ بعيوبها، وتقبل هشاشتها بوصفها إنسانية.
إذًا الدينامية تقوم على ثلاث مراحل:
1. الرفض – رفس السياسة.
2. الاستعادة – استعارة الطفلة والحجل نحو الذات.
3. الاعتراف – اكتشاف قصور الحب والبحث عن التطهير.
وفي النهاية، تتخذ الحركة شكلًا دائريًا مأساويًا:
«غسّلوني بها، وهم يغسلون أبي، وأمي تغتسل بدموعها…»
هنا تبلغ الحركة ذروتها، فالتطهير لا يتمّ إلّا بالموت الرمزي، أي أن الميلاد الجديد يمرّ عبر الفناء.
بهذا تغدو الدينامية النفسية حركة من التمرّد إلى الإدراك إلى الطهر.
رابعًا : المستوى النفسي (التحليل السيكولوجي)
النص من منظورٍ نفسي هو رحلة اعتراف ذاتي تفيض بالشعور بالذنب والخلاص في آنٍ واحد.
الكاتبة تعيش صراعًا داخليًا بين الأنثى المتمرّدة والأنثى المذنبة، بين صوت الرغبة وصوت الوصية.
1. صراع الذنب والرغبة: العبارة:
«وأنا ألوم نفسي على فكرة، مجرد فكرة»
تكشف عن حالة كبح ذاتي عميق، إذ تَدين الذات حتى الخيال. هذا النمط من اللوم المستمرّ هو ما يصفه علم النفس بـ الذنب الموروث (Inherited Guilt)، وهو شعور تنتجه التربية الصارمة والوعي الجمعي الأبوي.
لكن الكاتبة، بإدراكها هذا الشعور وفضحه لغويًّا، تتحرّر منه جزئيًا؛ لأن الاعتراف أول درجات الشفاء.
2. الحنين إلى الأمومة كمركز أمان نفسي
في المقطع:
«كانت أمي تحتضن أبي، تشرقه بحب، وهي تحلم أن تحمل بي…»
الأم هنا ليست شخصية سردية فحسب، بل رمز للحنان الأصلي وللتوازن النفسي المفقود.
ومن خلال هذا التخييل، تسعى الكاتبة إلى ترميم فجوة الحب الأولى — تلك التي تُفسّر نفسيًا على أنها حنين لاواعي إلى وحدة ما قبل الولادة، أي إلى رحم الأمان الوجودي.
3. الارتعاش بثقل الوصية
«أنا أرتعش بثقل الوصية حتى اللحظة…»
هذه الجملة هي القلب النفسي للنص، إذ تبيّن أن الذات لم تتحرّر بعد تمامًا، وأنّ الحمل الأخلاقي والاجتماعي ما زال يقيّدها.
الارتعاش هنا ليس خوفًا، بل ارتجاف من ثقل التاريخ الجمعي الذي أورثها الألم والواجب معًا.
4. العلاقة بالزمن والوعي
يتبدّى في النص تداخل بين أزمنة متعدّدة: “هذا الصباح”، “مساء قبل هذا الصباح”، “ذاك الصباح الحزين”.
هذا التلاعب بالزمن يدّل على وعي زمني متشظٍّ، كما لو أنّ الراوية تعيش أزمنتها في آنٍ واحد.
في الذرائعية النفسية يُعد هذا التداخل دلالة على تيار وعي مضطرب، لكنه صادق، يعكس اختلاط الذاكرة بالحاضر، والوعي باللاوعي.
5. التطهير (Catharsis)
ينتهي النص بفعل تطهيري كامل:
«غسّلوني بها، وهم يغسلون أبي، وأمي تغتسل بدموعها…»
إنه طقس انفعالي يشبه ما وصفه أرسطو بـ”التطهير التراجيدي”، لكنّه في المنظور الذرائعي تطهير وجودي؛ فالذات تتطهّر من ذنبها بالاعتراف والكتابة، لا بالموت الفعلي.
التحليل الديناميكي النفسي في ضوء الذرائعية
تُظهر الذرائعية أن النفس الإنسانية كيانٌ متحرك بين قطبي الخير والشر، الطهر والرغبة، الخوف والحب، وأنّ النص الأدبي هو مجال لتمثيل هذا الصراع وتحويله إلى طاقة إبداعية نافعة.
وهذا ما يحدث في هذا النص: تتحوّل المعاناة إلى فن، والوجع إلى إدراك، والاعتراف إلى ميلاد.
فالميلاد في العنوان ليس جسديًا، بل ميلاد الوعي بعد خوض معركة النفس.
وهكذا، تتجلّى في النص دينامية صعودٍ من الرفض إلى الوعي، تتناغم مع بنيةٍ نفسية متوتّرة تبحث عن التوازن بين الأم والابنة، بين الوصية والحرية.
هي رحلة داخلية تجسّد ما تسميه الذرائعية بـ “المنفعة النفسية للفن”، إذ تتحقّق الفائدة من خلال تطهير الذات بالقلم، لا بالعقاب.
خامسًا: المستوى الإيحائي (الرمزي والدلالي)
النص في جوهره رحلة رمزية مكثفة عن ميلاد الذات من رحم القيد.
فكل عبارة فيه مشحونة بإشاراتٍ باطنية تتجاوز معناها الظاهري لتكوّن نسيجًا من الرموز والطبقات التأويلية التي تربط بين الجسد، والفكر، والأمومة، والمقدّس، والموت.
1. دلالة العنوان: «في هذا الصباح غير الجديد / ميلاد S»
العنوان نفسه ثنائي الطبقة:
«في هذا الصباح غير الجديد»: يشي بالزمن الرتيب، الواقع المكرّر، الحياة التي لم تتجدّد بعد.
«ميلاد S»: يفتح الأفق نحو ولادةٍ رمزية جديدة، تنقض الرتابة وتعلن بدء دورة أخرى للوعي.
الحرف S يحمل دلالات مفتوحة:
قد يرمز إلى Self (الذات) — أي ميلاد الوعي الداخلي.
أو إلى Sin (الخطيئة) — إذ يولد النقاء من رحم الخطيئة الإنسانية الأولى.
كما يمكن أن يرمز إلى Silence (الصمت) أو Soul (الروح)، أي ميلاد الكلمة بعد صمتٍ طويل.
هذا التعدّد الإيحائي يعكس مقصود الكاتبة في خلق نص مفتوح على أكثر من تأويل، حيث المعنى لا يُقال بل يُلمح إليه.
2. رمزية الصباح والمساء
يتكرر في النص توتر بين الصباح والمساء، كأنهما قطبان للزمن الوجودي:
الصباح يرمز إلى البداية والأمل، لكنه هنا “غير جديد”، أي أنه فقد نقاءه.
المساء يرتبط بالذاكرة، بالحلم، بالماضي الذي يتكرّر كجرح.
وبينهما تنسج الكاتبة خيط الزمن الأنثوي: زمن دائري يعيد الأحداث لا ليكرّرها، بل ليعيد قراءتها شعوريًا.
هو زمن الحنين المتجدّد، حيث كل صباحٍ هو تكرارٌ لمساءٍ سابق، وكل ميلادٍ هو استمرارٌ لموتٍ قديم.
3. رمزية الجسد والطقس
يتجلّى الجسد في النص ليس بوصفه موضوعًا حسّيًا بل كوسيلة إدراك ومعرفة:
“جرّة الحب مشعّرة” تحيل إلى الجسد كوعاءٍ بدائيٍّ للحب الخام.
“أحجل لأصل إلى هدفي” تحيل إلى الجسد الناقص الذي يحاول التوازن، رمز للأنوثة المجروحة التي تتعلّم المشي من جديد.
“غسّلوني بها” تحيل الجسد كأداة تطهير وعودة إلى الأصل.
في الذرائعية الرمزية، هذه الصور تشكّل ما يُعرف بـ الحركة الطقسية (Ritual Movement)، أي تحويل الفعل الجسدي إلى رمزٍ للتطهّر النفسي والروحي.
فكل حركةٍ جسدية في النص هي في جوهرها فعل خلاصٍ وجودي.
4. رمزية الأم
الأم في النص ليست شخصية واقعية بل رمز كوني:
تمثّل الرحم الأول، والمصدر، والمطلق.
وفي الوقت نفسه، المرآة التي ترى فيها الراوية امتدادها وسبب ألمها.
حين تقول الكاتبة: «كانت أمي تحتضن أبي، تشرقه بحب، وهي تحلم أن تحمل بي» تستحضر لحظة الخلق الأولى، لحظة الحب الخالص الذي سبق الخطيئة.
الأم هنا تُقابل في الرمز الخلق الأنثوي المقدّس، وتتحوّل إلى أيقونة الوجود المتجدّد، بينما الأب يمثل البذرة أو الفعل الإلهامي الأول.
الولادة إذًا ليست بيولوجية فقط، بل كلمة كونية تتكرّر في كل أنثى تكتب.
5. رمزية الماء والتطهير
«غسّلوني بها، وهم يغسلون أبي، وأمي تغتسل بدموعها…»
الماء هنا يقوم بدورٍ مزدوج: غسل الموت وغسل الميلاد.
في الموروث الرمزي، الماء هو حدّ فاصل بين عالمَين — بين الطهارة والدنس، بين الحياة والموت — وهكذا يتحوّل المشهد الأخير إلى عمادٍ رمزيٍّ تتطهّر فيه البطلة من وصية العار( أخت الرجال)، لتولد من جديد.
6. رمزية الموسيقى
«سأستبدل السياسة بالموسيقى…»
الموسيقى ترمز إلى الانسجام الداخلي، وهي في مقابل السياسة — رمز الفوضى والقبح — تمثل صوت الروح مقابل صوت السلطة.
باختيارها الموسيقى عنوانًا لحياتها الجديدة، تُعلن الكاتبة انتقالها من خطاب العالم إلى إيقاع الذات.
فالموسيقى هنا ليست ترفًا فنيًا، بل لغة خلاصٍ.
7. الإيحاء العام
النص بكليّته إيحاءٌ متدرّج بالتحوّل:
من الانكسار إلى المقاومة، ومن الذنب إلى الوعي، ومن الخضوع إلى الوعي بالمقدّس الأنثوي.
وهذا التحوّل يُنتج ما تسميه الذرائعية بـ المنفعة الإيحائية — أي القيمة الوجدانية التي تتولّد من الجمال الرمزي حين يُعيد تعريف المفاهيم الأخلاقية والفكرية في ذهن القارئ.
بالنتيجة، ينسج النص عالمًا رمزيًّا تُولد فيه الأنثى مرتين:
مرّة من رحم الأم، ومرّة من رحم اللّغة.
ويصبح الحرف S ختمًا رمزيًا على هذا الميلاد الجديد، حيث تتجلّى الذات وقد غسلت وصاياها القديمة بالماء والكلمة.
الكتابة هنا ليست فعلًا جماليًا فحسب، بل طقس عبورٍ من الظلمة إلى المعنى، من القيد إلى التجلي.
التجربة الإبداعية
ينتمي النص إلى فضاء الكتابة الأنثوية الاعترافية المعاصرة، لكنه لا يكتفي بالتعبير عن الذات، بل يعيد صياغة العلاقة بين الأنثى واللغة في زمنٍ ما بعد الصدمة.
الكاتبة تمارس هنا نوعًا من الكتابة الطقسية، حيث يتحوّل النص إلى معبدٍ صغير للبوح، وإلى مرآة تُطهّر الذات من رواسبها، وفق ما تسميه الذرائعية بـ (المنفعة الوجودية للكتابة).
التجربة الإبداعية في هذا النص تقوم على ثلاثة مستويات متداخلة:
1. المستوى الفني:
الكاتبة تمارس الهُجنة الأسلوبية بوعيٍ جماليٍّ رفيع، فتدمج السرد بالشعر، والاعتراف بالرمز، لتنتج نصًّا مفتوحًا على تيار الوعي دون أن يفقد تماسكه البنائي.
يُقرأ النص كصفحة من اليوميات، وكقصيدة نثر في الوقت نفسه، وهو ما يضعه في قلب التحوّل الفني للأدب المعاصر الذي يرفض تصنيفاته القديمة.
2. المستوى النفسي: تمثّل الكتابة فعلَ خلاصٍ من الذنب الجمعي الذي كبّل الأنثى عبر أجيال، فالكاتبة تحوّل الألم إلى إدراك، والوصية إلى وعي.
في ضوء علم النفس الإبداعي، يمكن القول إن هذا النص يُجسّد ما يُعرف بـ التحويل الجمالي للصدمة (Aesthetic Transformation of Trauma)، أي إعادة صياغة التجربة المؤلمة في شكلٍ جمالي يمنحها معنى بدلًا من مرارتها الأولى.
3. المستوى الفكري: التجربة تُعيد تعريف مفاهيم الأخلاق، الحرية، والحب. فالقيمة الأخلاقية هنا ليست في الطاعة، بل في الصدق الداخلي والرحمة الإنسانية.
الكتابة تتحوّل إلى وسيلة مقاومة صامتة ضد الخطاب الأبوي والسياسي، لذلك يمكن اعتبار النص بيانًا جماليًا للحرية الأنثوية عبر اللغة.
إنّ الكاتبة — عبر هذا النص — تُمارس ما تسميه الذرائعية بـ “الوعي المزدوج”: وعي باللغة كأداةٍ جمالية، ووعي بها كأداة نجاة.
فهي لا تكتب لتصف، بل لتتطهّر؛ لا لتروي، بل لتتجدّد. وهكذا يصبح الفن هنا شكلاً من أشكال البقاء.
في الختام:
يقدّم النص نموذجًا متقدّمًا لما يمكن تسميته في النقد المعاصر بـ “الكتابة الهجينة ذات البنية الطقسية” — نصٌّ يمزج الشعر بالسرد، والعاطفة بالفكر، والمقدّس باليومي، ليعبّر عن تجربة أنثوية تتجاوز الاعتراف الشخصي إلى تأملٍ كوني في معنى الوجود والميلاد.
من خلال القراءة الذرائعية، يمكن القول إن النص حقّق توازنًا بين المستويات الثلاثة الكبرى التي تقيسها الذرائعية:
المنفعة الفكرية: عبر رفض الزيف الاجتماعي وإعادة تعريف القيم.
المنفعة الأخلاقية: عبر السعي إلى التطهّر لا عبر الخضوع.
المنفعة الجمالية: عبر بناء لغوي وصوري متقن يُحدث المتعة الفكرية والانفعال معًا.
أمّا من جهة القيمة الإنسانية، فقد تحوّل النص إلى وثيقة وجدانية عن صراع المرأة مع القيد، وعن ولادتها من رحم الألم إلى رحابة الوعي. إن “ميلاد S” لا يرمز إلى اسمٍ أو حرفٍ بعينه، بل إلى ولادة الكلمة بوصفها خلاصًا، وإلى ميلاد الذات التي وجدت في الحرف ما عجزت الحياة عن منحه. هكذا يبرهن النص على أن الكتابة ليست ترفًا لغويًا، بل فعل مقاومة وخلقٍ متجدد، وأن الأنثى حين تكتب بصدقٍ تنقذ العالم من عتمته الصغيرة.
«ميلاد الذات من رحم الوصايا» نصٌّ هجيني مفتوح يجسّد تطوّر الوعي الأنثوي عبر لغةٍ مشهدية متوهجة، ويمثّل في منظوره الذرائعي تحقّق الفن بوصفه منفعة وجودية وأخلاقية وجمالية في آنٍ واحد.
إن الكاتبة تولد في كل سطرٍ من جديد، تغسل الكلمات بدمعها، وتعلّمنا أن الكتابة — حين تكون صادقة — هي أصدق طقوس الخلاص.
النص: أمان السيد
في هذا الصباح غير الجديد سأرفس السياسة، وسأستبدلها بالموسيقى التي تُعنوِن لها امرأة جميلة حالمة مثلي، بفارق أنها تدخن، وتشرب الويسكي، وأنا ألوم نفسي على فكرة، مجرد فكرة..
في هذا الصباح غير الجديد، سأجرّب أن أستعير طفلتي، وأحجل، أن أقفز برجل واحدة لأصل إلى هدفي بقدميّ كليهما، لكن هل تراني سأستطيع؟!
في هذا الصباح غير الجديد، أكتشف أن جرّة الحب لدي مُشعّرة، وأني لم أتقن يوما كيف أوصل الحب لمن أحبهم، وأني ما أزال بحاجة إلى أن أحجل…
مساء قبل هذا الصباح بثلاثة عشر شهرا، كما كانت تدّعي، وهي تغمز، كانت أمي تحتضن أبي، تشرقه بحب، وهي تحلم أن تحمل بي، بِكرهما، أعرف كم جهدت لتحظى بي، فقد جهدت لأحظى بها، وحيدتي، وفي صومعتي تعبدت وابتهلت ليكون العالم أفضل لنا.. أذكر كثيرا تلك اللحظة التي قررت فيها أن ينتفخ رحمي بحب سيقزّم الكون بعينيّ، أنا خير من يفهم أمي…..
في ذاك الصباح الحزين، وَعيتُ الدرس جيدا.. نحن لا نخاف عليك، فأنت أخت الرجال.. غسّلوني بها، وهم يغسلون أبي، وأمي تغتسل بدموعها…
أنا أرتعش بثقل الوصية حتى اللحظة…
د. عبيرخالد يحيي الاسكندرية – مصر 19 /10/ 2025