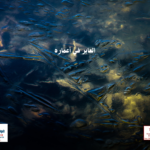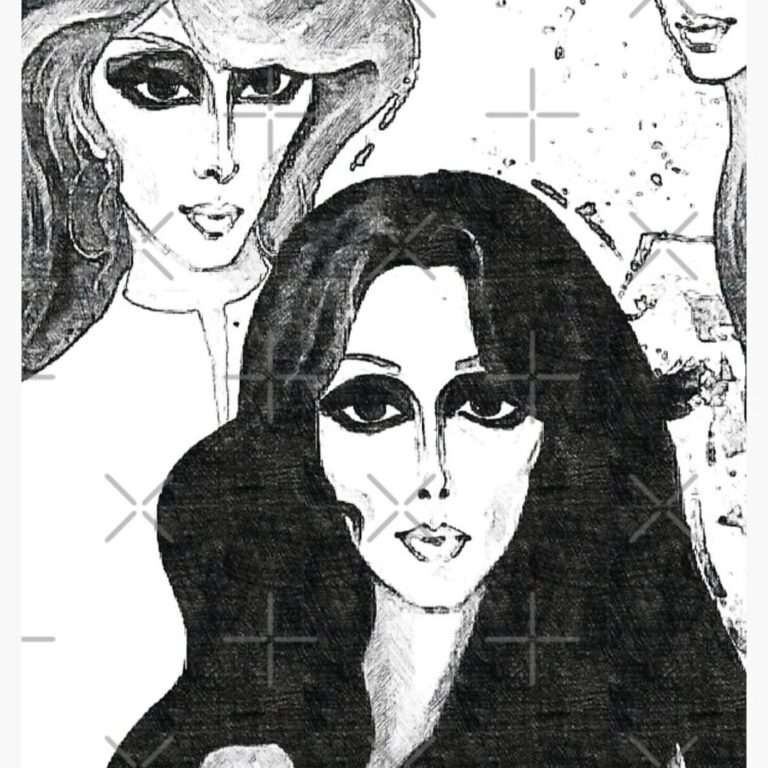ناظم ناصر القريشي

بعيد البعد في بعده كالبعد في المرايا وقريب القرب في قربه كالقرب في المرايا
ناظم ناصر القريشي
في البداية، أن تحاول اكتشاف ما يمكن أن يتضمنه ديوان جديد يحمل عنوانًا شاسعًا، عبارة عن نداء وإجابة وما بينهما، يشبه أن تحفر عميقا في ذاكرتك عن كل الإبداعات التي مرت بك وتتخيل ماذا سيكون وما هي الحياة التي يحتويها هذه الديوان
فالمسافة بين النداء والإجابة هي القصيدة، وما يحتويهما هو موج الكلام، وسيمفونية الحياة. فالعنوان: “يا حياة، أتوق إليكِ، فتجيبنى: أتوق إليكَ”، قد يعطيك الانطباع ذاته الذي وصفه الديوان الصادر عن دار المتوسط للنشر – إيطاليا، والذي يحتوي على سبع وسبعين قصيدة تجاوز فيها الشاعر مفهوم الشعر بمعناه المعروف إلى شكل أكثر مرونة عبر سردية تعبيرية وسخاء نثري وشعرية كونية. فهو ليس رائعًا وحسب لانحيازه للحياة، بل لأنه يحتوي دوماً عناصر بسيطة ومتجانسة تشعرك بالحيرة لجمالها، لتوافق الإلهام مع الفكرة التي انبثق عنها التكوين الفني والشعري للصورة
قراءة موسيقية
علينا أن نقرأ ونستمع ونرى ونتأمل، فنقرأ شغف الشاعر فيما دونَه من كلمات في مفتتح ديوانه قصيدة: “قد نكون في تدافع ماشِين من دون أن تتلامس خطواتنا”، فنجد أن الشاعر يتأمل بياض الورقة، وهو بياض شاسع كالولادة، ويدون عبر أفكاره المتدفقة سيمفونية لا تروضها سوى متعة الكتابة. تبدأ مسافتها الزمنية بعبارة “مرة أخرى”، وهذه العبارة موالية لما قبلها، وتكرار لما بعدها، فتضارعه في حضورها، وتتوافق مع تواترها واتساقها، وتنتهي هذه المسافة بعبارة: “في تمتمات خفية”. لهذه السيمفونية ثلاث لوحات، وسنجد تلميحات هنا وهناك بقصد الإيحاء نثرَها الشاعر، وتساعد على التوزيع الموسيقي للقصيدة

اللوحة الأولى
ما قبل التكوين والإيحاء بفكرة قد يكون مجال الشعر والموسيقى هنا واسع لا للاحتواء فحسب بل للبحث والاكتشاف في بدء البدء. هكذا يبدأ بهذه العبار: “مرة أخرى، تَطلب مني الظهور من دون هيئة”، أي الحضور في الكلمات من دون شروط واشتراطات. وهذا يحيلنا الى الانطباعية في فنون التشكيل إذ يحضر الرسام بذاته، وليس كريشة، ثم ينتقل الى العبارة التالية
“ليستْ في يدي خريطة، ولم أضعْ رسمًا لخطواتي”
ثم يوضح ما يمتلك
“فقط هذا النَّفَس. هذه الرغبة في القول التي تسبقني فأجدني أستقبلها من دون معرفة مسبقة”
ثم تنتهي هذه اللوحة بهذا المقطع
“بابٌ يصطفق على عابرِِيه من دون أن يُحسنوا حساب الوقت الداهم أو المنقضي
ألهذا تبدو ساعة الحائط رتيبة في رنينها فيما يبلع الشارب ريقه أمام ما يعبر أمام عينيه الخافتتَين؟”
نلاحظ عبر المسافة الزمنية للقصيدة ظهور كلمات أو مقاطع صوتية، مثل باب يصطفق أو ساعة الحائط الرتيبة في رنينها. وهذا ما يعادل انخفاض وارتفاع النغمات في النوتة الموسيقية في تناظر وانسجام مع الكلمات. وفي سُلَّمها الكثير من النغمات التي تحاول الوصول الى الذروة، وتجسم ذاتها فوق ورقة القصيدة، وكأن العالم كله من حولها يراقبها. وكما قلنا في مقال سابق إن الشعر هو الحالة الأيونية للكلمات وعلينا ان نتخيل ماذا بعد ذلك
اللوحة الثانية
ليبدأ بعدها مقطع صغير يهيؤنا الى اللوحة الثانية والتي تعبر عن الإمساك بالفكرة ولغتها التكوينية. فتمرير الفكرة عبر ديناميكية الكلمات وحركتها المستمرة وضخامة العمل الشعري الاوركسترالي للإمساك بالانفعالات، وتحويلها الى موجات متدفقة تنبض بالموسيقى عبر احتمالات عديدة تقدمها تلك الموجات في التعبير عن الأفكار والاكتشافات التي تتلوها، مع التأكيد على العلاقة التفاعلية بين جماليات الصورة والموسيقى
“فوق طاولة، تتداول الورقةَ أكثر من يد، من دون أن تعرف جملة السابقِ فوقها من جملة الوافد إليها
يتناوبون عليها
يسجِّلون وحسب مرورهم العابر
فيما تخطفُها منهم بيدك الخفية، ورقةً تلو ورقة، وتُبقي غيرها لمن يظن أنه وصل إليها بعد طول سفر”
لتنتهي هذه اللوحة بهذا المقطع
“فهي ليست طريدة، وأنتَ لست قنَّاصًا ما دام أن بينكما ما يشمُّه الحبيب في الحبيبة، والحبيبة في الحبيب، قبل أن ينعطف الخصر إلى الخصر وتلتقي الشفتان بأوسع مما تسعان”
اللوحة الثالثة
التكوين، الانتهاء، ثم البحث من جديد، لتكتمل دورة الحياة في يقين حضورها في القصيدة، وتكتمل القصيدة في يقين الحياة وحضورها، والتعبير عنها بقوة الشعر القادر على التعبير عن جوهر الإنسانية الخالص فتبدأ”
“- أأنتَ تكتب أم تحبُّ؟
أأنتَ تكتب إذ تحبُّ أم تحبُّ إذ تكتب؟
= ألي أن أجيب أو أشرح أو أبرر ما أعيش، وأن أفصل لساني عن أصابعي، ودفقَ دمي عما ينشب في غفلة الحروف عن قوامها؟
– ها أنتَ تداور من جديد وتتخفى خلف بريق ألفاظ”
ثم ينتهي المقطع كما يلي
“فتتقدم شفاهي لتلاقي شفاهها وأصابعي لتوافي أصابعها مثل واحد في اثنين
فتتنصتُ عصافير فوق أغصانها وتحلو حبات ليمون في بريقها المتراقص
فلا يسع الفضاء غير أن يلفَّهما في عرائهما الأبيض مثل ستارة عرس
ستارة ما يكشف رمحًا لعنفوانها وقبضةً لعزمهما الرقيق وقبلةً لما يتصاعد في تمتمات خفية”
الأكيد هو أن هناك مستوى من الشعور لا تدركه الكلمات، لكن إذا حولنا هذه الكلمات الى موسيقى فإنها تتكلم في بعد آخر، فسنرى الشعر بكل جماله، الشعر الحقيقي الذي لا يزنه أي شيء. هذا ما يبتكره موج الكلام في الموسيقى وما تتعاكس به الافكار
قراء افتراضية
عنوان هذه القصيدة يحيلنا الى العالم الافتراضي وأكوانه المتوازية الذي يقترب منه الشاعر كثيرا، فسنجد ورقة القصيدة عبارة عن جدار، وهذا الجدار يتحول الى شاشة، والشاشة تتحول الى ورقة تدور. وهذا ما نتداوله في عالمنا الحاضر، في حياتنا، والذي تقاسمنا مع العالم الافتراضي باستخدام الحاسوب والهاتف المحمول. حتى طريقة الكتابة تغيرت كثيرا، فنحن نضغط على أزرار أو نلمسها لكي نكتب، وعندما نكتب نكون قد انتقلنا الى العالم الافتراضي. فنحن أمام شاشة وداخلها في نفس الوقت. ورقة تدور فيقرأها الكثيرون. لذلك “قد نكون في تدافع ماشِين من دون أن تتلامس خطواتنا”. ولا نستغرب دهشة الشاعر حينما يتساءل عن منطق اللغة الرقمية في العالم الافتراضي
“= أهذا جدار أم شاشة؟
– لعله جدار لشاشة
= لا، هو ورقة تدور
– لعلي ورقة تدور”
كما يقول ايضًأ
“هذا يأكل وهو يعاين هاتفَه، ويشرب وهو يعاين هاتفَه، ويمسح فمه بهاتفه من دون أن يفترق عن ملاحظته، فقد تصلُه رسالة صاعقة من قارىءٍ أكيدٍ يقرأ ما يكتب”
البحث عن الزمن المفقود: “النزول” إلى بيروت
علمني كيف أبكي
في قصيدة “النزول” إلى بيروت نجد الشاعر، كما مارسيل بروست، يبحث عن زمنه المفقود في استرجاعات عديدة، يحاول الشاعر فيها أن يستدرك ما فاته، والقبض على سر الزمن والتعبير عن قلقه الوجودي. فهو يضعنا امام زمنَين: الواحد بموازاة الأخر. ففي الوقت الذي يظهر فيه الماضي حاضراً أمامنا في القصيدة يبدو وكأنه ليس من هنا كأنه ينتمي إلى مكان وزمن آخر يستحيل الولوج إليه من جديد لأن حضوره يشكل علامة غيابه رغم أنه يظهر مرئياً بكلمات الشاعر على اعتبار انه شكل من الأشكال التي ترويها النفس. لكن في اللحظة التي يندمج فيها الزمنان ليصبح هذا النداء : “يا حياة، أتوق إليكِ… فتجيبني: أتوق إليك” الزمن المطلق في القصيدة، الذي يتحقق في هذا الديوان الذي لدينا، وفي هذه القصيدة بالذات. وربما ضاهى بها الشاعر صورة الفنان في شبابه لجيمس جويس لتصبح صورة الشاعر في شبابه”
“نزولُ ما تخفُّ حمولته في السَّير
ما يتصاعد في أنفاس حلم
ما تتحرَّى عنه القصيدة، فلا تجده
إذ ما استبقى النزولُ
غيرَ ما نثرَه في قصيدة مفتوحة.
هكذا لا أتوانى عن النزول
من دون أن أتقدم
أتمشى فقط
من دون أن أتراجع
أصعد إلى عالي العمارة، وأصيح
يا حياة، أتوق إليك
فتجيبني: أتوق إليك”
الشاعر وتحولاته في قصيدة: “ذلك الطفل الذي كَتب”
هذا هو سحر الكلام وانتقالاته المدهشة في الزمن الذي سنجد امتداداته في قصيدة ذلك الطفل الذي كَتب ثم ليكمل موسيقى الماء وبحضور هاندل في قصيدة الشاعر والطفل
“ذلك الطفل الذي كَتب
لم يكن قد أمسك بعدُ بقلم
ولا تمدَّدَ فوق ورقة مثل بساط ريح
وما صرف عينَين لشاشة أو كتاب
كان يجول وحسب بين صخور لم يعتد التنقل بينها
ويبتسم فقط
لمّا تطيرُ فراشة من دون علمه
لمّا يُقْبِلُ حسُّون على تغريداته من تلقاء نفسه
أما الوريقات التي نادتْه من علو أشجار الجوز
نادتْه وحده من دون رفاقه على ضفة النهر الأخرى
فلم يعلم مقصودها
ولا مغزى إشارتها له
ما دام أنه وقع على الأرض وحسب
ووجد الأشجار عالية ما يكفي لكي لا يشعر بألفة معها”
لقد أمضى الشاعر مسافة القصيدة يتحدث في حومة شغفه، وهو يلتقط التجربة الشعرية في أقصى نعومتها وارتعاشها ورهافتها، عن طفل الماضي الذي سيصبحه في المستقبل، وهو يصغي وحيدًا إلى صوت الاغصان تغني بكل ما فيها من عنفوان، وبكل ما منحت من قوة الطبيعة على نغمات بيانو ابيض بمفاتيح خضراء. ولأول مرة يتلفت حوله وهو في متاهة القصيدة الشاسعة؛ بينما الكلمات ترقبه وهو ينمو بدهشة. هذا الطفل الذي رأى كل المعاني تتجلى في روحه حين رأى الشجرة وهي تتحول الى قصيدة، هل كان حديثا صامتا بينه وبين الشجر عبر روحانية بسيطة تتجاوز لغة الكلام وعرف من خلالها معنى الحياة؟ لكن الذي نعرفه أن الكلمات بقيت ومضى الزمن
قلب طفل صغير لا يكف عن الشعر
الشاعر لم يهجر طفولته لأنه تمسك بالشعر وتوحد مع الكلمات، وهي لديه كذكرى الحاضر كما يقول الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون. فهي حياة داخل حياة مضاف اليها الحياة في القصيدة؛ وسنجد أن قصيدة “بين طفل وشاعر” هي الأكثر انعكاسا لذات الشاعر في كثافة لحظته الشعرية، وربما قبل ما تومض في ذاته، فتمر تحت مرأى دهشته وانبهاره وهو يحاول اللحاق بها”
“يمدُّ الطفل إصبعه إلى حجر مثل نحات
أو إلهٍ يفكر في صُورِ مخلوقاته
يمدُّ الشاعر لسانه إلى ألفاظ فلا يجدها
بل يجد غيرها
مما يرتق به فتوقًا
بين عبارة وفجوة”
وهذه العبارة التالية لما بعد الخلق والتكوين الشعري بعد أن مرقت اللحظة الشعرية بزمنها المطلق (“يمدُّ الشاعر لسانه إلى ألفاظ فلا يجدها، بل يجد غيرها”) تعبر عن حسرة الشاعر. فالطفل أكثر اكتمالا في شاعرية على الفطرة، والشاعر الذي جلس يُسائل غافلين عن غيبوبتهم النافرة هو أكثر حضوراً في التدفق الذي لا ينضب لتلك الشاعرية
“بين طفل وشاعر دروس متأخرة
لا تعوِّض ما فات
الطفل نسيَ قصيدته حيث مضتْ
وجلس الشاعر يُسائل غافلين عن غيبوبتهم النافرة”
ليه خلتنى أحبك ؟
التجربة وملامح القصيدة
عندما دون يوهان شتراوس سيمفونية “الدانوب الازرق” ولظروف معروفة جعل منها موسيقى للحياة وتحاكيها. والناظر الى تجربة الشاعر شربل داغر خلال ديوانه “يا حياة، أتوق إليكِ… فتجيبني: أتوق إليك” سيجد أن الشاعر يكتب للحياة أيضا. والفرق في أن تكتب للحياة او تكتب عنها هو أنك جميل جوهريا. والشاعر شربل داغر هو كذلك، لذا نجد الجمال ينبع من خلال كتاباته وحتى يجعلها تليقُ بالحياة. عزف لحناً أنغامه جلية وغامضة في آن تنبعث منه جاذبيّة ساحرة، تؤكد خلاله الكلمات حضورها الرقيق بفضل حيويتها وسعة خيال الشاعر الذي يمنحنا الفرصة الى ان نتسلل الى الحلم، الى خلف الكلمات، الى أصل الاشياء. يرافقنا نهراً من اللون الاخضر، الذي ينفتح على ما تبقى من براءتنا الأولى. والشاعر جعلنا نتسائل كيف نصل الى الشعر المطلق المستغرق دائما في كمال ذاته. وإذا كان وصفه بعيدًا عن فعل الروح التي نأسرها في الكلمات، والتي تدرك أن ما نعتقده نهائي هو بحد ذاته ابتداء للغة شعرية بالغة الحضور، والتأثير مفتوحة على الحياة، واحتمالات المرور من الشعر الى الموسيقى إلى الواقع عبر ميلودي الكلمات. هو المطلق الذي هو بعيد البعد في بعده، كالبعد في المرايا، وقريب القرب في قربه، كالقرب في المرايا. والمرايا هي اللغة الأولى لعالم افتراضي، لا تحمل افكارها، وانما تحمل أفكار المقابل؛ لكن القصيدة تحمل افكارها وأفكار المقابل، فكيف يعرف الشاعر أن هذه الفكرة ستكون قصيدة، وكيف يعرف أنها موجودة في الكلمات، فيذهب باللغة الى أقصاها، والشعر هو أقصى اللغة الذي يدون الدهشة والانبهار. وهذا ما أبدعه الشاعر شربل داغر