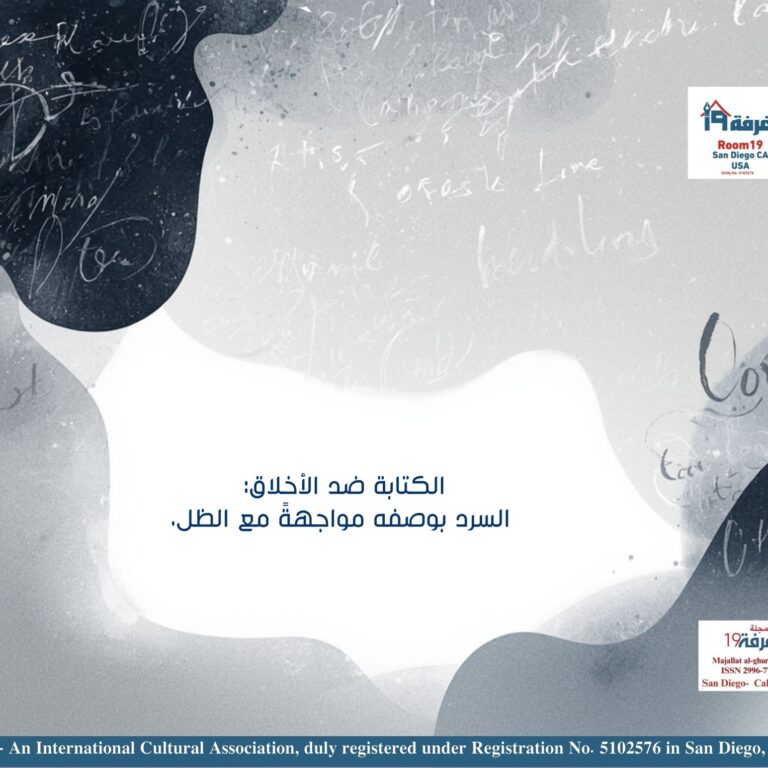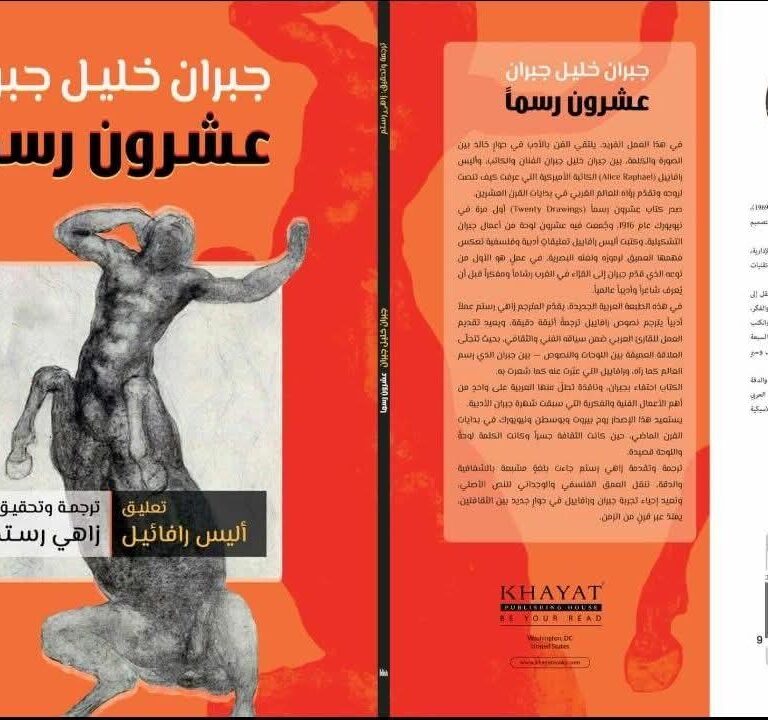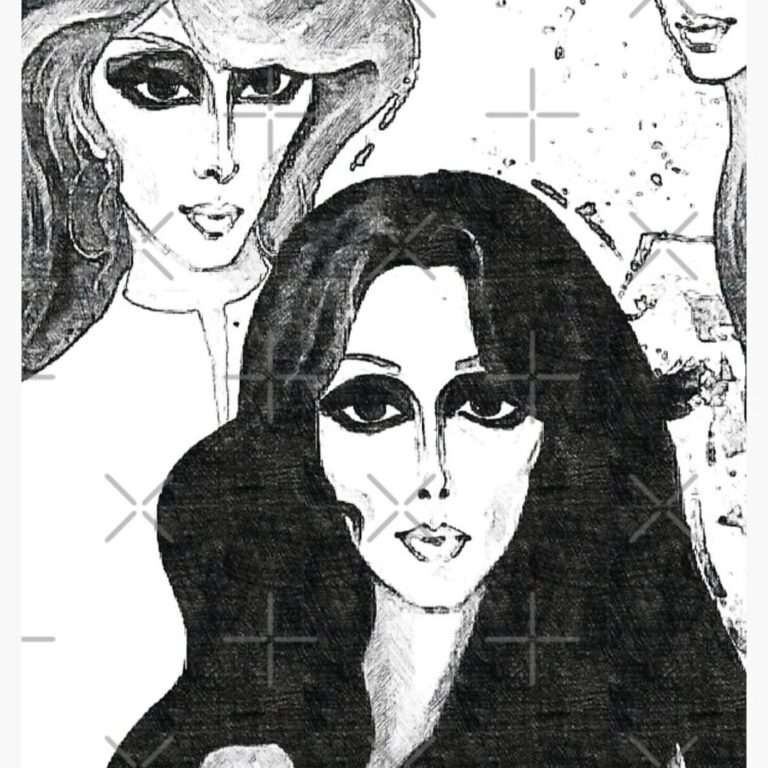بعد حلقة أولى عرضت فيها للأسس التي قامت عليها الأغنية، في نهاية القرن التاسع عشر وطوال القرن العشرين، برموزها الكبار، غناء وتلحينًا وشعرًا، أستكمل العرض بسؤال: أيَّ برنامج أو مؤسَّسة أو أكاديميَّة أو شركة إنتاج صنعت هؤلاء الكبار؟ ولم كان التنافس شريفًا بين مبدعين كثر؟
يكون الجواب ليس أيٌّ منها، بل المناخ العام الَّذي أوجد جبالًا تحاكي جبالًا في زمن واحد وعلى رقعة جغرافيَّة واحدة. فتعاونوا، شعراء وملحِّنين ومغنِّين، مستندين إلى آراء أئمَّة في اللُّغة والموسيقى والنَّقد والذَّوق، كأن نعرف مثلًا أنَّ العبقريَّين عاصي ومنصور رحباني، على أهميَّة موهبتهما وإبداعهما، كانا محاطين بسعيد عقل وجورج شحادة والأب بولس الأشقر والفرنسي روبيار وبوغوص جيلاليان وأنسي الحاج وصبري الشَّريف وبيرج فازليان وغيرهم، مستشارين لهم في الشَّاردة والواردة، وأنَّ عبدالوهاب غرف من معين أحمد شوقي الأدبيِّ حتَّى أتخم، وكذا كان عبدالوهاب نفسه بالنسبة إلى عبدالحليم حافظ. حتَّى إن ملهى (“نايت كلوب” بلغة اليوم) كانت تملكه وتديره اللُّبنانيَّة السورية بديعة مصابني في القاهرة، خرَّج كبارًا من مثل فريد الأطرش ورياض السُّنباطي. ولا يمكن أن ننسى رائدًا في الموسيقى والغناء هو سيِّد درويش المصريُّ الإسكندرانيُّ الَّذي أحدث ثورة في المجالين (وكذلك في الأوبِّريت المسرحيَّة)، بنقله الأغنية من طور “الدَّور” والجمود، إلى شكلها الرَّاهن، بسيطة تصوِّر أوضاع النَّاس ومشاعرهم، ومحددة بمذهب ومقاطع، فشقَّ لها دربًا سار عليه الكبار الآخرون ولا يزالون.
 لقطة جمعت الكبار (من اليمين): منصور رحباني، فيلمون وهبة، بديعة مصابني، محمد عبدالوهاب، فيروز، فريد الأطرش، عاصي رحباني، نجيب حنكش
لقطة جمعت الكبار (من اليمين): منصور رحباني، فيلمون وهبة، بديعة مصابني، محمد عبدالوهاب، فيروز، فريد الأطرش، عاصي رحباني، نجيب حنكش
كانت شركات الأسطوانات تتولَّى أمر هؤلاء، بداية، ثمَّ شركات الإنتاج السينمائيِّ، وبعدها الإذاعة والتِّلفزيون، ودائمًا المسرح بكلِّ أشكاله، وكذلك انتشار الكاسيت في مرحلة لاحقة. أذكر مثلًا أنَّ أغنية عبدالحليم حافظ “على حسبي وْداد قلبي” الَّتي أطلقت شهرته على أوسع نطاق، كانت تخلي شوارع لبنان، خلال موعد بثِّها من الإذاعة اللُّبنانيَّة، الثَّانية عشرة إلَّا ربعًا ظهر كلِّ أحد، مطلع السَّبعينات من القرن الماضي.
 عبدالحليم حافظ “على حسبي وْداد قلبي”
عبدالحليم حافظ “على حسبي وْداد قلبي”
وكان التَّنافس شريفًا بين هؤلاء، ومن لا ينافس غيره، كان ينافس نفسه… كأن تنوِّع أمُّ كلثوم في سنة واحدة، في أغنياتها، بين محمَّد القصبجي وزكريَّا أحمد ورياض السُّنباطي، وتصوَّروا ماذا ستكون النتيجة، بخاصَّة عندما يعلم كلٌّ من هؤلاء الملحِّنين أنَّ الآخر هو أيضًا مكلف إعداد لحن لـ “السِّتّ”. وغير ذلك، ثمَّة أغان كانت تتطلَّب من ملحِّنيها سنة أو أكثر لتختمر ويرضى عنها قبل أن تؤدِّيها المطربة أو المطرب، كمثل أغنية “أغدًا ألقاك” الَّتي نظمها الشَّاعر الهادي آدم ولحَّنها عبدالوهاب لأمِّ كلثوم.
وثمَّة أغان كانت تؤجَّل أسابيع قبل إذاعتها لأنَّ المغنِّي أو الشَّاعر أو الملحِّن غير راض عن كلمة فيها، وهذه حال “أنت عمري” الَّتي أصرت أمُّ كلثوم على تغيير مطلعها الَّذي كان “شوَّقوني عينيك”، ليصبح “رجَّعوني عينيك”، برضى الشَّاعر أحمد شفيق كامل وسروره. ثمَّ إنَّ رياض السُّنباطي كان يعيد بصوته تأدية الأغاني الَّتي وضعها لأمِّ كلثوم، ليس اعتراضًا على أدائها، بل لمزيد من الإتقان، لأنَّ ثمَّة نوتة أو قفلة أو جوابًا أو قرارًا لم تقدِّمه هي كما أراده هو، فضلًا عن أنه كان يصر على حضور حفلاتها، بعكس محمد عبدالوهاب الذي كان يتجنب ذلك.
 أم كلثوم “إنت عمري”
أم كلثوم “إنت عمري”
وبعد، ثمَّة أغان ولدت، مصادفة، ومن دون عناء تفكير، لكنَّها كانت تختزن، لحظة ولادتها، بحرًا من الثَّقافة والجمال والتَّألُّق والإبداع، من دون أن يكون واضعها واعيًا بمصيرها، فشلًا أو نجاحًا. فأغنية “شايف البحر شو كبير” لم تتطلَّب من عاصي رحباني الَّذي ألَّفها، ليالي سهر، بل قطفها من لسان ابنته ليال حين كانت صغيرة في حضنه، وسألها وهما ينظران من نافذة منزلهما في الرَّابية، والبحر من تحتهما، والسَّماء الصَّافية من حولهما: “بتحبِّيني يا بابا؟”، أجابته: “شايف البحر شو كبير… قدّ البحر بحبَّك”، فكانت تلك الرَّائعة الغنائيَّة اللُّبنانيَّة بصوت فيروز. وأغنية “شتِّي يا دنيي” للأخوين رحباني وفيروز، أضيفت إلى عمل كان معدًّا، في السّتوديو شعرًا ولحنًا وأداء، خلال دقائق قليلة، لأنَّ ذاك العمل كان ناقصًا عن مدَّته الزَّمنيَّة المطلوبة، خمس دقائق. وأغنية “ع اللُّوما” الَّتي وازت في حضورها في الذَّائقة والذَّاكرة الشَّعبيَّتين، الأغاني الفولكلوريَّة، أضافها وديع الصَّافي إلى مجموعة أغان لإصدار أسطوانته الأولى، في اللَّحظة الأخيرة، وبناء على طلب من القيِّم على شركة الأسطوانات عبدالله شاهين، الَّذي قال له إنَّه يحتاج بعد إلى أغنية قصيرة ليكتمل العمل.
 فيروز: “شايف البحر شو كبير”
فيروز: “شايف البحر شو كبير”
الأمثلة كثيرة، والرِّوايات عنها لا تنضب، وليس الهدف من إيرادها، السَّرد والتَّسلية، بل القول إن ولادة الأغنية، قديمًا، في ذاك الزَّمن الجيِّد، كان يتمُّ بعد مخاض حقيقيٍّ، مؤلم ومتعب ومكلف، لأنَّ الأغنية مسؤوليَّة ملقاة على عاتق صانعيها، إذ ستصبح ملكًا للنَّاس، وعلى ألسنتهم، ورفيقة سهراتهم ولحظات حزنهم أو فرحهم، وجزءًا لا يتجزَّأ من يوميَّاتهم.
والمفارقة اللَّافتة في هذا السِّياق أنَّ معظم هؤلاء المبدعين لم يكن متعلِّمًا وحامل شهادات عليا، ولم يدخل معهدًا موسيقيًّا أو يتخرَّج في جامعة، في اختصاص الموسيقى، بل علَّمته مدرسة الحياة والخبرة وتفاعل الآراء والانفتاح على فنون الغير، من دون مركَّبات نقص، وتثقَّف على نفسه وعلى آخرين.
قد يقول قائل: ما شأننا ومسيرة هؤلاء ما دامت الحياة تتطوَّر، والأمور اليوم باتت أسهل، ومعاهد الغناء والموسيقى كثيرة ومنتشرة في كلِّ حيٍّ، ووسائل الإعلام، المرئيَّة منها بخاصَّة، صارت فردًا من الأسرة وهي تنقل إلينا ما نعجز عن الحصول عليه وتفيدنا وتثقِّفنا وتسلِّينا؟ الجواب في الحلقة المقبلة.