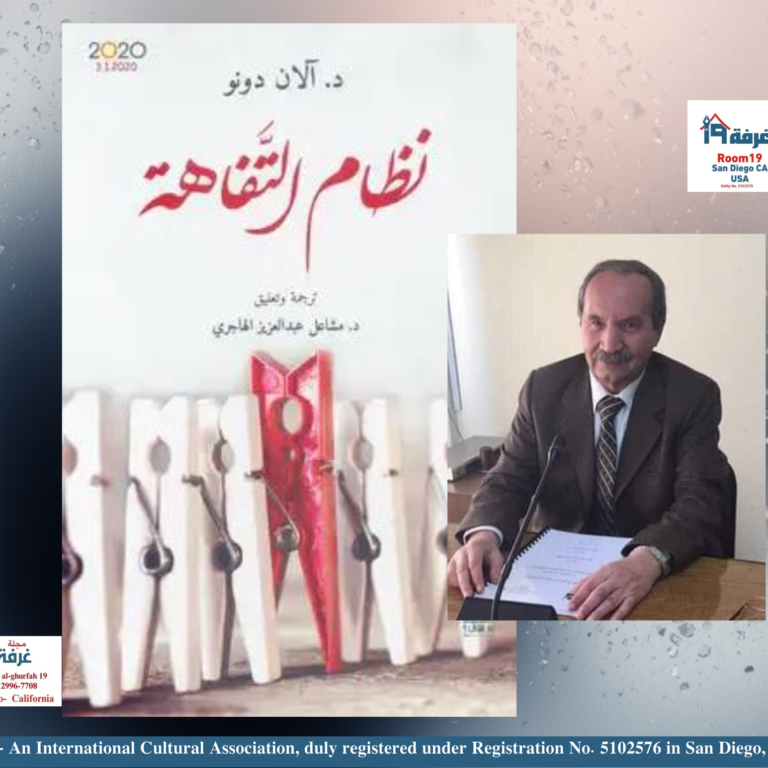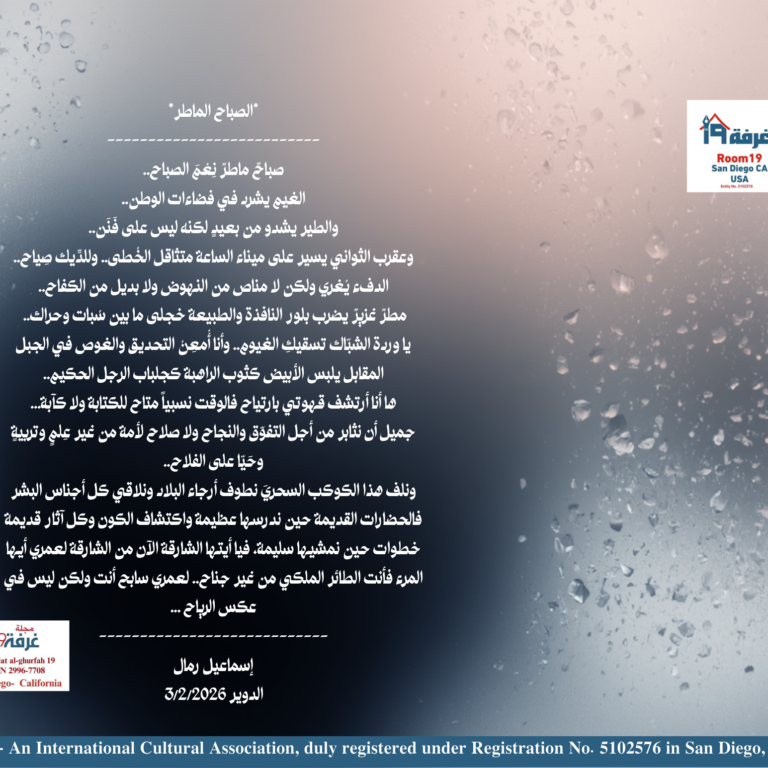الدكتور السعيد بوطاجين
أقيم قبل سنوات ملتقى القصة القصيرة في إحدى مدن الغرب الجزائري، وقد حضرته نخبة من النقاد وكتّاب القصة في ذلك الوقت الذي شهد ندوات ولقاءات ونقاشات مكثفة، ولأنّ أغلب المسؤولين لا يهتمون بالكتاب والكتابة والابداع واللغة، فقد افتتح الوالي أشغال المهرجان بقوله: “مرحبا بكلّ من هبّ ودبّ”، معتقدا أنه رحّب بالحضور بشكل لائق. أصبحت هذه العبارة بمثابة نكتة نتداولها، وكانت شبيهة بما قاله أحد المنشطين في الاتحاف الأدبي بولاية بسكرة: “وما زاد الطينة بلّة حضور السيد الوالي والسلطات المحلية”، وكان سعيدا بذلك.
أصبحت أتذكر الطرفتين عندما أقرأ بعض النصوص الجديدة التي تسمي نفسها روايات ومسرحيات وقصصا قصيرة وقصائد، في حين أنها تدخل في خانة ما هبّ ودبّ. كأن الوالي تنبأ بالمستقبل فقال كلمته الشهيرة عن وعي، مستبقا الأحداث بأعوام، دون أن يزيد الطين بلة. هناك سباق نحو التأليف والشهرة بأقلّ التكاليف، وبجهد في الدرجة صفر. لقد ذكر الكاتب الأمريكي هنري ميللر في كتابه ربيع أسود، متحدثا عن تجربته في النشر: “عندما أنهي مؤلفا أضعه في الثلاجة لمدة سنة، ثم أعيد قراءته من جديد”.
وهو يقصد المراجعة والصناعة والتمحيص والتدقيق للتخلص من السفاسف التي تكتب في سياق نفسي ما، أو تحت ضغط مؤثرات ظرفية سواء تعلق الأمر بالأفكار أو بالرؤى والأساليب واللغة، أو بالموضوعات في حدّ ذاتها. هذا الكاتب عاش مفلسا في باريس بعد تخليه عن الولايات المتحدة، لكنه لم يتسرع لنشر رواياته بطلب من دور نشر مكرسة. كان يكتب ويمزق، كما كان يفعل مالك حداد في قسنطينة. كان هذا الأخير يلقي في سلة المهملات الأشعار التي يكتبها ليلا، ولولا ابن اخته الذي ظل يجمعها صباحا، كما حدثني في بيت الكاتب قبل سنين، لضاعت هالات كثيرة اعتبرها صاحبها تجارب فاشلة، مع أنها ذات قيمة كبرى، كما يدلّ على ذلك ديوانه الشقاء في خطر.
في السياق ذاته قلت مرة للطاهر وطار في حديث عن مؤلفاته: إن قصة “الحوت لا يأكل”، المضمنة في مجموعة “الشهداء يعودون هذا الأسبوع”، قصة مثيرة فنيا، وشاملة، لقد لخصت العقل العربي في صفحات معدودة، فأجابني: “لقد استغرقت مدة كتابتها قرابة عشرين سنة”، عندها فهمت سبب قوتها وعمقها. ذاك ما قام به غابريال غارسيا ماركيز عندما كتب رواية وقائع موت معلن، الحكاية التي يعرفها الجميع، أو كما فعل ليون تولستوي في الحرب والسلام التي استغرقت 12 سنة. عنصر الزمن مهمّ في التأليف والمراجعة قبل الدفع بالكتاب إلى المطبعة، بنوع من اليقين المرضي، أو بعدم التفكير في القارئ، أو بالاعتقاد أنه ساذج.
القراءة المتواصلة للآداب والثقافات تأتي قبل الكتابة كشرط قاعدي، ومن لم يقرأ قواعد اللغة والنصوص وحدود الأجناس الأدبية والتقنيات لن يكتب سوى ما هبّ ودبّ من سفاسف وخواطر وانطباعات ومواعظ يسميها قصة أو رواية عن جهل. يجب التذكير، بخصوص تعقيدات اللغة وأهميتها في التأليف، أنّ تيودور دوستويفسكي، الروائي الروسي الشهير، قال مرة وقد أربكه ضيق المعجم أمام اتساع الدلالات: “ما أفقر محرفنا اللغوي”، مع أنه كان ظاهرة لغوية وبلاغية مربكة. مشكلتنا الحالية لا تتمثل في انحسار الكلمة فحسب، بل في عدم القدرة على كتابة نص لا يخلو من مئات الأخطاء اللغوية والأسلوبية والنحوية والبنائية، دون الاشارة إلى علامات الوقف وعدم التمييز بين الكلمات، بين جلس وقعد، بين الأسد والليث والهمام.إننا أمام ظاهرة يمكن أن نطلق عليها: كراريس الأخطاء، من الغلاف إلى نقطة الخاتمة.
لقد أسهم الفاسبوك ووسائط التواصل في تقويض الذائقة وظهور رواية الراب، كما كان الطاهر وطار يسمي الأدب الاستعجالي في التسعينيات. بإمكاننا أيضا أن نتحدث عن كتابة الرّاي في ظل هذه الميوعة الكبيرة. كيف نروج مثلا لأصغر كاتبة في العالم؟ جزائرية في التاسعة من العمر تكتب قصصا ناضجة للأطفال؟ أليس هذا بهتانا يمحو المنطق وعلم النفس الأدبي والجانب التربوي برمته؟ لقد بلغ بعض الكتّاب المتخصصين في الكتابة للأطفال من العمر عتيا ولم ينضجوا بعد، وهم واعون بالمعضلة.
إنّ مطالبة النقد الأدبي، في حالات مماثلة، بمتابعة المشهد الابداعي، أمر تعجيزي لن يتحقق إلا بتنازل الناقد عن الأكاديميات، عن الصرامة المنهجية والمصطلحية والجهاز المفاهيمي لأنه يتعامل مع نصوص لا ضوابط لها، ومعنى ذلك أنه سيلجأ إلى تزكية كتابة ليست ذات قيمة. ما يتسبب، في ترقية الفشل والأخطاء الابداعية التي ستصبح موضوعا للدراسات والرسائل والأطاريح الجامعية في ظل هيمنة المناهج الواصفة التي لا تهتم سوى بتمفصلات المعنى، دون تقييم. هذه المناهج، على أهميتها الكبرى في تفكيك النصوص وفق آليات دقيقة، وخاصة السيمياء وعلم السرد والشكلانية، سمحت لهذه النصوص المفلسة بالتسرب إلى الدراسات وتبوأ مكانة لا تستحقها لأن هذه المقاربات لا تهتم بالأخطاء، قدر اهتمامها بالكيفيات الشكلية.
دور النشر ملزمة بالحد من انتشار كراريس الأخطاء التي تدمّر المشهد الأدبي، وذلك بالتعاون مع لجان القراءة وتسبيق الجودة على الأموال. لقد أصبح كلّ من هبّ ودبّ ينشر ويحاضر وينظّر ويجري حوارات سريالية في الجرائد التي لا مسؤولية لها، وليس من المستبعد أن يمثل هؤلاء البلد في المحافل الدولية، كما حدث مع أسماء ساعدتها العلاقات ونفاق الاعلام والأشخاص والنقاد لتكتسب شهرة، مع أنها مجرد مسوّدات رثة لا تصلح للقراءة.