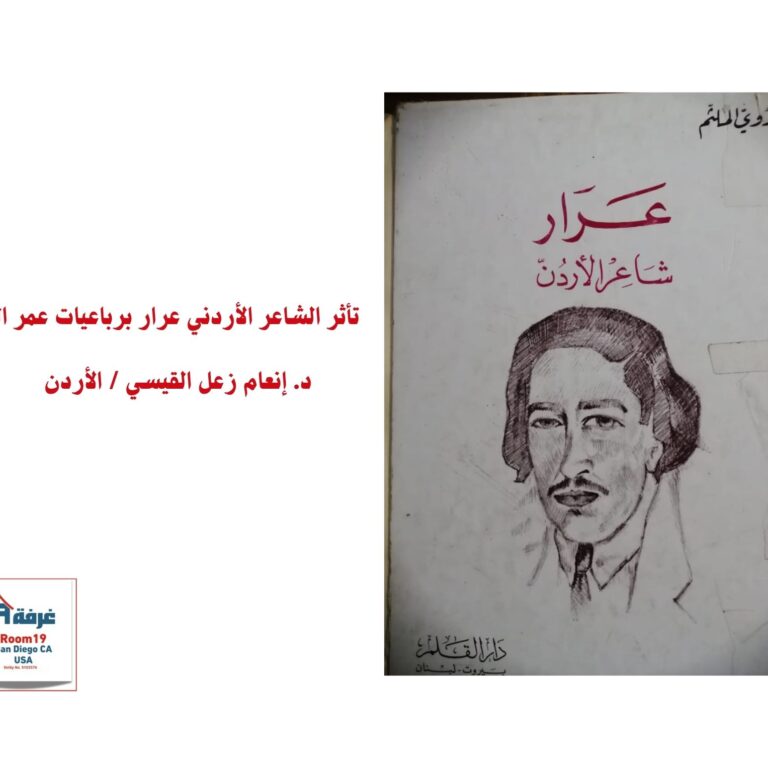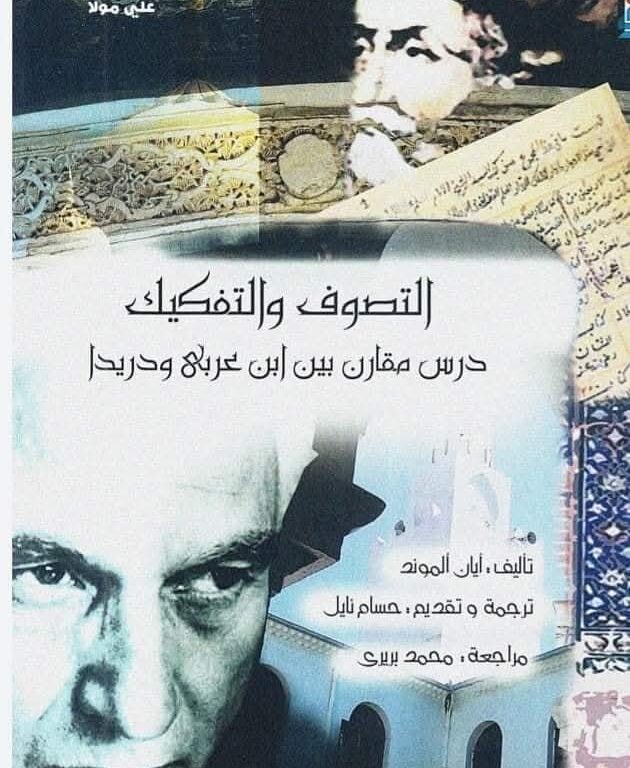طفلة الكرتونة
رولا بطرس سعد، مربية وكاتبة وإعلامية، تستحق منا التفاتة مميزة، خصوصًا إلى نضالها من أجل الحياة، هي التي خضعت لجراحات خطيرة، وقاومت بالابتسامة، ذاك المرض الخبيث، وما زالت تعد الحياة بسنوات مديدة.
مناسبة القول أنها أصدرت في أيار من العام 2019، رواية مبنية على ظاهرة التبني، عنوانها “طفلة الكرتونة”، تتناول قصة فتاة ناجحة، تعيش وسط والديها، حياة كريمة، وكانت على عتبة الزواج، إلى أن سمعت من جاراتها، مصادفة، أنها ليست ابنة والديها، إنما هي متبناة منهما… لكن حراك 17 تشرين الأول، لم يكتب لتلك الرواية أن تنتشر وتصبح مادة للنقاش، لما تضمنته من سرد متين وحبكة متراصة وأدلة وشواهد على مجال تتداخل فيه مشاعر الأمومة والرغبة في تكوين عائلة، و”التجارة” و”السمسرة” و”بيع الأولاد” والمياتم، والمستشفيات… والضمير الإنساني الغائب أحيانًا.

فأنا لم أعرفْ جرحًا، سعتْ إليه مائدةُ القلب، ليعتليَها مزهريَّةَ محبَّة وأمل… سوى جُرحِ رولا.
ولم أعرف جرحًا، كان يخشى على العيون دمعًا، فيُفيض عنها دمًا وألمًا، إلَّا جُرحَها.
ولم أعرف جرحًا، غيرَ جُرحِها، بينَه وبينَ الابتسامة تواطؤٌ مقدَّس، لم يَقُمْ يومًا إلَّا بين الخشَبةِ والمسمار… فصار مثلَه، جُرحَ قيامة.
فاذكر يا قلمي، أنَّك من هذا الجرح بدأت أملًا، وإليه، تعود.
أعودُ، وقلمي… بعدما أسكرنا الفرح المنبثق من جراح. فما سمحتُ لها، سَنَتَذاك، أي عام 2011، بأن تسألَ “من أنا”، عنوان كتابها الثاني؟ لأنَّنا كنا، من ثمَّ، على موعد غجريٍّ، في عرسٍ فَضح ألوانها جميعًا، إذ تواطأتِ الشَّمسُ مع الحبر، فاختصرت على ورق الكتاب، قصائدَ من انبعاثٍ وجيعٍ وجيع، ملأ الدُّنيا قيامة.
وما أجمل تلك الألوان؟ قل الأحمرَ… إشراقًا وثورةً في النَّفس.
وأيُّ أحمر؟

فستانٌ كان بطلَ رواية، كأنِّي بها طوت صفحةَ الجراح، بابتسامتِها المُشرعة على الغد، لتتحدَّى الحياة، باغتصابِها الدَّائمِ للفرح، وتنسجَ حكايةً من واقع متخيَّل، أو تخيُّل واقعيٍّ، بترميز آسرٍ… لم نكنه سره، إلَّا في ما بعد. روت ثمَّ خبَّأتِ الحكاية في عبِّها، وهي بعدُ بعدُ في عزِّ صبًا، ولكن في عزِّ ألم.
وأيُّ أحمر بعد؟ خطٌّ… حاكت أوَّلَه ممَّا علَّمها إيَّاه الوجع، بإضاءة على جراحات مجتمع، بعضها مرذولٌ، وبعضها الآخرُ ممقوت، وبعضها الثَّالث واقعٌ نُشيحُ بنظرنا عنه، لكنَّه واقعٌ، قد يكون مرضًا… فلنكن مثلَ من قال: كنت مريضًا فعدتموني… فلنَعُدْه معها، ولو بأسطرِ رواية.
والآن أعود إلى “طفلة الكرتونة”… آخر إصدارات هذه “الغجريَّة” المزركشة بالفرح، وهو لقب أضفي عليها بعد كتابها الثاني “عرس غجرية”، الصادر عام 2012. رواية هي الثَّالثة لها، بعدما خلعت عنها عباءة بوح وجدانيٍّ أليم، لترتديَ قضايا النَّاس، تحمِل عنهم أوجاعَهم، وتعرُضَها بقلم عالي الصَّوت، وبقِيَميَّة وأخلاق ندَرَت، هذه الأيام، علَّ عقلًا ما يستجيب، أو قلبًا يرأف، أو ضميرًا توقظه وخزة، وعلَّ إنسانًا يكون إنسانًا.
فضلًا عن ذلك، تخصص رولا إطلالاتها الإعلامية، عبر إحدى محطات التلفزة، في أكثر من برنامج “تعا ننسى”، و”سألوني الناس”… لهذه القضايا الإنسانية، باستضافة من خبروا الحياة، في مجالات الفن والأدب والسياسة والطب والعلم والمسرح… وجسدوا فيها إنسانيتهم.
إقرأوا وتوجَّعوا… ولكن إقرأوا قبلُ الإنسانَ في داخل رولا، واقرأوا القيم، والأخلاق، وهجئوها خلقًا خلقًا.
موضوع “طفلة الكرتونة”، أي التبنِّي، أيًّا تكن النَّظرة إليه، يجعلني وسْطَ ما كانت عليه المجتمعات قديمًا حين رذلتِ المرأة العقيمة، أو ما آل إليه بعض الحاضر، كأن يتبنَّى زوجان ذكران، أو زوجان أنثيان، طفلًا… وما بينهما من نظريَّات وسلوكيَّات، يجعلني أسأل: أما كان للإنسان، بصفة كونه إنسانًا قبل أي أمر آخر، أي اعتبار؟ ويجعلني أسأل أكثر: مَن الأهم صاحب النُّطفة وحاملة البويضة، أم مَن نتج من فعل التلقيح، أي المولود حين يُرمى، لسبب أو آخر، على قارعةِ طريق، أو على عتبةِ ميتم أو دير… عاريًا أو مقمَّطًا، ويوضع في كرتونة؟

طفلة الكرتونة، رواية أيقظت فيَّ، مذذاك، هذا السُّؤال، وشدَّتني إلى حالات أعرفها عن كثب، وأحيا قلقًا ينتاب أهلَ متبنًّى، أحياه معهم، مخافةَ يُفتضح الأمر… وليُفتضح. ألا يعود ساعتذاك، المتبنَّى إنسانًا؟ بلى، فقد وُلد إنسانًا، ويبقى ويموت إنسانًا، ودعك من مجتمع، لا همَّ له سوى لوك الكلام، والنَّميمة والشَّماتة والحقد والتَّشفِّي والتعيير والتنمُّر… وتلك الابتسامة الخبيثة التي تعلو وجوهًا صفرًا وقلوبًا سودًا.
وما بالك أنَّ هذا يحدث في بيئة مسيحيَّة (بيئة الرواية)، تعرف، إذا كانت تقرأ الإنجيل أو تفهمه، أنَّ المسيح كلَّم السَّامريَّة، ولمس الأبرص، وأدخل اللِّصَّ بيت أبيه السَّماويِّ، وهو يمسك بيده، وجاء من أجل الخطأة والمعذَّبين… والمتبنَّى، في كل ما سبق، ليس أيًّا من هؤلاء… ذنبه أنَّه ولد ورمي، معذَّبًا، وثمة من رفع عنه هذا العذاب، ووفَّر له حضنًا دافئًا وكنفًا عائليًّا، وكيفما نظرت إليه، ليس سوى إنسان.
موضوع “طفلة الكرتونة” دفعني إلى أن أصدِّق، لوهلة، ما قاله نيتشه في كتابه “نقيض المسيح”. قال: “كلمة المسيحيَّة بالذَّات هي سوء فهم، في الحقيقة، كان هناك مسيحي واحد فقط، ومات على الصَّليب”.
فلا نجعلنَّ المسيح… المسيحيَّ الوحيد الَّذي مات منذ أكثر من “ألفي سنه، ولم تزهِّرْ من حدائق روحه في الأرض حتى سوسنه”، على ما كتب جوزف حرب.
مؤلمة هذه النِّهاية، مثلما هي موجعة رواية رولا بطرس سعد، التي لن أفصح عن مضمونها وسياقها أكثر، فأفسد على القراء مُتعة قراءتها.
موجعة لأهلٍ افتُضح أمرُ تبنِّيهم، موجعة للمتبنَّى، موجعة بالحقيقة التي تضيع بين سجل ميتم، وطمع سمسار ومحدوديَّة جمعية ووحشية عصابة، ووالدين حقيقيين لم يباليا بما أنجبا. موجعة أيضًا للمسيح، كأنَّها دمعته.
إقرأوا وتوجَّعوا… ولكن إقرأوا قبلُ الإنسانَ في داخل رولا، واقرأوا القيم، والأخلاق، وهجئوها خلقًا خلقًا. واقرأوا رشاقة أسلوبٍ أين منها رشاقة مشيتها، وانسيابيَّة عبارة، أين منها انسيابيَّة رولا أينما حضرت وحلَّت، واقرأوا إنسانيَّة صارخة، هي رولا جميعُها المبتدأُ المرفوع بالفرح الظَّاهر على محياه، والجاري نهرًا في أوردة الحبر.
“طفلة الكرتونة”، أغنية رولا بطرس سعد المتفلِّتة من أيِّ مقام، ورقصتها المذبوحة من الألم، وخبريتها التي خبأَتْها جدَّتُها في عبِّها، وهي صغيرة، وجاءت ترويها، كبيرةً، لمجتمعاتٍ وضمائرَ وإنسانيَّة.