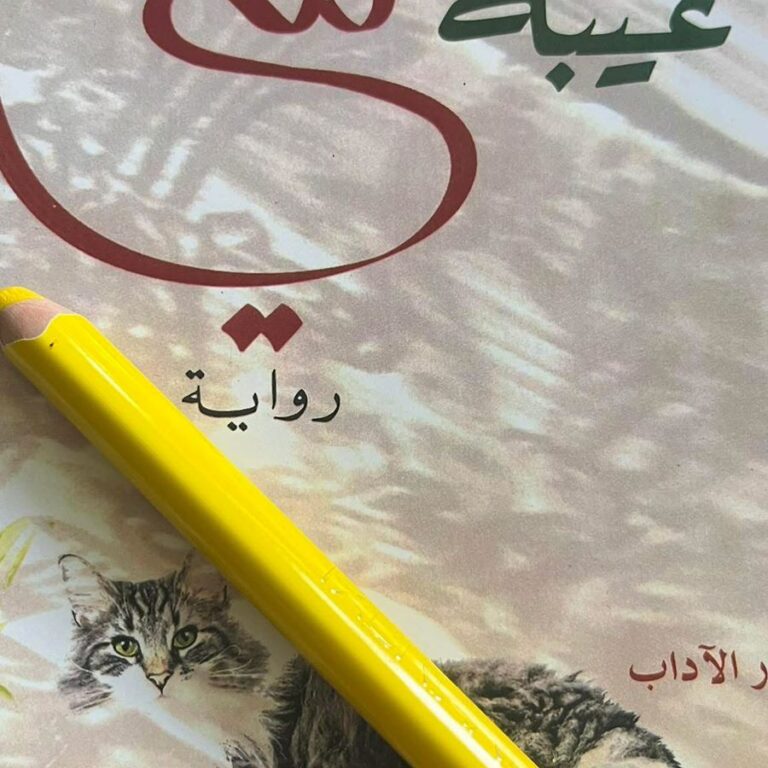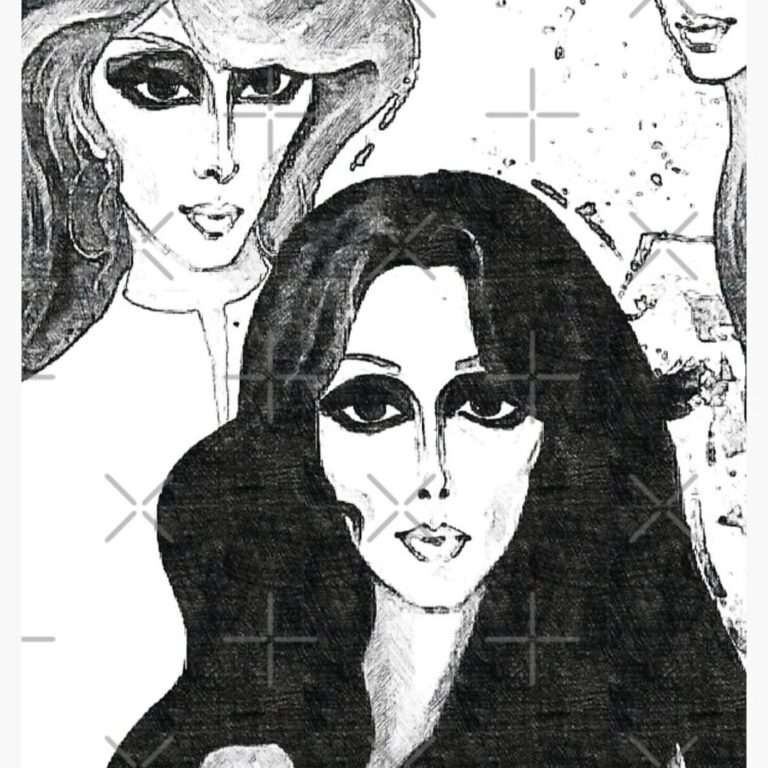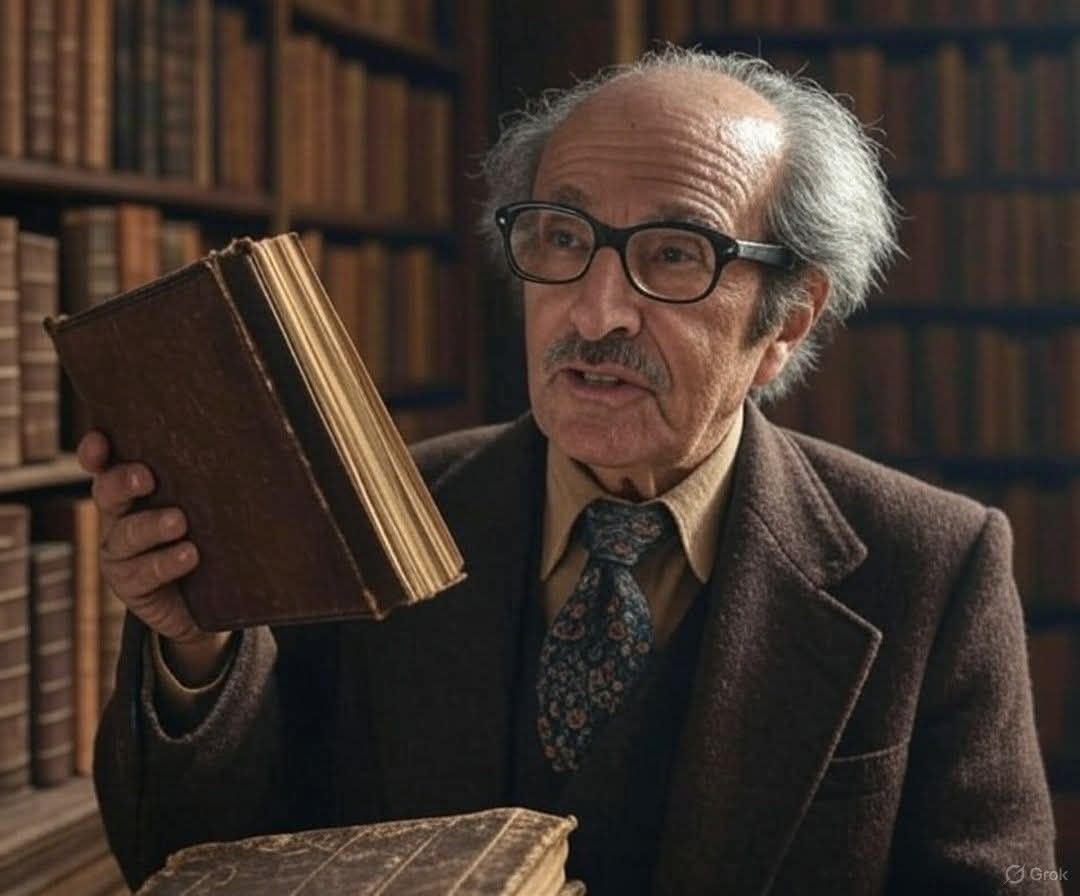
كتاب "سبعون" للشاعر الأديب اللبناني ميخائيل نعيمة: عرض مفصل ونقاش مع الاستشهاد بنصوص
كتاب “سبعون: حكاية عمر” للأديب اللبناني ميخائيل نعيمة (1889-1988) هو سيرة ذاتية شاملة تُعد من أبرز الأعمال في الأدب العربي الحديث. صدر الكتاب عن دار نوفل في بيروت في ثلاثة أجزاء، يمتد على 1248 صفحة، ويغطي سبعين عامًا من حياة نعيمة منذ ولادته عام 1889 وحتى عام 1959، ظنًا منه أن السبعين ستكون نهاية عمره، لكنه عاش حتى التاسعة والتسعين. يُعتبر الكتاب رحلة إنسانية وأدبية وفكرية تجمع بين السيرة الشخصية والتاريخ الاجتماعي والثقافي للبنان والمهجر، ويتميز بأسلوب أدبي راقٍ يمزج البساطة بالعمق والشاعرية.
عرض مفصل لمحتوى الكتاب
ينقسم الكتاب إلى ثلاث مراحل أساسية، كل مرحلة تتناول فترة زمنية محددة من حياة نعيمة:
المرحلة الأولى (1889-1911): من الطفولة إلى نهاية الدراسة في روسيا
تبدأ هذه المرحلة في قرية بسكنتا اللبنانية بجبل صنين، حيث يصف نعيمة طفولته في بيئة ريفية بسيطة. يتحدث عن بيتهم المتواضع، وهو كوخ مكون من غرفة مستطيلة قضى فيها أول 13 سنة من حياته، وعلاقته العميقة بالطبيعة المحيطة: الأشجار البرية، الوديان، البساتين، وأصوات العصافير وقطعان الغنم. يقول نعيمة في وصف الشخروب: “هذه الصورة التي رسمتها لك عن الشخروب قد تعطيك فكرة عن تكوينه الجغرافي. ولكنها صورة ممسوخة ومشوهة إذا أنت لم تسعفني بخيالك على استكمال ألوانها التي تستعصي على أي ريشة، ومعانيها التي هي أعمق من أن يغوص عليها أي قلم”…
يتناول ذكريات طفولته الأولى، مثل أول مرة رأى فيها نفسه في المرآة، وأول مرة أعطته والدته خمسة قروش تركية ليشتري “قضامي” من البائع. كما يصف تجربته في المدرسة الروسية في الناصرة، حيث أظهر تفوقًا أهّله للسفر إلى روسيا لمتابعة دراسته في بولتافيا الأوكرانية (1906-1911). هناك تعمق في الأدب الروسي، مما ساهم في صقل موهبته الأدبية.
يبرز في هذه المرحلة الحديث عن الهجرة، وهي ظاهرة كانت شائعة في لبنان خلال تلك الفترة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة. يروي قصة هجرة والده إلى أمريكا بدافع من والدته التي رأت في الهجرة أملًا لتحسين الأوضاع، لكنه عاد بعد ست سنوات دون أن يحقق ما كان يطمح إليه: “الناس ما هجروا أوطانهم إلا حملوا معهم إلى مهجرهم جميع أحقادهم وخلافاتهم وضغائنهم وترهاتهم السياسية والطائفية”.
المرحلة الثانية (1911-1932): الهجرة إلى أمريكا والعودة إلى لبنان
تنتقل السيرة إلى الولايات المتحدة، حيث هاجر نعيمة مع أخيه الأكبر وزوجته. يصف هذه الفترة بأنها مليئة بألم الغربة والبحث عن الذات. درس الحقوق هناك وحصل على الجنسية الأمريكية، لكنه وجد عزاءه في الكتب والكتابة: “أما سلواي الكبرى فكنتُ أجدها في معاشرة الكتب ومعاشرة قلمي، فقد أقبلتُ على مطالعة الشوامخ في الأدب الإنجليزي بمثل الشراهةِ التي أقبلتُ على مطالعة الأدب الروسي”..
انضم نعيمة إلى الرابطة القلمية التي أسسها أدباء المهجر، وكان نائبًا لجبران خليل جبران. بدأت أعماله الأدبية تنتشر في مجلات مثل “الفنون” و”السائح”. ينقل لنا معاناة المهاجرين اللبنانيين والسوريين في نيويورك، وكيف أن الخلافات الطائفية والسياسية أثرت على اندماجهم.
يتناول نعيمة الحرب العالمية الأولى وتداعياتها على لبنان، واصفًا إياها بـ”النار التي شملت العالم” و”المجزرة العالمية”، ويتحدث عن نكبة الجراد التي أدت إلى الجوع والفقر في جبل لبنان.
المرحلة الثالثة (1932-1959): العودة إلى لبنان وبلوغ السبعين
بعد عشرين عامًا في أمريكا، عاد نعيمة إلى لبنان عام 1932، ليعيش حياة الناسك في الشخروب، حيث لُقب بـ”ناسك الشخروب”. لم يتزوج، معتبرًا الأدب بديلًا عن الزواج ومؤلفاته بمثابة أبنائه: “تبيّن لي من علاقاتي مع النساء أنّني لم أولد لأكون بعلًا لامرأة وأبًا لعددٍ من البناتِ والبنين”..
في هذه المرحلة، يركز نعيمة على أفكاره الفلسفية، مثل وحدة الوجود والتقمص، ويعبر عن قيمه الإنسانية. يقول: “الفرح ليس وقفًا على الأغنياء، والكدر ليس منحصرًا في الفقراء. إنّهما في الفكر والقلب أوّلًا”..
يتحدث عن رسالة الأديب، مؤكدًا أهمية الكلمة: “سلاحنا هو الإيمان بقدسيّة الكلمة، وتنزيهها عن التبذّل والتدجيل والتمرّغ على أقدام الأصنام، وتكريسها لخدمة الحقّ والعدل والذوق الرفيع”..
نقاش وتحليل الكتاب
الأسلوب الأدبي واللغة
يتميز أسلوب نعيمة بالبساطة والعمق، مع لمسة شاعرية تجعل القارئ يشعر بالراحة والانجذاب. لغته ساحرة، كما يصفها أحد القراء: “لغته في الكتابة ساحرة عبقة بلذعة شعرية حلوة”..
يعتمد نعيمة على النثر الشعري، خاصة عند وصف الطبيعة أو المشاعر العميقة، كما في قوله عن الحب: “أيّها الحبّ! أنت البداية التي منها كلّ بداية، والنهاية التي إليها كلّ نهاية. بك تتماسَك الأقمار والشموس والمجرّات، وحولك تدور”..
نعيمة يبرز عالمه الداخلي بصدق، لكنه يحذر القارئ من أن السيرة لا يمكن أن تكون كاملة: “إنّك خادع ومخدوع كلّما حاولت أن تحكي لنفسك أو للناس حكاية ساعة واحدة من ساعات عمرك. لأنّك لن تحكي منها إلا بعض بعضها”..
الصدق والمبالغة
يلتزم نعيمة بالصدق في روايته، لكن بعض النقاد، مثل الدكتورة فوزية الصفار الزاوق، يرون أن هناك مبالغة في تصوير ذاته: “عرض من نفسه صورة مشرقة عادة، وكأنه صورة لا أروع منها، ولا أنقى”..
هذه المبالغة قد تثير تساؤلات القارئ حول الغاية الحقيقية من الكتاب: هل هو توثيق لحياته أم دفاع عن نفسه وتضخيم لمآثره؟
القيم الفكرية والإنسانية
يعكس الكتاب فلسفة نعيمة في الحياة، مثل إيمانه بوحدة الوجود والتقمص، ورفضه للزواج ظنًا أنه “مقبرة للمشاعر”. كما يظهر وعيه الاجتماعي من خلال نقده للفوارق الطبقية: “إن عقدًا واحدًا فيها، أو سوارًا، أو قرطًا، أو خاتمًا قد يطعم ألف جائع، أو يكسو ألف عريان، أو يبتاع الدواء لألف مريض”
يبرز نعيمة دور الأديب كمرشد للمجتمع، مؤكدًا أن الكلمة سلاح للخير والهداية.
البعد التاريخي والاجتماعي
لا يقتصر الكتاب على حياة نعيمة الشخصية، بل يوثق لمرحلة تاريخية مهمة في لبنان والمهجر. يتحدث عن ظروف الهجرة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، والتحديات التي واجهها اللبنانيون خلال الحرب العالمية الأولى ونكبة الجراد. كما يسلط الضوء على الحياة الاجتماعية في لبنان الريفي، من خلال وصف العادات والتقاليد والطقوس الدينية.
التقييم العام
كتاب “سبعون” ليس مجرد سيرة ذاتية، بل هو وثيقة إنسانية وأدبية تعكس تجربة شخصية وجماعية في آن واحد. يتميز بأسلوبه الأدبي الرفيع وقدرته على الجمع بين الذاتي والموضوعي، لكنه لا يخلو من بعض الانتقادات، خاصة فيما يتعلق بالمبالغة في تصوير الذات. مع ذلك، يبقى الكتاب مرجعًا لا غنى عنه لفهم تاريخ لبنان والمهجر، وتجربة أديب عظيم ساهم في النهضة الأدبية العربية الحديثة.
المصدر: الأكاديميون اللبنانيون