
بقلم: عماد عواودة
من بين الأصوات الشعرية التي جمعت بين التجربة الإنسانية العميقة والرصانة الفكرية، يبرز اسم الشاعر والدبلوماسي الأردني إبراهيم عواودة ، ابن بلدة قميم في شمال الأردن ، ومن مواليد مدينة القدس عام ١٩٥٨م ، رجل عاش الحياة بوجه دبلوماسي مضيء ، وأمسك يراعته ليكتب مشاعره بوجه إنساني مرهف ، يقيم اليوم في جنوب أفريقيا بعد حياة زاخرة في وزارة الخارجية الأردنية ، تدرّج خلالها حتى بلغ مرتبة السفير المفوّض . عاد السفير الشاعر الذي جاب الكثير من العواصم والمدن ليسجل حياته في قصائد خطها على الورق في عدة دواوين شعرية ، فكان ديوان « قلبٌ على ورق ، ١٩٨٥ » ، وديوان « روحٌ حائرة ، ٢٠٠٧ » ، وديوان « وردةُ قلب ، ٢٠٢٣ » ، وله عدة قصائد غير منشورة ، انطلق الشَّاعر « العواودة » من قريتة الأُولى « قميم » ، لا بوصفها مكانًا جغرافيًّا ، بل بوصفها المهدَ الذي يبدأ منه الكائن رحلته نحو الوعي ، وتنقل في أسفار كثيرة في بقاع الأرض فتكونت لديه التجربة والخبرة ، وتحدث بعدة لغات غير لغته الأُم ، مثل الإنجليزية والفرنسية ، والإسبانية ، مما مكَّنه من قراءة الأدب العالمي بلغته الأَصلية ..
بين أَيدينا في هذا المقال قصيدة يعود تاريخها إلى عام ٢٠٠٧ ، يخاطب فيها الشَّاعر حفيده باسلوب شاعري ناعم ، وموسيقى شعرية هادئة ، قصيدة « من جدٍّ لحفيده » جاءت لا لتكون خطابًا عائليًّا عابرًا ، بل تأمّلٌ عميق في الوعي الوجودي للحياة الإنسانية ، فهو يتسلسل من الطفولة حتى الشيخوخة ، من الوهج إلى الذبول ، ومن الألق إلى الرضا ، فيبدأ الشاعر خطابه بهمس رقيق بمرآة الزمن :
« كما الآنَ أنتَ ، أنا كنتُ يومًا
صغيرًا ، ضعيفًا ، رقيقًا ، طريًّا ..»
في هذا المطلع نغمةُ كشفٍ إنساني بطابع وجودي فلسفي حياتي ، فالعبارة لا تقول ؛ « كنتُ طفلًا » ، بل « كنتُ كما أنتَ الآن » ، وكأن الشاعر يبرز العلاقة التي تكاد تُلغي المسافة بين الجيل والجيل ، أو أنه يصنع مواجهة بين الحاضر والماضي في جملة واحدة مضمونها الزمن ، وكأنّ الإنسان كائنٌ متعدّد الطبقات ، يحمل داخله كلّ أعمارِه السابقة بأرشيف زمني موحد ، يلتقي الجدُّ مع حفيده عند نقطةٍ واحدة هي الوجود الحياتي ، فالطفولة في نظر الشاعر ليست مرحلة عمرية بل حالة من الكينونة الإنسانية تتكرّر مع الأجيال . ثم تبدأ القصيدة مسارها المتدرّج عبر مراحل العمر وتزداد معها الموسيقى الشّعرية ايقاعا متناغما :
« ستكبرُ يومًا فيومًا ، وتغدو
غلامًا فتيًّا ، فشابًّا قويًّا
فكهلًا رشيدًا ، فشيخًا حكيمًا
يُنَكَّسُ في الخلق شيئًا فشيَّا .. »
هذا ما يمكن تسميته بـ نظرية الكمال والنقصان ، فالعمر ليس خطًّا صاعدًا على الدوام ، أو نحو الكمال ، بل منحنى يتجه إلى ذروة معينة ليعود بالإنحدار نحو العجز والضعف
وهذا المشهد يُذكّر ، باب التشابه الجوهري ، ما دوّنه الشاعر الإغريقي ميلياغروس على نصبه الجنائزي المنقوش في مدينة أم قيس الأثرية في الأردن : « أيها المارّ من هنا… كما أنتَ الآن كنتُ أنا ، وكما أنا الآن ستكونُ أنت ، فتمتّع إذن بالحياة لأنك فانٍ ».
لا يخفى على السفير الشاعر إبراهيم عواودة هذا الوعي الفلسفي القديم ليعيد صياغته بالعربية في الزمن الحاضر ، غير أنّ الفرق الجوهري بين القولين هو أن ميلياغروس ينطق من عزلة الموت ، بينما « العواودة » ينطق من دفء الحياة ، فالأول يخاطب المارَّ من جانب القبر ، أما الثاني فيُخاطب الحفيدَ في لحظة وجدانية تضج بالحياة والشاعرية . ويستمر الشاعر بقصيدته على نفس السلم الموسيقي فـ يقول :
« لتُمسي مثلي عجوزًا ضعيفًا
تُحاكي يداكَ ذبولَ يديَّا
فتنهضُ يومًا ، وترقدُ شهرًا
وتذكرُ حينًا ، وتنسى مليًّا .. »
الشاعر العواودة يعيد ترتيب الأدوار العمرية ، فهو لا يرسم مشهد الشيخوخة بوصفه انحدارًا جسديًّا ، بل هو تحوّلٌ روحيٌّ نحو الحكمة والصفاء ، إنه الضعف الذي يفضي إلى البصيرة الثاقبة ، والنسيان الذي يمنح الأشياء معنى ما ، والزمن عند الشاعر ليس خطًّا مستقيما إنما هي دورة الحياة ، يعود فيها الإنسان إلى بدايته وتتوالى فيه الأجيال : طفولة وكهولة والشيخوخة ، وبذلك تتعرّى الروح الإنسانية من زخارفها وتبقى الحقيقة .« وتُمْسي حياتُكَ خَلْفَكَ طَيْفاً
تسَرَّبَ بين الشقوق قَصِيَّا
فتأسى على كلّ يومٍ مَضَى
تركت شُجُونَكَ تَطويهِ طَيَّا ..»
الحياة تظهر كـ طيفٍ ، وتتسرب من بين الشقوق راحلة ، وكأنها الرمل الناعم ينساب من خلال ساعة رملية ، إذن هي خيال يتلاشى كلَّ ما مر عليه الزمن ، والإنسان يتأسى ويتحسر على ما فات من عمره سدى ، وتصوير بان الأيام تطوى بما تحمله من شجن . تتبدّل نغمة القصيدة في المقطع التالي ، فـ يرتفع صوت الحكمة فوق صوت الحنين ويتحول الشاعر من الجَدِّ إلى الرجل الحكيم ، وينتقل من الخطاب الخاص إلى الخطاب العام ، ومن حفيده الخاص إلى كينونة الإنسانية :
« عشِ العُمْرَ ما استطعتَ يا ولدي
إليه سبيلًا … نديًّا شذيًّا
فما خلق اللهُ هذه الحياةَ
لتعبرَها حائرًا وشقيًّا .. »
القصيدة هنا لم تعد عن الجدّ والحفيد ، بل عن معنى أن تكون انسانا حيًّا ، إنها دعوة إلى العيش الجمالي بالحياة ، أن تعيشها نديّةً وشذيّةً ، لا أن تعيشها عبورًا نحو الفناء ، بل تفاعلا شاعريا بقدر المستطاع ضمن الوجود الذي وهبه الله للإنسان . وينهي الشاعر العواودة حين يبلغ النص ذروته فيقول :
« ولا تنسَ يومًا نصيبك منها
وأحسن لغيرك ما دمتَ حيًّا
تعِشْ هانئًا ما رُزقتَ الحياةَ
وترجعْ إلى حيثُ جئتَ رضيًّا .. »
هنا تكمن ما يمكن تسميته بـ فلسفة الروح في شعر إبراهيم عواودة ، فالموت عند العواودة ليس نقيض الحياة بل امتدادها الطبيعي ، والرجوع إلى « حيث جئتَ » ليس انطفاءً بل اكتمال دورة حياة ، وكأن هذا المعنى يتكئ على الآية القرآنية : « كما بدأنا أول خلقٍ نعيده » ، إنها حلقة الحياة الوجودية ما ان تخبو وتنتهي حتى تعود في جيل جديد ، حياة يعيشها الإنسان في كل ولادةٍ وفي كل موتٍ صغيرٍ داخل حياته اليومية. إبراهيم عواودة في هذه القصيدة لا يكتب شعراً تعليميًّا ، ولا حكمة عابرة ، بل يكتب سيرة الكائن الإنساني في لغة شعرية ، يكتبها بلغةٍ عربيةٍ صافية ، متينة التكوين ، لا تتزخرف بل تنحت صور بيانية ، وما يميز القصيدة أنّها تحافظ على الإيقاع الشعري التقليدي ، وتزرع فيه روحًا حديثة تجعل القارئ يشعر بأن هذا الكلام قيل اليوم ، ولا يتكئ عل موروث الأَمس . لقد تجاوز الشاعر الشكل إلى الجوهر وعمق المعنى ليغدو شعره من ضروب الحكمة ، وجعل من الخطاب الشعري من الجدّي وسيلةً لإعادة ترتيب علاقتنا بالزمن وكيف نكبر ، إنّها قصيدة فيها من العمق الفلسفي أكثر مما تُتلى في صالونات الشعر ، لأنها ببساطة عن الإنسان في مختلف مراحله العمرية ، وهو الكائن الذي يعرف أنه فانٍ ، ومع ذلك يحب الحياة . تكمن عظمة النص ؛ أنه ينقلنا من المألوف إلى الحالة الوجودية ، من الموروث وتراكماته إلى التجربة وغربلتها ، من الخوف من الموت إلى قبول الحياة بما فيها من فناء ،ولعلّ هذا ما يجعل قصيدة « من جدٍّ لحفيده » واحدة من القصائد النادرة التي تُنصت إلى حكمة القدماء ، ثم تعيد صياغتها بلسان الحاضر ، بمنطق المؤمن الراضي ، فتجمع ثقافة اليونان والحداثة العربية في بوتقة شعورية واحدة .
( عماد عواودة ، ابو حازم
الجمعة ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٥ ، قميم / الأردن )

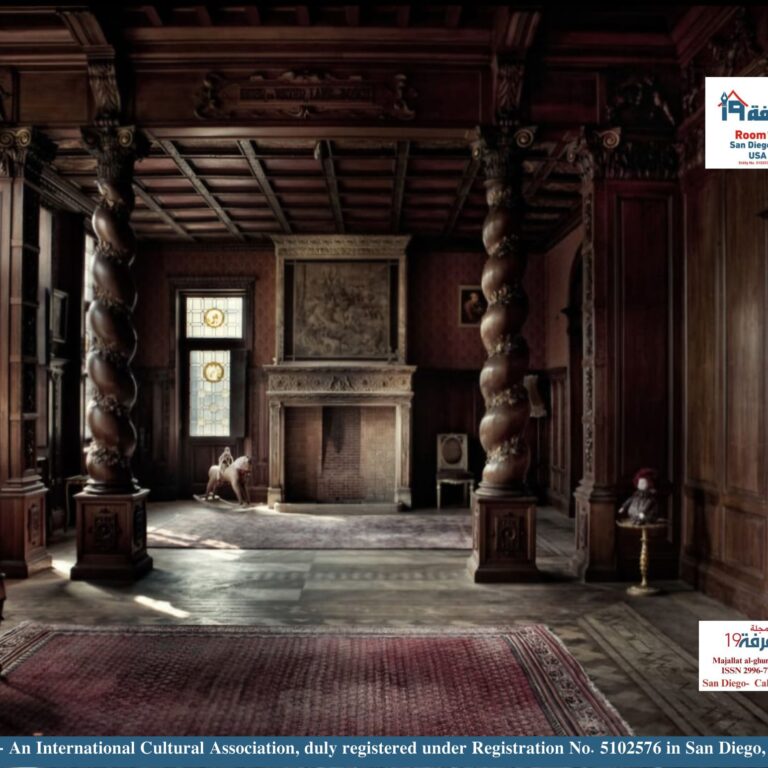



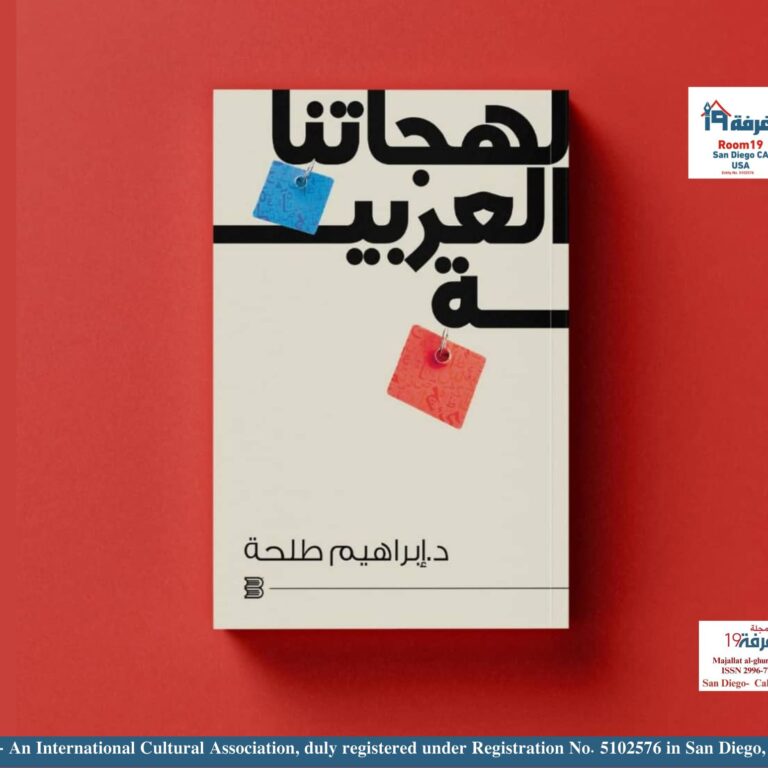
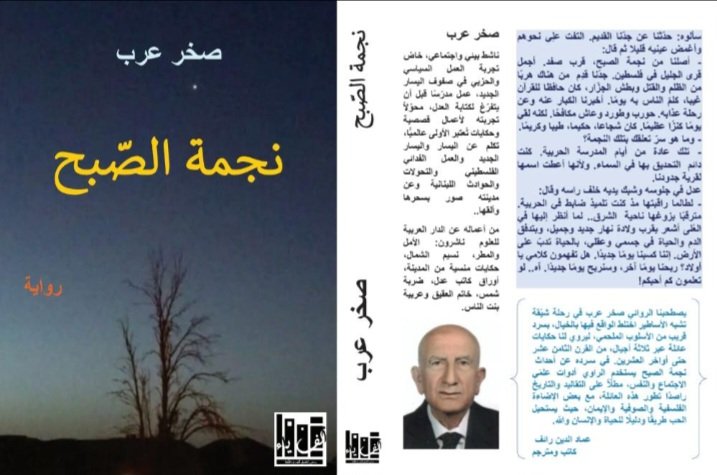
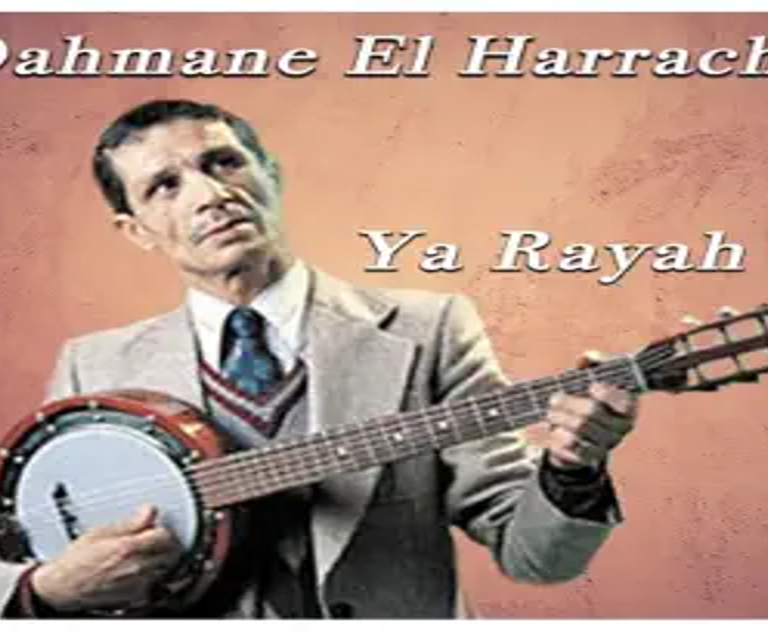
أحسنت أستاذ عماد. شكرا لك على هذه القراءة الجميلة والعميقة للقصيدة. يسعدني أن القصيدة قد راقت لك فخصصت لها هذا الجهد والوقت. بارك الله فيك وأدام عطاءك الثقافي والأدبي. مع المودة والتقدير