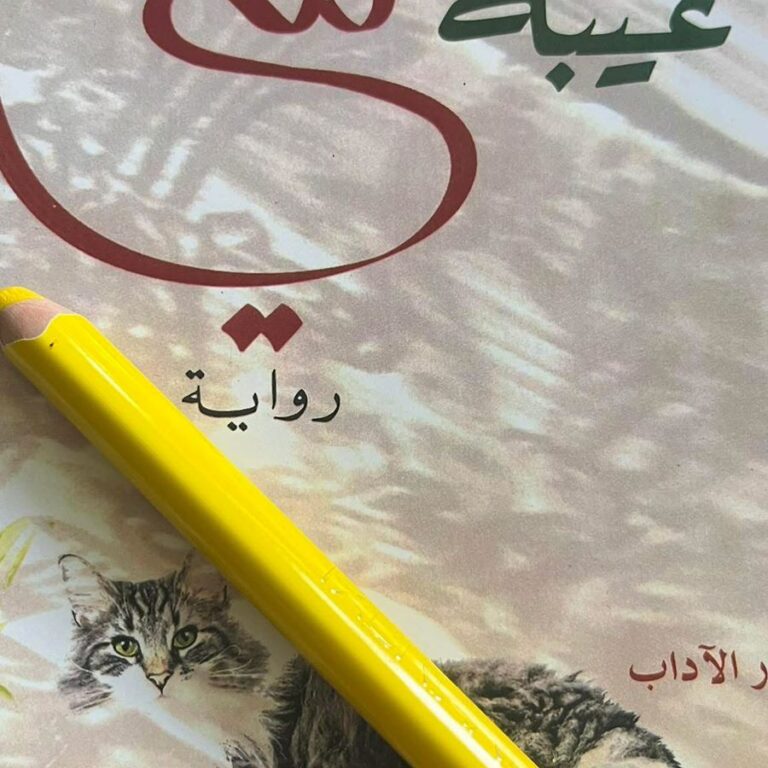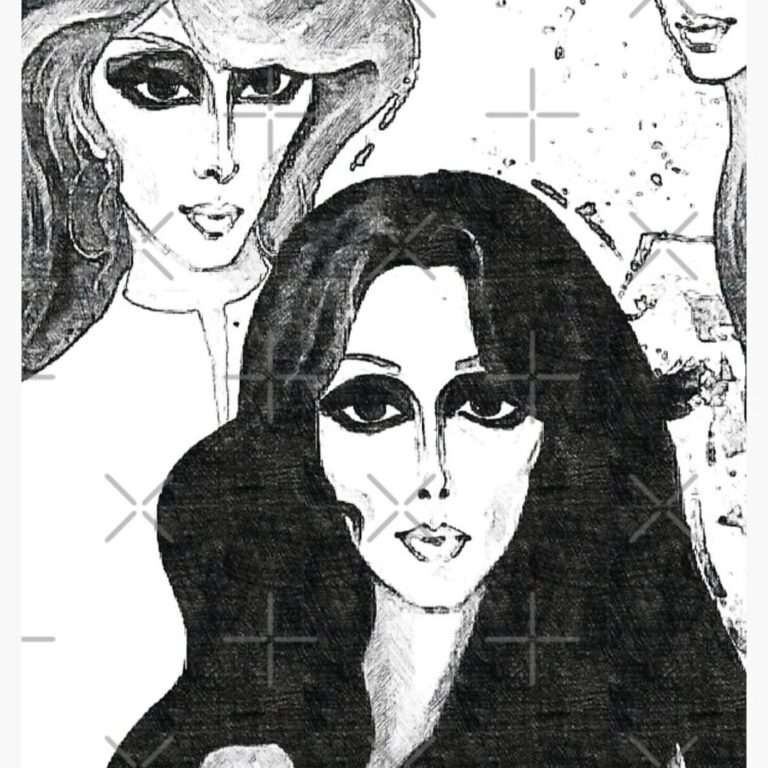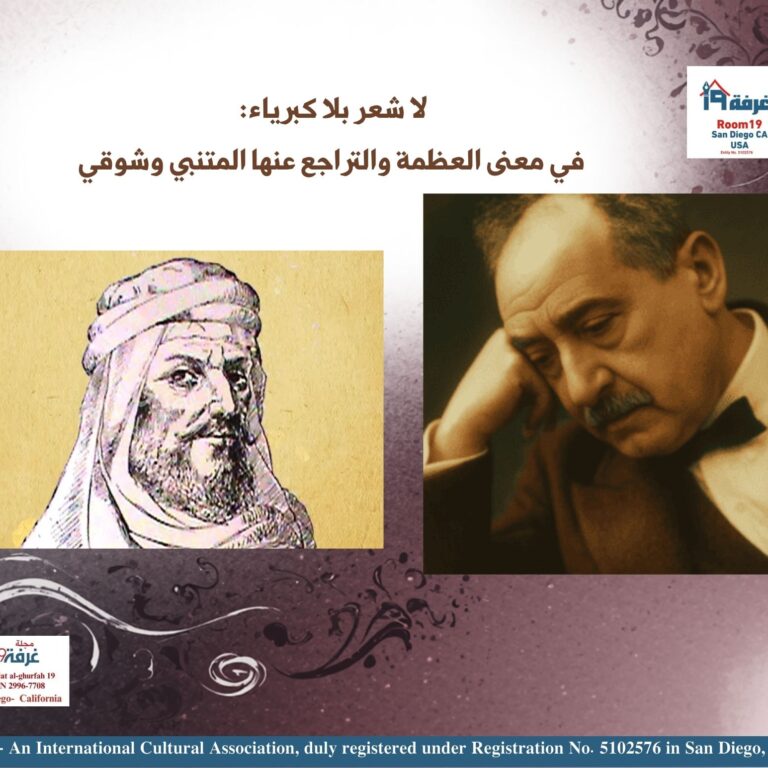الكاتب قصي البسطامي

أكملت هذا الكتاب بعنوان التصوف والتفكيك: أطروحة مقارنة بين الشيخ الأكبر ابن عربي ودريدا يوضّح الكتاب ـ رغم القلق الفلسفي في المقارنة الواضحة بين دريدا وابن عربي فيما يخص الإبستمولوجيا الإلهية وأنطولوجيتها ـ مدى قربها من استراتيجيات التفكيك لدى دريدا، إذ يمثل كل منهما اتجاها معاكسا للآخر. وهذا الانعكاس يقتضي فهماً مستقلاً لكل منهما للنصّ.
فابن عربي يرى أن النص محمول بمعان ومقاصد ودلالات كثيرة متناقضة، يمثّل كل معنى فيها استقلاليته عن الآخر. بينما يرى دريدا أن النص لا يحمل في داخله أي معنى أو دلالة خاصة، وأن فصل النص من مكانه يفرغه ويعيده إلى درجة الصفر؛ فلا يحمل النص أي دلالة أو معنى إلا ظاهره، فيصبح نصاً فينومينولوجياً ظاهريا..
يبدأ الكتاب بطرح الفصل الأول حول الاعتراض الصوفي–التفكيكي على الفكر العقلاني، إذ يقول الكاتب أن هناك مصطلحات صوفية مشتركة بينهما مثل: الحرية، والانفتاح، والتنفس، والنَّفس. كما يتفقان على الطعن في الميتافيزيقا، إذ إن اللاهوت الغربي لم يضع أي إشكالية في فهم المعنى، ولم يتقبّل أن العلامات تُفضي إلى معان متعددة. كذلك في مشروع التحرر عند كليهما، لم يُعتبر النص قابلاً للتحكّم، ولا أن ميتافيزيقا العقل هي المسيطرة عليه.
وفي كتاب ابن عربي الفتوحات المكية يشير الشيخ الأكبر إلى أن كلمة عقل (reason) ترجع إلى الجذر اللغوي نفسه “عقال” (fetier). وهذا التتبّع التاريخي للفظ يناسب غرضه في الاعتراض على الفلاسفة واللاهوتيين، الذين يحدّون الاتساع الإلهي ويضيّقونه. وهذا التتبّع اللغوي هو ذاته منهج دريدا في البحث عن جذور الألفاظ.
وفي استحالة الحق، وتنازل الحلول والعلوّ، يتحرّك ابن عربي بأسلوب عالم لاهوت سلبي، إذ يرى أن فهم الله عند كل طائفة إنما يكون فهما خاصّا بها ومحدودا بإطار وجودها الوظيفي في المجتمع.
وفي تحرير الحرف من أغلال الروح يرى دريدا أن النص لا يخضع للتحكّم أو الضبط، معترضا بذلك على البنيويين. وعند ابن عربي أن الله يمتنع عن التصوّر؛ وما بين التصور لماهية الله، والتحكّم في النص، يوجد توافق أحدثه تحرر فلسفي لدى كل من دريدا وابن عربي. فكلاهما يعالج الإشكاليات والتصدعات التي تحدث في النص، ويحاولان معا إنعاش طابعه الشكلي عبر الغوص في تراكيبه وتأويلاته وفك شيفراته الداخلية. بمعنى آخر: إن الثوابت المستقرة وتأويلاتها التقليدية تحتاج إلى زعزعة ركائزها لفهم ما الذي يجري لها.
أما بالنسبة إلى اختلاف المُرجَأ (La différance)، فهو لا يرى إلا بوصفه اختلافا في التصوّرات والماهيات، مع عدم وجود ثوابت معتمدة. إذ يجعل الكتابة مراوغة، غير قابلة للتحكم أو الضبط، تختلف على نفسها، وتؤجل نفسها، وتكرر نفسها. فالإرجاء جزء منه وإليه. ولا يكون الاختلاف إلا أساسا يعتمد عليه في تغيير أنساق الدلالات والتصورات. ومن هنا أرى أن اختلاف المُرجأ ضربٌ من اللعب واللهو لسيولة اختلافاته؛ لذا يصعب علينا تصوّر هذا المفهوم كما هو. فاختلاف المرجأ ليس كلمة ولا مفهوماً يمكن وضعه على مسطرة والإمساك بتلابيبه؛ يغيب عنه المعنى. وبالتالي تصبح La différance لا بوصفها تأجيلاً بالفرنسية، ولا هي العكس من التأجيل، ولا تعني التبشير النبوي، ولا أي شيء محدد. ويرى دريدا أن أصل الفلسفة هو الإرجاء، بمعنى اللاشيء أو الفراغ من المعنى. وهذا ما يريد إيصالنا إليه.
فعندما نقول: الوجود، العلة، المعلول، كلها مصطلحات دلالية يسهل فهمها ومعرفة مقصدها، على غرار «المرجأ» الذي لا يمكن تصوره أو تخيله، سواء تتبّعته لفظياً أو من حيث المنهجية المرجئية التي اتخذها كل من دريدا وابن عربي. فهو أقرب إلى السر، إلى القبر، إلى الشيء الخفي غير المعلوم.
كذلك يعتقد دريدا أن السر مجرّد فراغ، شيء لا يحمل في جعبته شيئاً. وقد ضرب مثلاً في آخر كتابه لرجلٍ كان لغرابة مظهره وتصرفاته محط سؤال وظنون، فظن الناس أنه يخفي شيئاً ما. دارت الظنون حوله حتى قتل وتخلصوا منه، وفي النهاية لم يكن يخفي شيئاً. فأي ذنب قُتل به؟
وفي علم التأويل الإيجابي، يرى كل منهما أن النص حامل بتأويلات كثيرة، وأن القارئ يصل إلى معان متعددة من خلال قراءته. فليس في النص ما يضبط المعنى عند ابن عربي، وكذلك عند دريدا. كما يرى دريدا أن تفاسير الآيات تنتقل دائما من الباطن إلى الظاهر، أي إنها عملية تنشيط لا نهائي لباطن الكتاب المقدس. وهذه الرؤية الهيراقليطية عند ابن عربي لعالم متقلّب سريع التحوّل هي نفسها عند دريدا، غير أن دريدا يعكس الاتجاه؛ فلا يرى أي معانٍ باطنية، ويرى أن النص عند تفكيكه لا يحمل في داخله أي شيء. (قام دريدا بقلب جدلية ابن عربي من الداخل إلى الخارج، كما فعل ماركس مع هيغل).
وفي القداسة بما هي حيرة، يفسر ابن عربي الطوفان الذي حدث لقوم نوح في سورة نوح تفسيراً مخالفاً للملاصق بالنصّ القرآني؛ فيرى أن الغارقين من قوم نوح هم مؤمنون، وأنهم غرقوا في بحر الحيرة، بينما (المؤمنون) الذين نجوا هم الجهّال والضالّون. وفي هذه الكارثة الأسطورية يتحدث دريدا عن قصة بابل، وهي نسخة قديمة قصصية–أسطورية عن سفينة نوح. فيشترك ابن عربي ودريدا في اعتبار أن هذا العقاب الذي حل بهم هو نعمة لا نقمة، ورقي لا نهاية. ولا يختلف القرآن عن الرواية البابلية فيما يخص الطوفان، إلا في التفاصيل التي يوضح فيها القرآن قنوط نوح من قومه، ويأسه، وعطفه عليهم.
إن هذا التأويل والتفكيك من أجل الوصول إلى الحق، وهذا الدوران خلفَ النصوص وأمامها ووراءها، يبيّن مدى تشابه أسلوب دريدا بأسلوب ابن عربي، ومدى ما يحمله دريدا من تناقضات حتى في الرأي والتفسير، كنوع من البلبلة والغرق في المعنى إلى حدّ الحيرة. وهذا أسلوب صوفي لا يخلو من تأثير شيخه الأكبر.
ملخص من كتاب: التصوف والتفكيك درس مقارن بين دريدا وابن عربي
تأليف أيان ألموند