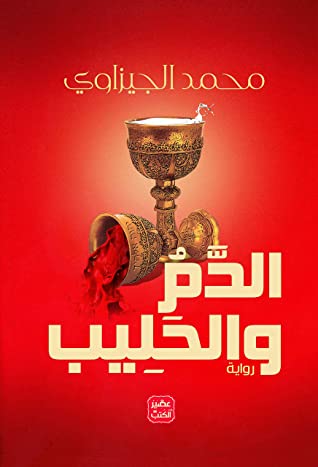

هوشنك أوسي. منقول عن موقع درج
أغلب النّصوص الرّوائيّة التي صدرت في العقدين الأخيرين، بخاصّة منها الصّادرة عقب حركات الاحتجاج والثورات التي شهدتها المنطقة العربيّة، بقيت لصيقة الهمّ الدَّاخلي المحلّي؛ الاستبداد، الفقر، العشوائيّات، والمهمّشين. وحتّى النّصوص التي جنحت نحو الفانتازيا والمتخيّل التاريخي أو المستقبلي، في جانب منها، كانت إسقاطًا على مرارة الرّاهن المعاش وقسوتهِ، ومشتركها الحنينُ إلى الماضي، في ما يشبه نوستالجيا خاصّة، أو بكاء على أطلال الواقع، ضمن المدوّنات الرّوائيّة، بدلاً من الشعريّة. في هكذا مناخ، حاول كُثر طرح اجتهاداتهم ــ نصوصهم الرّوائيّة. وبقت أغلب النّصوص رهينة المكان، بلد، مدينة، منطقة…! أمّا الخروج من هذه الثيمة إلى ما هو أوسع من فضاءات اليومي، المحلّي، المناطقي، الهويّاتي، والميل نحو معالجة وطرح أسئلة العالم والتحوّلات والصراعات الكبرى، وتناول أسباب الانحدار نحو الانحطاط والحضيض العالمي، فتلك ثيمة أشتغل عليها قلّة من الأدباء الغربيين والعرب.
مناسبة ذلك، الحديث عن رواية “الدّم والحليب” للروائي المصري محمد الجيزاوي، الصادرة في 380 صفحة من القطع المتوسّط، عن دار “عصير الكتب” المصريّة، في سبتمبر 2020. ذلك أن هذا العمل، يعتبر خروجًا من إطارِ الحديث عن مصر؛ القاهرة، إسكندريّة، الصعيد…الخ، بأن قدَّمَ الكاتب نصًّا روائيًّا عن أمكنة أخرى، مصر جزء منها، (ويكاد أن يكون وجودها حدثًا عارضًا)، وسلّط الضّوء على قضايا، لا تمسّ بشكل مباشر المجتمع المصري، وكانت البؤرة الدراميّة للرواية ثابتة، ومتحرّكة في آن، عبر الأزمنة والأمكنة، وخليطًا من الحقيقي والمتخيّل، حاولت ملامسة الهمّ الإنساني العابر للأوطان والهويّات. وهذا بحدّ ذاته، تحدٍّ كبير حاول الجيزاوي التصدّي له في روايته، موضوعة هذه الأسطر.
الحكاية
تبدأُ في اليمن، بحبّ جارفٍ يجمع فتاةً يهوديّةً تُدعى صفية بنت حزقيال بن ميمون القدّاح، وشابٍ مسلمٍ يُدعى عبدالله بن إسماعيل بن شمس القرشي. يتحدّى العاشقان رفض أسرتيهما، ويتزوّجان، ويثمر حبّهما ولادة طفل سنة 1938، اسمه حسّون، غادر والدهُ الحياة وطفله لمّا يزل في الخامسة. ازدادت معاناة الأمّ أكثر، بفقدانها حبيبها وسندها الذي خالفت لأجلهِ تعاليم دينها، ورفضت ترك الدين والحبيب. إخلاصها لزوجها، دفعها لأن تخلص إلى دين ابنه؛ ثمرة عشقهما، ولم تسعَ إلى تبديل دينه، على العكس من ذلك. فصار الطفل يدين بدينين؛ إسلامي ويهودي، ومنذ ولادتهِ، وحتّى نهاية العالم. تتفاقم محنة الأم في كيفيّة حفاظها على ابنها، فاعتزلت الزواج، وعاشت حياتها لأجله.
في العاشرة من عمرهِ، وأثناء تردّدهِ على حفرة، كانت في الأصل موقع “كنيسة أبرهة الأشرم، ليصرف أنظار العرب عن حجّ الكعبة” (ص27)، نام في ظلّ شجرةٍ لا ثمر لها، نمت في قاع الحفرة غير الخالية من القمامة، فرأى حلمًا غريبًا، أنه وسط تلك الكنيسة القديمة، وإذا بتمثال مريم العذراء يتحرّك ويتّجه نحوه، وتمسح على رأسه وتمسك بيده، تأخذه إلى قاعة فيها رجالٌ ثلاث، أمام كل واحد منهم كأس، والكأس الرابعة فارغة. وقالت له: “هؤلاء موسى ويسوع ومحمد. فانظر أيُّ كؤوسهم أحبُّ إليك فخذهُ وصبَّ منه في كأسك (…) كأس موسى مترعة بالدّم؛ آيته التي ضرب بها أنهار فرعون. كأس يسوع ملأى بالخمر؛ أوّلُ آياتهِ (…) وهذه كأس محمد مملوءة باللبن، أحبُّ الشراب إليه وآية الفطرة البيضاء في أمّته. أمّا هذه الكأس الفارغة فهي كأسك، صُبّ فيها ما تشاءُ من شرابهم” (ص29). يرى حسّون، في حلمهِ، أن وجه موسى عابسًا متجهِّمًا، فيصبّ شيئًا من كأسهِ، تحاشيًا غضبتَهُ، ويرى وجه عيسى ودودًا هادئًا متسامحًا تكاد عيناه أن تدمعا، فيتجاهلهُ، ويرى أن محمد يجمع بين وداعة وطيبة يسوع، وحزم وصرامة موسى، فيأخذُ قليلاً من حليب كأسه. ويشربُ خليطًا من الدّم والحليب، فتحزن المرأة (مريم) وتبكي قائلة: “شرِبتَ من كأسيهما ولم تشرب من كأس ولدي” (ص29). وتبقى هذه الرؤية ــ (الحُلم) مصاحبة لبطل “الدّم والحليب” حتّى نهاية الرواية.
يشبُّ الطفل عن الطوق في تنازع داخلي بين دينين متنازعين. يتم ترحيله إلى فلسطين، رفقة أمّه وجدّه، مع يهود اليمن، عقب إعلان إسرائيل عن نفسها كدولة، عبر عمليّة “بساط الرّيح” أو “جناح النّسر” (1949-1950). تبدأ حياة جديدة لحسّون وأمّه وجدّه في المخيّمات. ويبقى يتعرّض للمتابعة والملاحقة من قبل الحاخام اليهودي اليمني “باروخ” ذي السلطة والنفوذ في إسرائيل. بمرور السنوات، لا تتغيّر ملامح حسّون، فليفت ذلك انتباه “باروخ”. وحين يعترف حسوّن بتفاصيل حلمه القديم حين كان في العاشرة، يعلنه الحاخام المسيح الذين ينتظره اليهود، لكنه يرفض ذلك. يُقتَل جدّه، وتخاف أمّه فتحاول تهريبه إلى الخليل، ثمّ غزّة، ومنها إلى مصر، كي يستقرّ به المقام في تونس. يقضي حسّون 45 سنة في إسرائيل، ومع وصوله إلى سيناء، في “جبل الرّب” تموت أمّه، فيدفنها هناك. يبقى في جوار ضريح أمّهِ، رفقه كلبه “غلام”. بعض مضي 17 سنة، يموت الكلب، فيضطر على المغادرة إلى تونس. يصلها عن طريق البحر. يبقى هناك نحو قرن، وتبقى ملامحه وهيئته ملامح رجل في الأربعين. تحدث تحوّلات كبيرة في ذلك القرن. تزول إسرائيل من الوجود، وتتحد دول المغرب العربي. يُفتضح أمرُ حسّون، ويتم تسفيره إلى أوروبا، بهدف إخضاعه للفحوصات والأبحاث في محاولة كشف سرِّ عمرهِ المديد. ومن ألمانيا، إلى هولند، ثم فرنسا، ويستقرّ المقام به في إيطاليا. تمرّه عليه قرون، تسيطر فيها إيران على العراق والشام، وتعود المجوسيّة! يتطوّر العالم، يضرب أحد المذنبات القمر، ويصبح أثرًا بعد عين. تحدث كوارث، براكين، فيضانات، حروب، دينيّة. بعد استسلام “مجلس العلماء” الذي فشل في إدارة شؤون العالم، عادت أوروبا إلى حكم الكنيسة، وساد الجهل والأحقاد الدينيّة، وعادت تلك البلاد إلى عصور أكثر ظلمة وجهالة من العصور الوسطى. سيطر التوحّش والبدائيّة وانحدرت المجتمعات إلى عصر الغابة. قبل استسلام مجلس العلماء للكنيسة، أطلق سراح حسون الذي هرب من فرنسا إلى اسبانيا. ومنها إلى المغرب، وصولاً إلى مصر، والاستقرار في سيناء، قريبًا من ضريح أمّه. مجددًا ينزل الله غضبه على الأرض عبر البراكين والزلازل والفيضانات، ويمطر الأرض بالشهب. ويبقى حسّون الإنسان الوحيد على الأرض ليروي لنا حكايته التي طالت ألفين وسبع مئة سنة.
سؤال العنوان
اختار المؤلّف جملة خبريّة مفتوحة، خبرها محذوف (مجهول)، عنوانًا لروايته. وجعل الأسبقيّة للدّم، وعطف عليه الحليب. عدم اختتام الجملة بخبر، فتح المجال أمام تقديره، كأن يكون: الدَّم والحليب، متصالحان، متعاديان، متخاصمان، متآلفان، منسجمان… إلى آخر ما يمكن أن يصل إليه التخمين والتأويل. وعليه، بقدر ما كان العنوان واضحًا، في اللفظ والدلالة، كذلك حضر الالتباسُ أيضًا، وترك الباب مشرّعًا على الافتراض ــ الاستنتاج؛ “الدّم والحليب”..، نعم، وماذا بعدهما؟! أو ماذا بينهما؟ أو ماذا جرى لهما؟ أو ماذا يريدان؟ وهكذا دواليكم من الاستفسارات التي يجترحها الظنُّ والتخمين.
مضافًا إليه، وقع كلمة الدّم، مع إطباق الشفتين أثناء النطق، والصوت الذي يصدر من اقتران الدال المشددة المفتوحة، بالميمِ المرفوعة المضمومة؛ الـ”دَّمُ”، ومع عطف المقاطع الصوتيّة (الأحرف) التي تشكّل كلمة الحليب على الدَّم، من دون تكرار أيّ حرف في الكلمتين، وعدم إبقائهما نكرتين معطوفتين بعضهما على بعض (دم وحليب)، بل معرَّفتين؛ “الدَّم والحليب”، لكن أل التعريف مختلفتان، الأولى شمسيّة، والثانيّة قمريّة، كلّ ذلك، يجذب القارئ، ويدفعه للتّساؤل: لماذا اختار الكاتب هذا العنوان؟ مع الرّهبة التي تخلقها كلمة الدّم، على صعيد اللون ودلالاته؛ الحبّ، الحرب، الثورة، والقداسة أو “النجاسة”، والطمأنينة السلام أو الاستسلام التي تجلبها كلمة الحليب. لونان متضادّان على صعيد الدّلالات والترميز والتّصنيف (أحمر لون ساخن، أبيض لون بارد)، لكن الأحمر يدخل في تركيب الأبيض الذي يتفرّع إلى ألوان الطيف.
من جهة أخرى؛ كلمة الدم، لجهة الدّلالة الاجتماعيّة، وصلة القربى، تتمُّ مقارنته بالماء، في الأمثال الشعبيّة الدارجة؛ “الدَّم ما بيصير مي”. أمّا أن يظهر في عنوان رواية، إلى جوار الحليب، فذلك مربط الفُجاءة والاختلاف، وعلامتي الاستفهام والتعجّب اللتين خلقهما العنوان لدي. وفي الصفحة 29 من الرواية، يوضّح الجيزاوي أن الدَّم المقصود به اليهوديّة، والحليب هو الإسلام. وهنا، يتضح لنا معنى ومغزى العنوان على أنه “اليهوديّة والإسلام”.
وعلى الرّغم من أن الكاتب كرَّرَ عدّة مرّات، على امتداد الصفحات 380، أنه لا فرق بين اليهوديّة والإسلام، لأن معبودهما واحد (ص76) مثلاً، وأنه حاصل جمع هذين الدينين، والسؤال هو: هل كان الجيزاوي محايدًا تمامًا، وعلى مسافة واحدة من الدينين؟ لا، طبعًا. وسند وبرهان ذلك من نفس الصفحة 29، حين يصف وجه موسى العابس، الباعث على الرهبة والخوف، ما أجبرهُ على اختيار صبّ القليل من كأس الدّم، بينما اختياره للحليب كان عن قناعة على أن محمّد يجمع بين سماحة ووادعة وطيبة المسيح، وصلابة وصرامة موسى: “كان وجه موسى عابسًا، يبثُّ الخوفَ في نفسي. عيونهُ حازمة مسددة نحوي. شعرت بالخوف، ولم استطع تجاوز كأسه، خشية أن يغضب. وصببت من دمها في كأسي (…) ثمّ ذهبتُ إلى محمد، فابتسم لي وابتسمت له، وجهه يحمل وداعة وجه يسوع، لكنه أكثر حزمًا منه. ويحملُ صلابة وجه موسى، لكنه أقلُّ قسوة منه. أعجبني أنه جمع بين بينهما… فأخذت من كأس اللبن وصببتُ في كأسي” (ص29). زد على ذلك، جعل اللون الأبيض الحليب، “آية الفطرة البيضاء في أمّته” (ص29)، لكأنّ الأحمر (الدّم) آية الفطرة لدى أمّة موسى!
هذا الميل والتفضيل والانحياز، يعبّر عن نفسه في صورة الغلاف أيضًا. إذ لدينا كأسان، المترعةُ حليبًا، واقفة من خلفها وميض، بينما الكأس مترعةُ دمًا، ساقطة، اندلق دمها. والسؤال هنا؛ مع وجود الميل والانحياز ورجحان كفّة الإسلام، ماذا نفعل بكلّ ذلك الكلام الذي تنضحُ به الرواية؛ عن التسامح والمساواة بين الدينين اليهودي والإسلامي؟
البناء والتقنيات
“لستُ المخلّص الذي انتظرهُ أحفاد إسرائيل، ولم أكن يومًا المسيح الذي انتظرهُ أتباع يسوع، ولا أنا المهدي الذي انتظره المسلمون. بل كنتُ دومًا وفقط، حسّون” (ص7)، بضمير المتكلّم المستتر؛ “أنا” المسند إلى الفعل الماضي الناقص “لستُ” الذي يفيد النفي، هكذا باشر محمد الجيزاوي روايته “الدّم والحليب”، منصّبًا بطله حسّون؛ الراوي العليم، الذي يسرد الحكاية، طبقًا لتقنية “الخطف خلفًا” أو “الفلاش باك”. وقسّم الرواية إلى ستّة أيّام، كلُّ يومٍ فصلٌ، لتنتهي الرواية بـ”لم يستطع أبونا الأكبر حسّون أن يحقق أمنيته، إذ أن اليوم السابع لم يأتِ على الأرض” (ص381). وهذا العبارة الخاتمة، القفلة، تشي أننا إزاء راوٍ جديد، غير حسّون. وأن الأخير كان يفترض به إكمال كتابة الرواية في اليوم السابع، إلاّ أنه لم يحقق ذلك. إذن، نحن إزاء راويين عليمين، الأوّل حسون، ابتدأ الرواية، والثاني؛ مجهول، اختتمها، في سطر.
ليس بخافٍ أن اختيار الأيّام الستّ، فيه تماهٍ مع قصّة الخلق، وأن الله خلق الكون في ستّة أيّام (سورة ق، الآية 38). لكن، صاحب الجملة الأخيرة من الرواية، حين يصف حسّون بـ”أبونا الأكبر” هذا يعني أن العالم لم ينتهِ، وأن صاحب العبارة من نسل حسّون، وأنّه ربّما يتحدّث إلينا من سنة 5638 أو 7538 م. علمًا أن الجيزاوي اختار عمرًا لبطله حسّون يتجاوز عمري النبيين آدم ونوح مجتمعين! وعليه، الثيمة الرئيسة في العمل، هي الزمن، والحقُّ أن المؤلّف أجاد الاشتغال عليها. مع ذلك، وكأيّ عمل روائي متعوب عليه، لا مناص من وجود بعض الهفوات والهنات التي شابت “الدّم والحليب”، المتعلّقة بالتحرير، منها:
1ــ المعلومات المتعلّقة بمدّة بقاء البطل في بطن أمّه (سنتان وسبعة أشهر)، وعمره (2700)، وانقسامه بين دينين؛ يهودي وإسلامي، هذه المعلومات تكرر ذكرها في عدّة أماكن في الرواية، بما تجاوز الضرورات الفنيّة. وكان في الإمكان تكرارها مرّتين أو ثلاث، لتذكير القارئ بها.
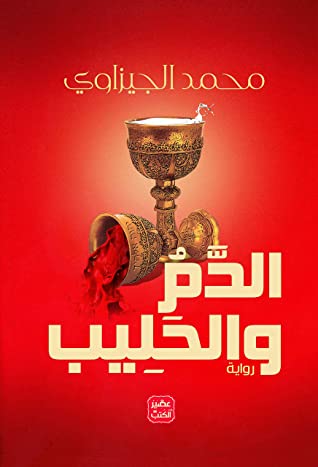
2ــ أبقى الجيزاوي بطله سنتين وسبعة أشهر في بطن أمّه، ومنحهُ عمرًا امتدَّ ألفين وسبع مئة سنة. وبالمقارنة بين الزّمنين، نجد أن كلَّ سنة من فترة الحمل، تقابل ألف سنة من العمر، وكلَّ شهر تقابل قرنًا من عمرهِ. وإذا اعتمدنا على مقياس أشهر الحمل (31 شهر)، يفترض أن يكون عمر حسّون ثلاثة آلاف ومئة سنة، وليس ألفان وسبع مئة سنة.
معطوفًا على ما سلف؛ معلوم أن ترحيل يهود اليمن إلى إسرائيل جرى سنة 1949-1950، وذكر حسّون أثناء تواجده في معسكرات اليهود اليمنيين، أنه بلغ الثانية عشرة (ص52)، وكرر ذلك في الصفحة 55. وفي الصفحة 247، يذكر أنه ولد سنة 1938. ما يعني أنهم وصلوا فلسطين سنة 1950. بينما نقرأ على لسان الحاخام “باروخ” مخاطبًا حسّون: “خمس وأربعون سنة، قضيت منها في إسرائيل ثلاثين سنة أو يزيد” (ص71). في حين أن الحاخام، في الرواية، يعرف تاريخ حبل أمّ حسّون به (ص15)، وتاريخ مولده، وأتوا معًا إلى إسرائيل سنة (1950)، وطبقًا لمواليد البطل؛ 1938+45-30= 1953، وعبارة “أو يزيد” يفتح مجال للاحتمالات: بضعة أشهر، سنة، سنتان، ثلاث؟
كذلك في الصفحة 88، وأثناء هروب حسّون وأمّه من الحاخام باروخ، وتواجده في الخليل، يذكر أنه مضى على تواجده في فلسطين أربعون عامًا. يعني أنهم في سنة 1990، إذًا، كان وصولهم إلى تونس سنة 2007! أمَّا إذا كان وصولهم سنة 1953، هذا يعني أن سنة وجودهم في الخليل، وصولهم إلى غزّة، ثم سيناء هي 1993. وبقي هناك سبعة عشر عامًا، وغادرها إلى تونس وهي تموج بثورة” (ص110)، بعد 17 ديسمبر 2010. هكذا، تكون الحسبة صحيحة. الوصول سنة 1953، البقاء 40 سنة في فلسطين، بقي في الخليل لأشهر أو أقلّ (ص87-98)، وسنة 1993 كانت المغادرة، ثمّ البقاء في سيناء 17 سنة، الوصول إلى تونس نهاية 2010. لكنه يأتي ويقول في الصفحة 111، أنه بقي في فلسطين 45 سنة، هذا يعني أنه غادرها سنة 1995. وإذا اعتمدنا هذه المدّة، تكون الحصيلة: 1950+45+17=2012 سنة وصوله إلى تونس، وقتذاك، ما كانت هناك ثورة! وإذا عكسنا الأمر: 2010-17-45=1948، سنة وصول حسّون إلى فلسطين، وكان وقتذاك في العاشرة من عمره، وليس الثانية عشرة! وعليه، متى وصلّ البطل أرض فلسطين، هل سنة 1950 أم 1953؟ وكم بقي هناك؛ 40 سنة أم 45؟ اعتقد أن التواريخ والمدد الزمنيّة، بحاجة إلى مراجعة ومزيد من التدقيق والضبط، لأن الثيمة الرئيسة في الرواية هي الزمن، فمِن غير المعقول أن يكون هناك ما يشبه الخلل في هذا المفصل الحيوي والرئيس في “الدّم والحليب”.
3ــ يشير الكاتب إلى تورّط مفتي أو إمام اليمن في عمليّة ترحيل اليهود: “منع الإمام يهود الشمال من الهجرة. حينما استفحل أمر النزوح عن اليمن، لكن هذا المنع لم يستمرّ طويلاً. أبرم اتفاق له ثمن، وبعدما قبض الإمام أجره، سمح لليهود بالهجرة” (ص48). ولم يذكر الكاتب اسم الإمام، طالما يثق بمعلومته التاريخيّة. وبحسب متابعتي، تبيّن أن اسمه “الإمام أحمد حميد الدين”.
4ــ لغة الجيزاوي جزلة تميل إلى البلاغة والرصانة، وبقيت على حالها، طيلة ألفين وسبع مئة سنة، لم تتغيّر، لكأنّ اللغة عند حسّون، ثابتة، لا حراك فيها، لا تتبدّل وتتطوّر طوال 2700 سنة، بل تراجعت، لأنه عاد إلى إطلاق اسم “بحر القلزم” (ص373) على البحر الأحمر، وبقي يصف المسحيين بـ”النصارى” بعد مضي 27 قرنًا! وهذا مخالف لمنطق اللغات، والعربيّة ليست استثناء. وبالرّغم من جودة اللغة في “الدّم والحليب” والمهارات اللغويّة والبلاغيّة التي لا تخطئها عين في هذا النصّ الروائي، إلاّ أنه شابها شيء من الحشو والتكرار والنتوءات والزوائد اللغويّة التي كان في الإمكان التخلّي عنها، لصالح التقليل من الدهون والشحوم اللغويّة الزائدة. وهنا، أذكر بعض الأمثلة: تكررت كلمة “طعام” خمس مرّات، في سطرين متواليين من الصفحة 89. وتكرر حرف العطف “ثمّ” أربع مرّات في سطرين متواليين من الصفحة 191. تكرر حرف الجرّ “في” ثلاث مرّات في سطر واحد من الصفحة 192، وتكرر إحدى عشرة مرّة في الصفحة 360. كذلك تكرر الفعل الماضي الناقص “كان” بكثرة، في عدّةِ أماكن من الرواية؛ 9 مرّات (ص11)، 9 مرّات (ص233)، كما تكرر اسم حسّون خمس مرّات في أربعة أسطر متوالية (ص249). أّما عن ورود كلمة “عيون” بدلاً من عينين أو عينان، فحدّث ولا حرج. فضلاً من العبارات التي تفيد الشروح التي لا لزوم لها، على سبيل الذكر: “وما أن خلوت بها وخلت بي” (ص208)، فالجملة المعطوفة “وخلت بي”، هي شرح زائد. ذلك أن اختلاءه بها، يفضي إلى بداهة اختلاءها به.
رواية “الدّم والحليب” للرّوائي المصري محمد الجيزاوي؛ بحقّ هي رواية الرؤيات ــ الأحلام؛ رؤيا والد حسّون (ص21)، رؤيا حسّون (ص28-29)، رؤيا الشيخ التيجاني (ص192)، والأحداث التي أتت كتفسيرات لها. وعليه، يمكن القول: إنها خلطة أدبيّة دسمة، بين الماضي القريب، والحاضر المُعاش، والمستقبل البعيد، حاولتْ الخوضَ في طبائع الصَّراع بين اليهوديّة والإسلام من جهة، والصّراع بين الدّين والعلم على إدارة العالم من جهة أخرى، وصولاً لاستشراف المآلات الوخيمة التي تنتظر البشريّة، من جهة ثالثة. سرديّة مركّبة، في ثلثيها الأوّل والثاني، تميل الرّواية إلى كونها اجتماعيّة، صوفيّة، فلسفيّة، وكيف أن الحبّ ينتصر على اختلاف الأديان وصراعاتها، لكن لهذا الانتصار ضرائبهُ وأكلافهُ النفسيّة، الاجتماعيّة، الاقتصاديّة والسياسيّة. بينما الثلث الأخير من الرواية، فيخوض في الخيال الاستشرافي التنبؤي، الاجتماعي، السياسي، والعلمي. وصحيح أنه يرجّح كفّة الدين على العلم: “كل ما صنعته يد العلم، حطّمته يد الله بضربة واحدة” (ص316)، إلاَّ أن هذه الرواية ذات محمول فلسفي، صوفي، في بعض جوانبها. ذلك أن العمل الأدبي ليس فقط مجرّد حكاية تتفرّع منها دزينة حكايات أخرى، هي حاصل ضرب الواقع بالفانتازيا، مقسومًا على اللغة الجزلة أو السهلة وحسب، بل يجب أن يكون هناك عمق، فكري، بصرف النظر عن منسوب ذلك العمق؛ شديد أم طفيف. لذا، فهي مغامرة خطرة وشاقّة، وتحدٍّ هام وصبور، لا يمكن أن يتصدّى لها إلاّ كاتب يمتلك تلك الثقة والجرأة والعدّة وذلك العناد والعتاد الثقافي واللغوي والمهارات والألعاب “القتاليّة” التي لا يستهان بها. وفي تقديري، نجح الجيزاوي في تلك المغامرة، بحيث غلبت نسبة “الموآنسة والإمتاع” نسبة الإقناع. وأعتقد أن الأصل في الأدب والإبداع، هو الإمتاع أكثر من الإقناع. رواية “الدَّم والحليب” اجتهاد أدبي، روائي، هام وجسور، وسواء بعِلمِ صاحبها، أو من دون علمهِ، فإنها طرحت سؤالاً جديرًا بالأهميّة والخطورة والفرادة والحيرة، مفاده: ماذا لو عاش المرء عمره، يدين بدينين، متخاصمين، متنافرين، كل واحدٍ منهما، يحاول إنكار وإلغاء الآخر؟ يبقى القول: إن من يقرأ هذه الرواية حاليًا، يفترض أن بطلها موجود الآن في تونس. ولأنها تتناول الحقبة الممتدّة من 1938 مضافًا إليها 2700 سنة، بما فيها من تنبؤات واستشرافات وتكهّنات وتوقّعات، حتّى نهاية العالم سنة 4638 م، فإن الرواية ستبقّى مستمرّة إلى ذلك الحين، هذا إن لم ينتهِ العالم، قبل حلول تلك السنة.







