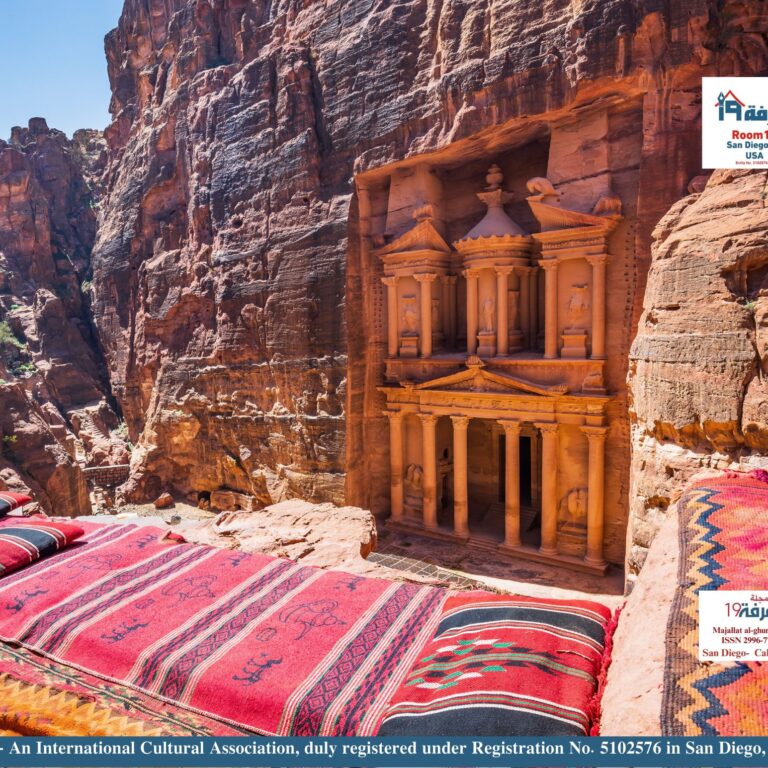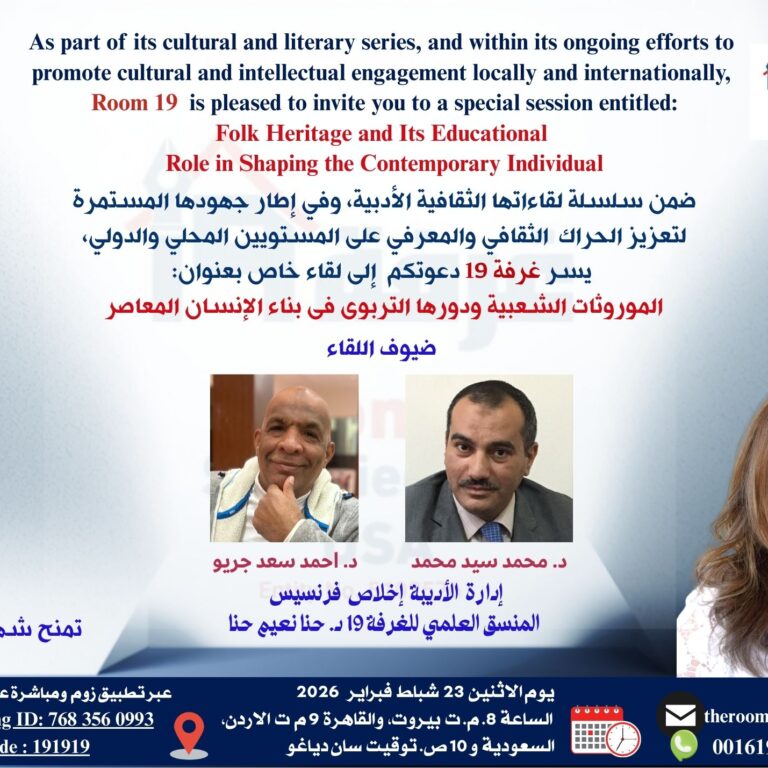توطئة
يُعدّ الأدب فضاءً معرفيًا وثقافيًا يتجاوز حدود الجماليّات التقليدية، إذ يمنح الأديب قدرة على التعبير عن ذاته وفي الوقت نفسه قراءة العالم وتأويله. فالنص الأدبي ليس بنية لغوية فحسب، بل هو نتاج علاقة معقدة بين الكاتب وخبرته الداخلية، وبين المجتمع بقضاياه وأسئلته. وفي هذا الإطار تبرز جدليّة الانغماس والتخارج بوصفها مدخلًا نقديًا لفهم كيفية تشكّل النص الأدبي من تفاعل مستمر بين البعد الذاتي والبعد الموضوعي.
إن دراسة هذه الحركة المتوترة بين الداخل والخارج تكشف أنّ الإبداع لا يتحقّق إلا عبر موازنة دقيقة بين التماهي مع التجربة الشخصية من جهة، واتخاذ مسافة نقدية تسمح للنص بأن يكتسب استقلاله وفاعليته بوصفه خطابًا ثقافيًا من جهة أخرى.
أولًا: الانغماس في النص
الانغماس هو لحظة التوحّد بين الأديب وعملية الكتابة، حين تصبح الكتابة جزءًا من الذات، وتمتد التجربة الفردية لتشكّل نواة الخطاب الأدبي.
• التعبير الشخصي المكثّف
في هذه المرحلة يتماهى الأديب مع النص تمامًا، فيغدو النص ترجمة لانفعالاته ورؤيته للعالم. وقد مثّلت روايات دوستويفسكي مثالًا واضحًا للكتابة المنغمسة في العالم الداخلي، إذ تنعكس صراعاته الوجودية والروحية في تفاصيل السرد والشخصيات.
. اللغة بوصفها مرآة نفسية
تتحوّل اللغة في لحظة الانغماس إلى وسيط نفسي، لا إلى أداة تقنية. فهي ناقلة للقلق، والذاكرة، والهواجس، والرؤى، بما يجعلها مرآة شفافة للذات الكاتبة. وقد أشار نقّاد عرب مثل عبد الفتاح كيليطو وجابر عصفور إلى الدور التوليدي للغة في تشكيل الوعي الأدبي.
. الحياة مادة للنص
تتواشج التجربة الحياتية مع الخيال لتشكّل مادة النص. فالأديب يعيد إنتاج الواقع عبر منظور فردي، فلا تكون الكتابة استنساخًا للواقع بل إعادة تشكيل جمالية له.
ثانيًا: التخارج عن النص
التخارج هو اللحظة التي ينظر فيها الأديب إلى النص باعتباره خطابًا مستقلاً، لا امتدادًا مباشرًا للذات، ما يسمح له بقراءة العالم من زاوية أشمل.
. التجريد الفكري
يتجاوز الأديب ذاته ليقدّم رؤى فلسفية أو وجودية أو اجتماعية أعمق. وهذا ما نجده في كتابات كافكا، حيث تتحوّل الأحداث إلى رموز كونية تُعالج علاقة الإنسان بالسلطة، والوجود، والمصير.
. المسافة النقدية
التخارج يتيح للكاتب مراقبة نصه بوعي نقدي، فيفككه ويعيد صياغته من منظور القارئ. هذا ما وصفه النقاد العرب بمفهوم “وعي الكتابة”، وهو القدرة على النظر للنص بوصفه «منتجًا ثقافيًا».
. الالتزام الاجتماعي
حين يكتب الأديب نصًا يتجاوز تجربته الشخصية ليعبّر عن قضايا عامة، يُصبح التخارج شكلًا من أشكال المسؤولية الأخلاقية. تتجلى هذه المرحلة مثلاً في كتابات نجيب محفوظ التي تُعبّر عن المجتمع المصري عبر مستويات رمزية وسوسيولوجية واضحة.
ثالثًا: جدليّة الانغماس والتخارج
لا يمكن للأديب أن يظل في أحد القطبين دون أن يفقد النص أحد أهم مصادر قوته. فالإبداع يتحقق عبر تفاعل دائم بينهما.
. النص كمرآة مزدوجة
يعكس النص ذات الكاتب كما يعكس العالم. وهذا ما سماه النقّاد «ازدواجية الرؤية»، حيث تتداخل التجربة الفردية مع البُنى الثقافية والاجتماعية.
. الحركة بين الذات والموضوع
قد يبدأ النص من تجربة شخصية، لكنه ينتهي إلى معنى كوني. ويتجلى هذا المزج في روايات ماركيز، حيث تنفتح الذاكرة الفردية على الذاكرة الجماعية والحكائية.
. الإبداع كتفاعل دينامي
الإبداع ليس حالة استقرار بل حركة مستمرة بين الانغماس والتخارج، بين الذات والآخر، بين الفردي والجماعي، وهو ما يمنح الأدب حداثته ومرونته.
رابعًا: انعكاسات الجدلية على القارئ
. النص بين الخصوصية والعمومية
يمتلك النص الذي ينجح في تحقيق التوازن بين القطبين قدرة على إثارة الأسئلة لدى القارئ، لأنه يحمل بصمة الكاتب دون أن يغلق أفق القراءة.
. تفاعل القارئ مع النص
النص الذاتي الخالص قد يُربك القارئ، بينما النص الموضوعي الخالص قد يفتقر إلى الدفء. أما النص الذي يزاوج بينهما فيمنح القارئ مساحة للتأمل والاندماج الوجداني.
. النص كفضاء للحوار
حين يبلغ النص توازنه، يصبح أرضية مشتركة بين الكاتب والقارئ، فيتحول الأدب إلى عملية تفاوض دلالي بين الذات والآخر.
خامسًا: أمثلة من الأدب العربي
. طه حسين
تجسّد «الأيام» نموذجًا للتوازن بين حميمية التجربة الذاتية ودلالتها الثقافية العامة، حيث تحولت السيرة الذاتية إلى وثيقة اجتماعية.
. غسان كنفاني
يمتزج في نصوصه الهمّ الفلسطيني العام مع الحساسية الفردية، فيظهر التخارج عبر الالتزام السياسي، بينما يظهر الانغماس في الأسلوب والشاعرية.
. محمود درويش
أوصل درويش الذاتي إلى الكوني؛ إذ انطلقت تجربته من الوجدان الفردي لكنها تحوّلت إلى خطاب إنساني شامل.
خاتمة
إن جدلية الانغماس والتخارج تمنح النص الأدبي عمقه وطاقته على التأويل. فهي التي تجعل الأدب قادرًا على التعبير عن الذات وفي الوقت نفسه على مساءلة العالم. ومن خلال هذا التفاعل الخلّاق بين الداخل والخارج، بين الفرد والجماعة، يظل الأدب أداة استكشاف للجوهر الإنساني، ومساحة للتفكير في قضايا الوجود والثقافة والمجتمع.
المراجع :
جابر عصفور، زمن الرواية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1999.
صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، 1985.
عبد الفتاح كيليطو، الغائب: دراسة في المقامة، دار توبقال، الدار البيضاء، 1987.
ميخائيل باختين، خطاب الرواية، ترجمة فخري خضر، وزارة الثقافة السورية، دمشق، 1990.
رولان بارت، لذة النص، ترجمة رشيد بازي، دار توبقال، الدار البيضاء، 1990.
بول ريكور، الزمان والسرد، ترجمة سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، بيروت–الدار البيضاء، 1999.
نجيب محفوظ، في حضرة النص (دراسات نقدية عنه)، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2006.
محمد برادة، الذات في الرواية العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1991.