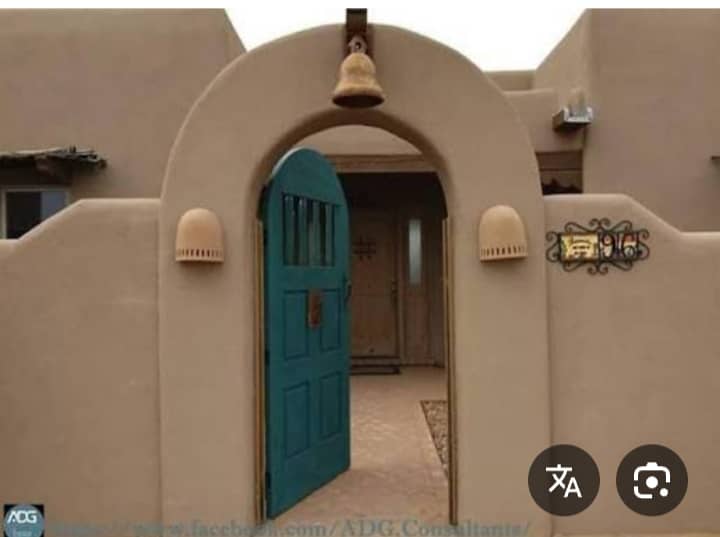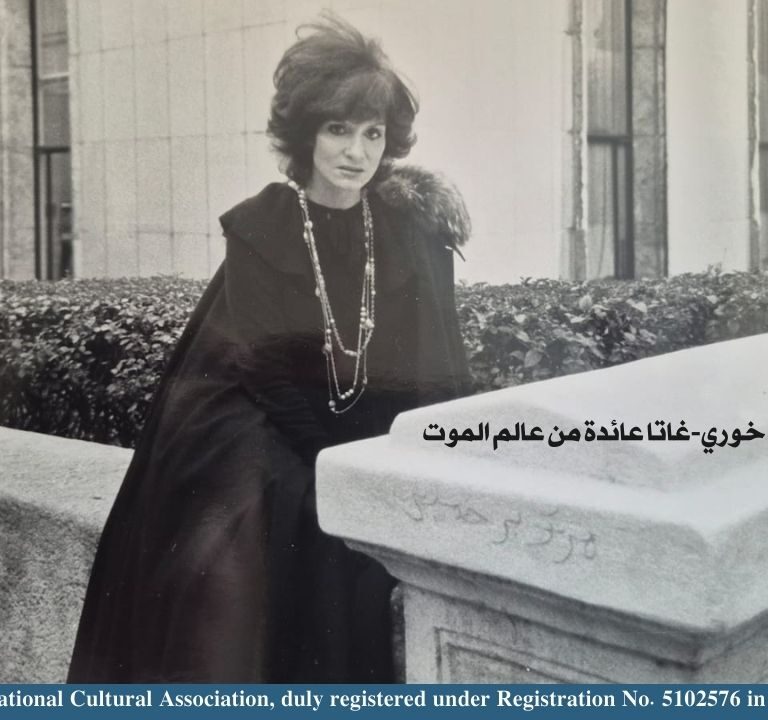“الرويال” حكاية مسرح هدمته الجرافات وبقي في الذاكرة/ زياد سامي عيتاني*
بيروت والمسرح من البدايات إلى صروح الفن(٥)
حين نتأمل تاريخ بيروت الثقافي في النصف الأول من القرن العشرين، سرعان ما يطلّ “مسرح الرويال” كأحد أبرز رموزها المسرحية والسينمائية. فقد كان هذا المسرح شاهدًا على مرحلة مفصلية من حياة العاصمة اللبنانية، حيث التقت السينما الأوروبية والأميركية مع المسرح العربي المحلي، وحيث وُلدت طبقة حضرية مثقفة جعلت من ساحة البرج فضاءً حيًا للعرض والتلاقي. ورغم أن هذا المسرح أُزيل مع مطلع خمسينيات القرن الماضي، إلا أن ذكراه لا تزال حاضرة في ذاكرة المدينة، كرمز لضياع جزء من تراثها المعماري والثقافي.
ففي قلب بيروت القديمة، على الجهة الغربية من ساحة البرج، ارتفع مبنى مسرحي حمل اسم “الرويال”، ليصبح أحد أهم معالم العاصمة اللبنانية في النصف الأول من القرن العشرين. كان “الرويال” أكثر من مجرد صالة للعرض؛ كان ملتقى للفن والجمهور، وفضاءً جمع بين السينما العالمية والمسرح العربي، وبين النخبة المثقفة وعامة الناس. ورغم أن جرافات الخمسينيات أزالت المبنى بحجة “شق طريق”، إلا أن صورته ما زالت حاضرة في ذاكرة المدينة، كرمز لضياع تراث ثقافي ومعماري ثمين.
•النشأة: من “الشيدوفر” إلى “الرويال” (1919–1924)
بدأت الحكاية عام 1919 مع سليم آغا كريدية وسليم آغا بدر، اللذين أسّسا صالة “الشيدوفر” لتكون دارًا بديلة يجتمع فيها السينما والمسرح. لبضع سنوات، شكّل “الشيدوفر” محطة أساسية لروّاد الفن السابع، خصوصًا مع تزايد الطلب على الأفلام الأوروبية.
ونشرت صحيفة النهار (1925) إعلانًا عن عروض للسينما الفرنسية في “الشيدوفر”، وأشارت إلى أنّ الصالة “مجهزة بأحدث أجهزة العرض في بيروت”، وهو ما يكشف عن سعي المؤسسين لجعلها من أكثر الصالات حداثة.
لكن عام 1924 شكّل منعطفًا مهمًا، إذ انتقلت الملكية إلى نقولا قطان وجورج حداد، اللذين أطلقا عليها اسم “الرويال”. منذ تلك اللحظة، ارتبطت ساحة البرج باسم جديد يطمح لأن يكون مسرحًا راقيًا ينافس نظيراته في المنطقة.
•الازدهار الفني: تنوع العروض وتفاعل الجمهور (1925–1945)
في ثلاثينيات القرن العشرين، لعبت السينما دورًا بارزًا في تكريس حضور “الرويال”. كانت الأفلام الأميركية والأوروبية تُعرض فيه إلى جانب الأفلام المصرية. وقد علّقت جريدة الصفا (1938) على عرض أحد الأفلام المصرية الشهيرة، مشيرة إلى أنّه “مزوّد بترجمة فرنسية لتلبية جمهور بيروت المتنوع”، ما يعكس الطابع الكوزموبوليتي للمدينة.
لم يكن “الرويال” دار سينما فقط، بل كان خشبة للمسرح العربي أيضًا. ففي عام 1930، ذكرت صحيفة المستقبل أنّ مسرحية “ليلى والذئب” عُرضت على خشبته من إنتاج فرقة محلية يقودها جورج حداد. وكتبت الصحيفة: “أثبت الرويال أنّه مساحة مفتوحة للفن العربي الناشئ، حيث يمكن للجمهور اللبناني أن يشاهد أعمالاً مسرحية تنافس العروض الأجنبية.”
إلى جانب فرقة جورج حداد، لمع اسم نقولا قطان الذي أسّس فرقة ركّزت على الأعمال الكوميدية والموسيقية، والتي سرعان ما أصبحت محط أنظار الجمهور الباحث عن الترفيه.
لم يقتصر المشهد على العروض العربية. ففي 5 آذار 1935، نشرت صحيفة الأوريان الفرنسية تقريرًا عن عرض مسرحي أجنبي قُدم في “الرويال”، مشيدةً بـ “جودة التمثيل والتنظيم، وكون المسرح قادرًا على استقبال فرق أوروبية على مستوى رفيع”. هذه الشهادة تعكس كيف أصبح “الرويال” جزءًا من شبكة ثقافية عابرة للحدود.
شهد المسرح أيضًا مشاركة وجوه نسائية بارزة مثل نزيهة وهبي، التي وصفتها صحيفة الزهراء (20 تموز 1940) بأنها “وجه جديد يعد بالكثير لمستقبل المسرح اللبناني” عقب مشاركتها في أحد العروض المحلية. كما استضاف المسرح الفنانة المصرية ليلى مراد في عروض غنائية – مسرحية زادت من شعبيته لدى الجمهور.
بهذا المزج بين السينما والمسرح، وبين المحلي والعالمي، تحول “الرويال” إلى مختبر ثقافي يعكس هوية بيروت المنفتحة والمتعددة.
•الدور الاجتماعي والثقافي
لم يكن الذهاب إلى “الرويال” مجرّد ترفيه، بل تجربة اجتماعية بامتياز. كانت ساحة البرج في تلك الفترة القلب النابض لبيروت، ووجود “الرويال” في محيطها أعطى للمكان بُعدًا ثقافيًا إضافيًا.
الصحافة كثيرًا ما ربطت بين حضور العروض في “الرويال” وبين “تشكيل ذائقة مدينية جديدة” تختلف عن أنماط الترفيه التقليدية. فقد أشار أحد كتاب الرأي في النهار عام 1932 إلى أنّ “افتتاح الرويال ساهم في ترسيخ صورة بيروت كمدينة لا تكتفي بالسياسة والتجارة، بل تفتح أبوابها للفنون الحديثة أيضًا”.
الجمهور كان متنوعًا: طلاب جامعيون، مثقفون، موظفو إدارة، وتجار. بالنسبة لهم، كان “الرويال” نافذة على العالم، ومكانًا لاجتماعات غير رسمية أسهمت في تشكيل شبكة من العلاقات الاجتماعية والثقافية.
•التراجع وظلال التغيير (1945–1950)
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأت بيروت تدخل مرحلة جديدة. ازدهرت صالات عرض أكثر حداثة مثل “ريفولي” و”الأوبرا”، ما وضع “الرويال” أمام منافسة صعبة. في الوقت نفسه، طرحت السلطات اللبنانية مشاريع لتوسيع طرقات وسط العاصمة، وكان “الرويال” في قلب المنطقة المستهدفة.
الصحافة آنذاك عبّرت عن قلقها. ففي مقالات متفرقة عام 1949، حذّرت بعض الصحف المحلية من أنّ “هدم الرويال لن يعني خسارة مبنى، بل خسارة جزء من ذاكرة المدينة”. غير أنّ صوت التطوير العمراني غلب على أصوات الاعتراض.
•قرار الهدم وتداعياته
بداية الخمسينيات، صدر القرار بهدم المبنى لفتح الطريق الرابط بين ساحة البرج وشارع بشارة الخوري. يروي المخرج والكاتب محمد سويد في كتابه “يا فؤادي” أنّ القرار لم يراعِ حقوق العمال، وحين رفض المالكون إخلاء الصالة، تحوّلت إلى ما يشبه “السد” في وجه المشروع.
ويضيف سويد أنّ رئيس مجلس الوزراء سامي الصلح نزل بنفسه إلى الموقع وأمر بالهدم الفوري “على من فيه”. هذا المشهد، الذي تناقلته الصحافة كخبر صادم، شكّل لحظة درامية تعكس علاقة ملتبسة بين الدولة والثقافة.
تردّد لاحقًا أنّ الحكومة دفعت تعويضات بلغت 17 ألف ليرة لبنانية، لكنّ الصحف علّقت على أنّ المبلغ “لا يعادل قيمة ما قدّمه الرويال من ذاكرة حيّة لبيروت”.
•الذاكرة المفقودة
بهدم “الرويال”، لم تخسر بيروت مجرد صالة عرض، بل فقدت معلمًا ثقافيًا كان شاهدًا على تحولات مجتمعها. فقد جمع المسرح بين السينما الهوليوودية والأفلام المصرية، وبين المسرح الفرنسي والكوميديا المحلية، وبين وجوه نسائية صاعدة وجماهير متعطشة للفن.
اليوم، حين نقرأ في أرشيف الصحف القديمة، أو نستعيد صورًا باهتة من واجهته، ندرك أن بيروت لم تفقد مجرد مبنى، بل فقدت جزءًا من ذاكرتها وهويتها. فالرويال لم يكن مجرد خشبة وعروض، بل كان فضاءً جامعًا، ومختبرًا للتنوع والانفتاح الذي ميّز العاصمة اللبنانية قبل أن تعصف بها الحروب والتحولات العمرانية.
إن قصة “الرويال” تطرح سؤالاً عميقًا حول العلاقة بين الذاكرة والتنمية. فهل يُبنى المستقبل بطمس الماضي، أم أن الحاضر لا يستقيم إلا بالحفاظ على معالم الذاكرة؟
الجواب يبقى مفتوحًا، لكن المؤكد أنّ “الرويال” سيظل في ذاكرة بيروت مثالًا على مدينة عرفت كيف تواكب الحداثة، قبل أن تفرّط بكنوزها الثقافية تحت عنوان التطوير.
________
*إعلامي وباحث في التراث الشعبي.
.