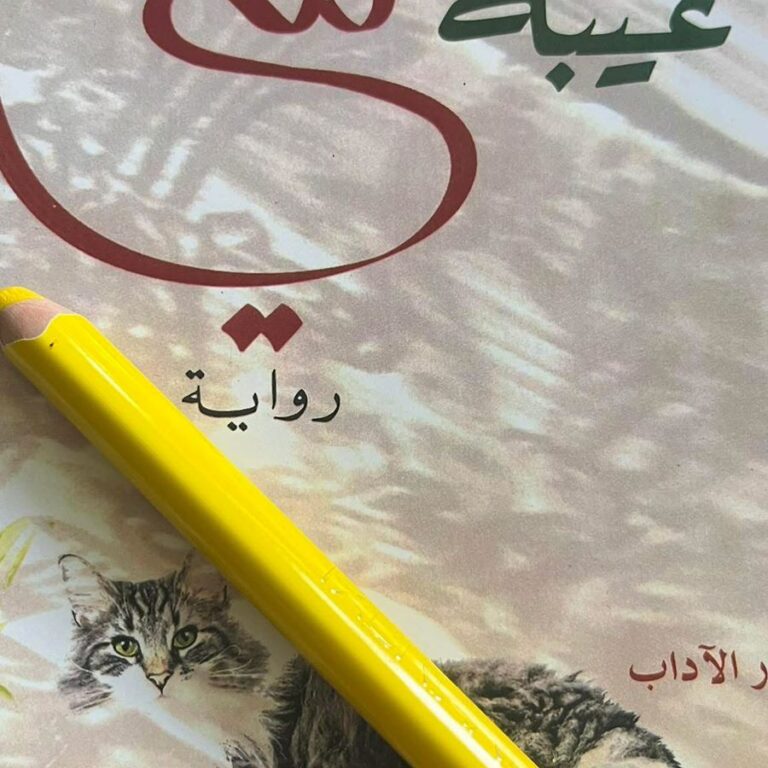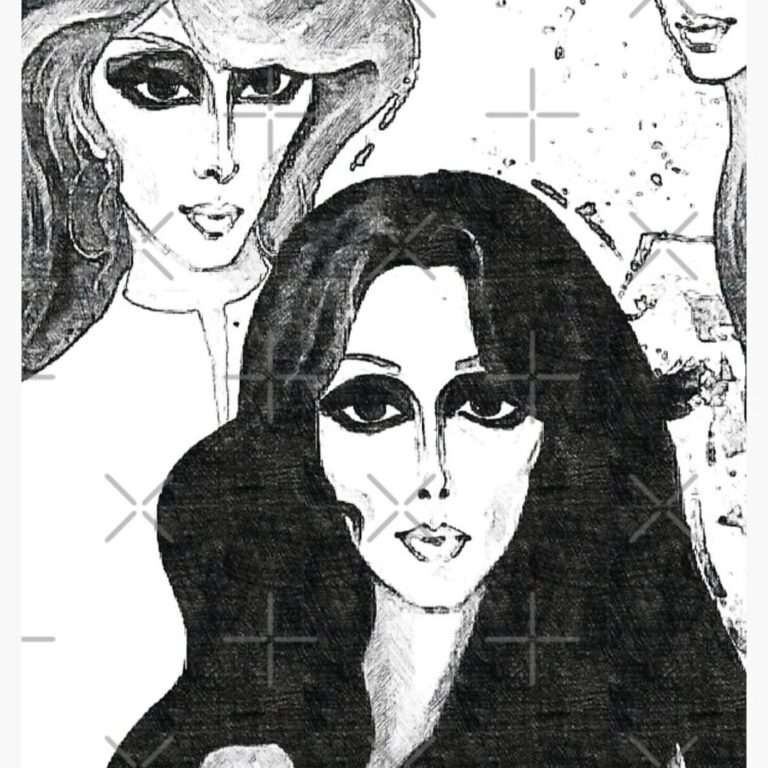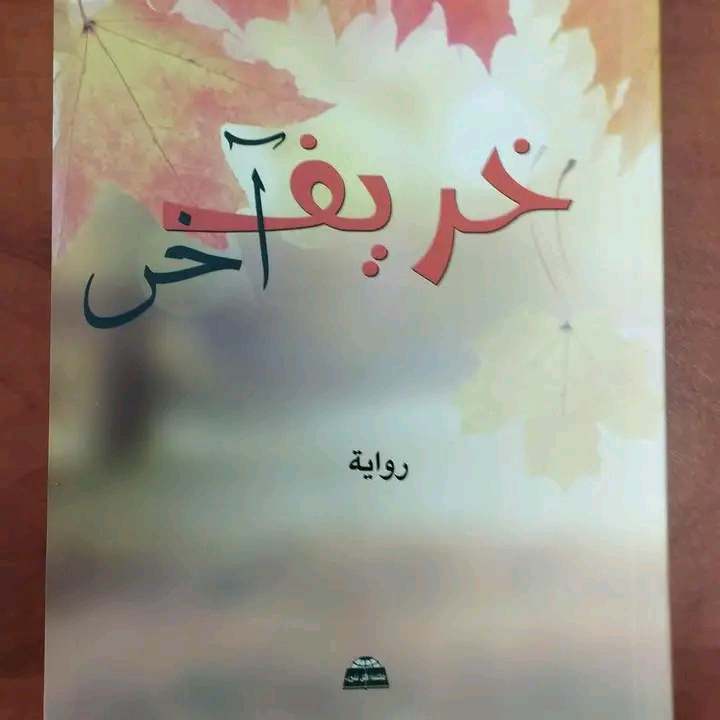
خريف آخر" لمحمود شقير / سردية فنّية فلسفية عن التآكل، الخيبات، واحتمال النهوض .

قراءة نقدية بقلم: ليلى تباني
في رحاب الأدب الفلسطيني الحديث، يسطع اسم محمود شقير كأحد أبرز الأصوات السردية التي تخطُّ وجع الأرض والإنسان بكثافة وجدانية عميقة، توثّق تجربة الفلسطيني في خضم نكباته المتلاحقة التي لا تخلو من التهكم المُرّ والذكاء الساخر. في روايته “خريف آخر”، يقدّم لنا شقيرـــ الاديب المقدسي البارزـــ عملا روائيا متعدد الطبقات، كتبه في عام 1978، لكنه لم ينشره إلا في 2025، بعد عملية حذف وتنقيح وتصفية ذهنية امتدت لسنوات. هذه المدة الفاصلة بين الكتابة والنشر ليست مجرّد زمن تقويمي، بل هي الزمن الحقيقي الذي نضجت فيه الرواية من كونها خطابا سياسيا غاضبا إلى تأمل فلسفي وجودي في مفارقات الوطن والهوية والتشظي الداخلي . شقير الذي يمتلك رصيدا غزيرا من الأعمال الروائية التي تنهل من بئر الذاكرة الجماعية والتجربة الشخصية، يخرج في “خريف آخر” برؤية سردية فلسفية معمقة، تتجاوز مجرد التوثيق لتصبح نقدا ذكيّا للذات والواقع. هذه الرواية، التي تقف على عتبات الغلاف بلون خريفي داكن، وتصميم يوحي بتفتت الأرض وتقلّب المواسم، ليست مجرد سرد لمرحلة زمنية من التاريخ الفلسطيني، بل هي استعارة عن تقلبات النفس البشرية تحت وطأة الاحتلال والتشرد والضياع. شقير الذي لطالما حفر في التربة الفلسطينية أدبيا، لم يقدّم في هذه الرواية بيانا نضاليا ولا حكاية رومانسية عن “العودة الكبرى”، بل نصّا ينأى عن المباشرة،مشبعا بالتوتّر الداخلي، والقلق الأخلاقي، والتصدّعات اليومية. ولعلّ التمهيد لكتابة الرواية يحمل بذور هذا القلق؛ يتّصل بمحمود درويش من أجل نشرها ، لكنّه يعدل عن قراره ، ويتراجع في نشره فتظل لفترة طويل بين طيّات النسيان ، كان قد كتبها في المنفى، وحين أعاد النظر فيها بعد عقود، حذف منها حوالي سبعة آلاف كلمة، أزاح الخطابات الشعاراتية، وركّز على همّ الإنسان العادي في ظل الخراب الكبير. بهذا، تصبح الرواية نتاج نضج فكري ونقد ذاتي لخطاب المرحلة.
الغلاف ذاته، بلونيه الخريفيين، لا يزيّن النص، بل يختصره: أوراق تسقط، زمن يتآكل، أرض تنزلق…. والعنوان “خريف آخر” ليس عنوان موسم، بل عنوان روح. الخريف هنا ليس نهاية طبيعية، بل إعلان مستمر عن التفسّخ، وعن التحلّل البطيء الذي يسبق إما الموت أو التحوّل. ويعكس ومضة باهتة لضوء خافت للغد، ورمزا حتى في أقسى أيام الخريف يظل رأيا حيا يقاوم الانتفاء. أمّا المتن فأصنّفه من بين النصوص المكثّفة، العميقة التي كتبت بلغة أنيقة مشحونة. تقاوم النسيان والتبسيط، لا تزعم بطولة، لغة تكشف الألم، وتمضي في تشريحه بلا تردّد. لغة تتلبّس أسلوب التمنّي في هيأة رثاء ، تكشف صورة ما بعد الهزيمة، وما بعد البطولة، لغة رغم خيباتها المتوالية تُراهن لا على الانتصار و البقاء .
في الرواية، نتتبع مسار الراوي من لحظات التشرّد والنزوح في طفولته، إلى مراهقته المشوّشة، ثم وعيه الناضج الذي يتقاطع مع انهيارات والده، وتفتت قريته، وضياع المعنى في زمن الاحتلال. هذه المسارات لا تُروى بخط مستقيم، بل بصوت متعدد و سردية بوليفونية تختلط فيها الحكايات الشخصية بالأحاديث الجماعية، بالسخرية المبطنة، بالعتاب، بالرغبة في الفضح، وبالتهكّم على زمن لم يترك مساحة للبطولة. يتخفّى الكاتب محمود شقير عمدا خلف شخصية الراوي “حلمي”، متجنّبا الظهور الصريح باسمه أو موقعه الحقيقي داخل النص. هذا التخفّي ليس هروبا من المسؤولية، بقدر ما هو اختيار سردي وفلسفي يمكّنه من مواراة الذات داخل التجربة الجمعية. فـ”حلمي” هو المزيج المركّب من ملامح الكاتب وشريحة كاملة من الفلسطينيين الذين شهدوا النكسة والنكبة والشتات والانكسار الأخلاقي.
الرواية لا تُقدّم حلمي كبطل تقليدي، بل كمُراقب هشّ، يحمل همّ والده، ويستعيد صور القرية، ويتلعثم أمام مشاهد القهر والخذلان، تماما كما يفعل الكاتب نفسه عند صوغ هذه الصور. ولهذا، يُمكن القول إن شقير يميل إلى موالاة حلمي لا لأن حلمي امتدادٌ ذاتي له، بل لأنه الوعاء الصادق الذي يمثّل انكساراته المعنوية ومقاومته الصامتة.
ها هو في مشهد مثير للجدل المفضي الى قناعة تختصر صورة العربي الذي لا يتوانى في خذلان وخديعة أخيه العربي، فيستجليه من خلال مشهد الذخيرة الفارغة الذي رأيته شخصيا أقوى شاهد على هذه الرؤية …. يتأمّل الأب الرصاصة ويكتشف أنها محشوة بنشارة خشب بدل البارود. يقول: “هذه الحرب مهزلة”. هذا الاكتشاف البسيط لا يُقرأ بوصفه انفعالا فرديا، بل يحمل بعدا رمزيا عميقا عن فساد المؤسسات، وبيع الأوهام، وعن كيف تصير الحرب نفسها تمثيلية بلا معنى، أدواتها زائفة ومسرحها مهزوم مسبقا.
وفي مشهد آخر، حين تُقام مخيمات النازحين، وتُغدق عليهم المعونات الدولية، تسخر “صفية الأحمد” التي أقحمها الكاتب كعرّافة تستقرئ المستقبل وتتنبّأ بالآتي من خلال ما تقرأ في كتب التنجيم، لتتدخّل قائلة بثقة دراويش:
“هذا الاحتلال يدوم سبعة أيام أو سبعة أسابيع أو سبعة أشهر أو سبع سنين أو سبعين سنة.” فتأتي إجابة الأب ساخرة لكنها مثقلة بالقلق: “بلا كتب، بلا هم. هذي كلها سوالف فاضية ” ، بهذا الحوار البسيط، تسخر الرواية من المرويات الكبرى، وتكسّر زمن المركزيات لتتجاوز الكلنيالية إلى ما بعدها ، وتنتقد التفاؤل الزائف الذي يحاول أن يُخدّر الألم بجرعات من الانتظار.
تتصاعد ثنائية الوعي والانكسار، حين يبدأ الفلسطينيون بالعمل في المصانع الإسرائيلية كتعبير عن رفضٍ أوّلي، يليه خنوع اضطراري. الأب الذي عاب على أخيه عمله عند العدو، يتغاضى لاحقا بسبب الجوع. التناقض هنا ليس ضعفا، بل بيان سردي عن هشاشة المبدأ أمام جبروت الحاجة. هذه الجدلية الأخلاقية تفضح ــــ كما في فلسفة الرواية عموما ــــ أن المقاومة ليست دائما شعارات، بل اختيارات معقدة، تتشابك فيها القيم والواقع المرّ. ومن التمزّق الاقتصادي والاجتماعي، تنتقل الرواية إلى التمزّق النفسي. فيظهر مصطفى صديق الرّاوي ” حلمي “، الذي قدّمه في شخصية المتفسّخ المائع ، إذ لا ينفكّ يُشجعه على تجربة العلاقة مع النساء الإسرائيليات مدّعيا:
“سينزاح عن صدرك هم كبير.” لكن حلمي يبقى معرضا، غير مقتنع. ثم يعود مصطفى بعد حين ويقول إنه كره تلك العلاقات. نضحك معهم حين يسخر:
“اهتديت إلى امرأة فلسطينية.”… ثم يكمل، في مرارة ساخرة:
“ هذا زمن الاحتلال وزمن العجائب… بعض النساء الفلسطينيات لا يحلو لهن إلا النوم مع إسرائيليين.”
ويضيف ساخرا: “رحم الله ابن خلدون، فقد كفاك.”
في هذا الحوار العابث على السطح، العميق في جوهره، تتحول العلاقة الجسدية إلى استعارة عن العلاقة المعقدة بين الضحية والجلاد. إنّ الغالب ـــــ كما قال ابن خلدون ــــ يؤثر في المغلوب، لا فقط سياسيا، بل أيضا في الذوق والسلوك والشهوة والتماهي. إنّ هذا البعد الإيروتيكي في الرواية لا يأتي من باب الإثارة أو الغرابة، بل يُحمّل الجسد مسؤولية الذاكرة والانكسار. فالجسد هنا هو الآخر المُستباح من الاحتلال، من الضعف، من الحنين، من الخذلان. ولا تكتمل هذه اللوحة بدون شخصيات المغتربين: ابن الخال الذي صار مطوعا في السعودية، وجعل من تحرير القدس قضية دعوية مجردة، ثم غادر غاضبا لأن البلاد تحت “حكم الكفار”. وابن العم الذي يتفاخر بقدرته على دخول إسرائيل والخروج منها دون أن يُسأل. هؤلاء ليسوا شخصيات ثانوية، بل نماذج لانقسام الذات الفلسطينية في الشتات: بين التدين المتشدد والتفاخر الفارغ، بين الاستعلاء على الداخل وبين جهله الحقيقي بالألم.
وسط كل هذا، تبقى حليمة ابنة عمّه ـــــ التي لم يكن يرغبها ــــ ملاذه الأخير واختياره الاضطراري ، تبقى الزوجة، الأم، الرفيقة ، تمسك بطرف الحياة إذ يقول الراوي:
“وتظل حليمة إلى جانبي تعتني بي وبابننا الوحيد جمال، الذي منحناه اسم ذلك الرمز الباقي فينا مدى الحياة.” فاسم “جمال” ليس فقط تخليدا للرئيس “جمال عبد الناصر ” ، بل هو استعادة رمزية لأمل لم يمت، لكفاح لا يزال قائما، وإن كان بصوت خافت.
هكذا، تتشابك في “خريف آخر” شخصيات متعددة، مشاهد واقعية، ورموز فلسفية ليصنع محمود شقير سردا روائيا غنيا، يمتدّ بين الفرد والجماعة، بين الذات والآخر، بين الحلم والواقع، بين الخريف والربيع. إنها رواية عن الخريف الداخلي؛ ذلك الخريف الذي لا يُشهد فحسب في تغير الفصول، بل في تصدّع الذات، في الانكسار الصامت، في موت الأب… لكنها أيضا عن الكتابة كهبة مقاومة وإضاءة لمعتم خوف ونسيان. إنّها الرواية التي تشدّ القارئ ليس فقط لتوثيق معاناة شعب، بل لتدخله في عوالم نفسية وإنسانية تعكس تناقضات الوجود في زمن الاحتلال.
أنصح القارئ ، بالقراءة للكاتب “محمود شقير” سواء روايته “خريف آخر” أو مجموعاته القصصية ، فما بين بساطة كتاباته ورفعة أسلوبه وسلاسة وبلاغة لغته وعمق قضاياه ؛ نكتشف شخصا بل إنسانا هو مرآة لفلسطين التي تتلاشى في التفاصيل والتكرارات والخطابات التي تُنسخ بلا روح….ويبقى الخريف يتكرّر ويبقى أمل قدوم الربيع بعد شتاء يحبل ويبشّر بغلال وفيرة وبين ثنايا هذا البقاء، يبقى محمود شقير واحدا من أولئك الكُتاب الذين لا يُجمّلون المأساة، بل يصوغون منها مرآة تُجبرك على النظر في ذاتك وتتفاءل بآت أفضل مرآة تشبه هذا الخريف الذي لا ينتهي لكنه أيضا لا يخلو من بذور يرويها عنفوان الشتاء وتزيّنها زهور الربيع .