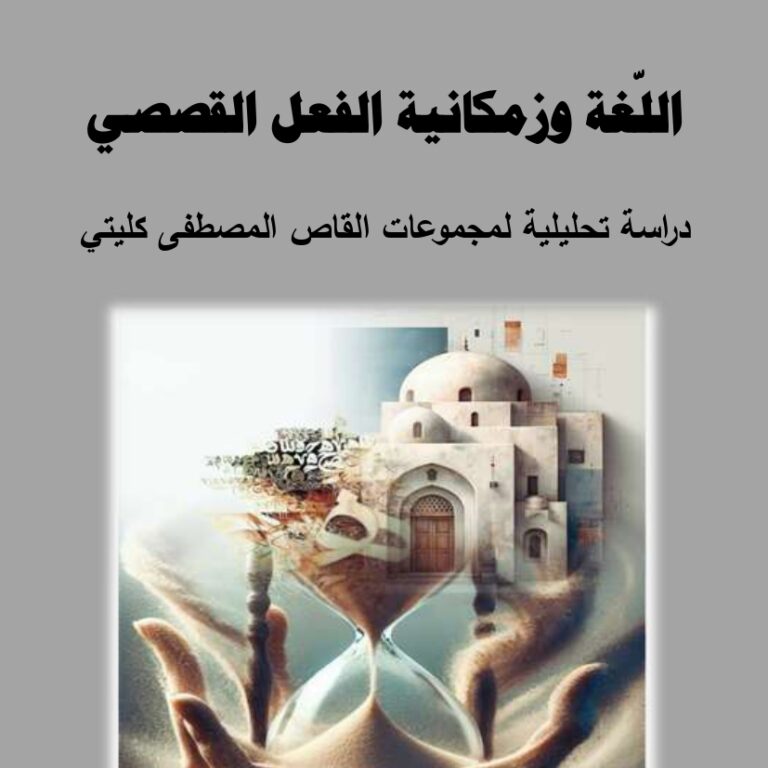اخلاص فرنسيس
إلى أمّي تميمة المكان، أول جملة في الإهداء والتي سوف أقول عنها ليس فقط المعنى الذي ندخل من خلاله إلى النصوص الأمّ، بل هي التميمة، وهي القلادة التي تدفع العين الحاسدة والشريرة عن حاملها
هذه التميمة التي تعلّق في العنق على مرأى من الكلّ لدرء خطر العيون “من علّق تميمةً فلا أتمّ الله له”
هنا التميمة تحمي ليس الشاعر فقط، بل المكان، وأيّ مكان هو هذا؟ هو البراح الذي يأخذنا إليه الكاتب في الصفحات المتتالية التي اختصرها الكاتب بالإهداء أيضاً، المحتوى الذي أوجزه في سطور الإهداء، سواء أسهب في الكتابة عن واحدة، واختصر في الناحية الأخرى، ولكن الديوان بأكمله هو
الأمّ، الأبناء، الروح التي سنقف عندها كثيراً، والصديق المسمّى د. ناجي الحربي
الرمز يبقى العامل المؤثّر والأكبر في الشعر، كما الصور هي الموسيقا الخلفية لكلّ نصّ يطالعنا، عصارة روح الكاتب بين أيدينا، نزف كما وصفه ولا عجب أنّ كلّاً منّا يغمس قلمه في جرحه، ويجترح إثم الكتابة والقصائد
بعد الولوج إلى النصوص التي لم تأت بعيداً عن الإهداء، أول ما يطالعنا هو ذلك المكان الذي أراد الكاتب أن يحميه بالتميمة بين قوسين “أمّه” والمكان هو الوطن الأكبر بعد جسده المسكون بالوجع، هذا الوطن الذي اعتملت فيه فوهات المدافع، ويتمت أطفاله، وباتت تبحث عن ألعابها وسط الركام الوطن ليس ليبيا فقط ولا حمزة الحاسي، بل الوطن العربي كلّه
الذكرى أو الوقوف على الأطلال، عندما يغادرنا الرجاء، وتنصهر الشموع، وتنحلّ عناصر الأمل وهي تغادر سماء الشاعر يصبح البوح أكثر عذوبة و إيلامًا، حين يصبح العشق كذبة يتكشّف لنا معاناة الشاعر في ما كابده من خيانة وهجر وهجران
تدور القصائد حول الحبيبة، ولكنّها لا تخلو من هجمات وطنية تشظّي قلبه حيث يريد الولوج إلى تلك المدينة، يسير في أزقّتها حيث أضاع يوماً اسمه، وهل هناك مأساة أكبر من أن يضيع الإنسان اسمه، عندها يكون ولا يكون، تكاد لا تخلو قصيدة من الحبّ والحرب ومزاجية العدالة حيث لا عدالة، الأفضل أن نسدل الستار لئلّا نصاب بشظية حبيب قبل أن يتاح لنا لثم الثغر لنسرق قُبلة حبّ بريء تحت السلالم

حمزة الحاسي شاعر وصحفي ليبي
اعتذار لا يكفي في ظلّ لعبة الكراسي وفي تمرّد الأحلام وتبادل الألعاب
هم يلعبون بالوطن من على الكراسي، وأنت وأنا الصغار دعينا نغلق التاريخ بهمسة حبّ برغم الغياب، تبقى المرأة المرسلة والمرسل إليها، الملهمة والغائبة الحاضرة في كلّ النصوص، الحاضرة في لاوعي الكاتب “واهبة الشعر والكتابة”، التي تمسك بيد الشاعر ليكتبها على جدار الصوت والصدى وفي أزقّة المدن المهجورة وفي عيون الأطفال، علّه يجد نفسه في نفحات حرفها وأنفاسها الحارة، ولكن لا شيء يشبهها، تسكن القصيدة وهو مسكون بها، بين الحقيقة والخيال وفي صليل الدمع بين الجفون، سفن ومناف، سحب وعتاب، قبل ومراث
هل تكفي باقات الغفران للتكفير عمّا كسرته الحروب، وهل يكفي ياسمين العالم كلّه ليمسح من ذاكرتنا رائحة الدم والبارود؟ أسئلة تترى حبل فيها وجدان الشاعر وولدت قصائد، تعكس حالة تجذّرت فيه، وأصبح مثل عصفور يغرد أنشودة الأحرار على شاطئ المساء، يرقب السماء علّ نجماً أضاء بغير لون الشهادة، حبذا لو كانت خضراء كما عينيها، خضراء كما الربيع كما الأماني كما الهيام والقبل شهيّة حدّ الثمالة، وما أحوجنا إليها كحاجتنا للشهيق والزفير
لم يغب محمود درويش في قصيدة “هذا الاسم لي” في تناصّ جميل بين ثنيات الكلام موسيقا عازفة لعملاق الشعر يدلّل جسد أنثاه بالحروف، بكلّ التفاصيل الأنيقة في صلاة أخيرة، هي اعتراف أخير دخول إلى حضرتها. من هي؟
في محراب الأنثى ينكشف جموح الشاعر كمنجة بين يديه تهطل ألحانًا، صلاة أخيرة. هل هي اعتراف الشاعر بفشله الاحتفاظ بها، بالوطن بطفولته ببراءته بأمانيه بأحلامه بعشقه الأوحد، وهل الاعتراف هنا سوف يقود روحه إلى السلام، هل سيبلسم الكلام مرارة الكلم؟ من يرتّب الأوجاع في دفاتر ذاكرتنا، ومن يخلّصنا من تلك اللحظات التي تتحد ضدّنا؟ لحظات الوجع والهزيمة حين تخلّى عنّا الوطن الحبيب الصديق والزمن
الديوان تراكمات من حياة أخرجها الشاعر في لغة متمكنة سهلة الفهم من الجميع حاضره وماضيه، في لهاث متتابع يحاول أن يبعث الحياة إلى زمن ماتت فيه كلّ الأحلام، منطقة قاحلة ولكن بالاعتراف والصلاة الأخيرة محاولة لامتلاك ناصية القرار علّه يرتق ما انسلخ منه في ضلال إلى تدفّق الدهشة، قراره في الاعتراف قرار ضمني بالمسؤولية تسلّلت إلى أوردته كلّ أوجاع الوطن تذوق الدم، ما مذاق العشق حيث الشفاه متخمة برائحة الدم
الوطن يشغل وعي الشاعر واللاوعي، يسكنه كيف وبأيّ طريقة نعيد بناء الأشياء الضائعة، والأهمّ النفس الضائعة، على الغلاف الخلفي، تعود إلينا صورة المرأة همسها دمعها مشاعر متنافرة، وإن خضع لحظة لفتنتها تختفى كلّها عند حضور الأمّ والارتماء في حضنها الدافئ، صورة فيها كلّ الوضوح
لا يقاوم الشاعر حبّه للنساء، ولكنّه يتفرد في العلاقة بهنّ، ويعيش الزمن في لحظته