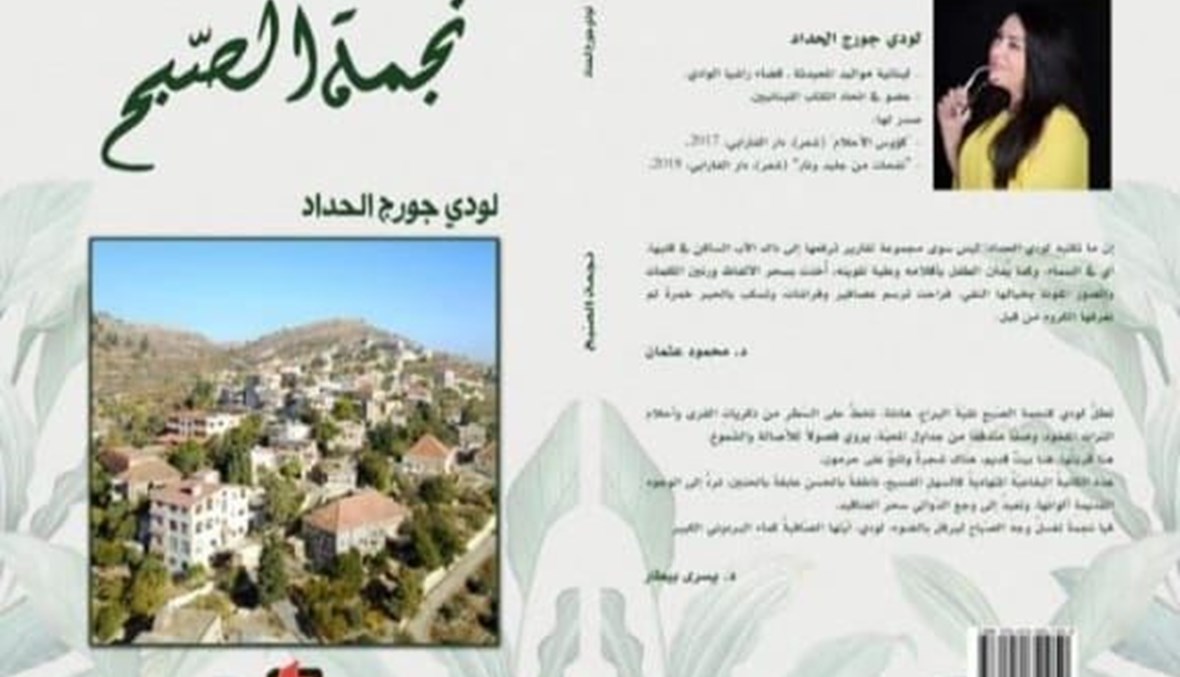

يوسف طراد للنهار
لم تكتب لودي الحداد مديحًا بالميزات الطبيعيّة والتاريخيّة لبلدتها “المحيدثة”، ولا شعرًا يغنّي جبالها وسهولها، إنّما أعطت صورة صادقة عنها، أرضًا وشعبًا، في ماضيها وحاضرها. فها أنّك تقرأ في كتاب “نجمة الصبح” الصادر ضمن منشورات دار الفارابي، أدبًا بقلم أديبة، أخرجت من الخيال والذكرى شخصيّاتٍ، ورفعتها إلى درجة استحقوها، ولم تُعطَ لهم من قبل
لم تكن الحدّاد أوّل من أعلن عشقه لقريته، لكنّها كانت من الأوائل اللواتي أشعلوا الجماد. فقد نضحت نصوصها بالنوستالجيا المشوّقة، وبما كانت وما تزال تمثّله قريتها من إرث وجوهر حياة. فقد أثبتت حضورها الدائم خلال السّرد بعفويّة صادقة، وكان حبرها من نبض قلب يحنّ إلى ماضي البركة، التي غابت عن خزائن كانت تضمّ الخير في داخلها
كتابها حوى على قرنٍ من الصفحات، ضمنها إحدى وعشرون صورة لأماكن ومنازل ومعابد، لكنّ الكاتبة بمئة صفحة فقط حافظت على اللهفة، وجعلت في الصدارة الرغبة في العودة إلى ماضٍ عَبر، وأصبح منسيًا. وقد اقتحم الوصف الرائع النصوص، مع نغم جميل، حملها على جناحيه، وحلّق بالقارئ بعيدًا، محرِّكًا في سامعه حنينًا كادت مطحنة العصر تطحنه
هل علّمت الحياة الكاتبة أن تبحث عن القلوب الطيّبة، والملامح الباسمة؟ فقد تركت فسحة جميلة للفرح المزهر، رغم الحزن العميق، ورماد العمر الهارب! وكانت كحكاية عتيقة على موعد مع نجمة بعيدة: “لا أدري إن كنّا نحن من يسير في أنوار الحياة ويتعفّر من ترابها، أم هي الّتي تتغلغل في أعمارنا وتتوغّل في شرايين وجداننا” (صفحة ١٥)
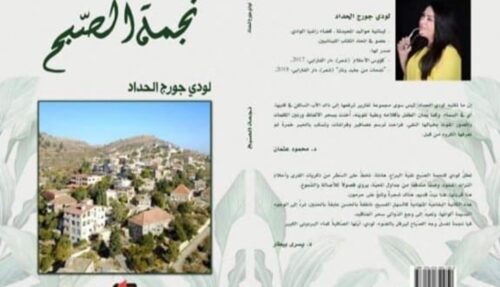
يكتسي جبل حرمون ببياض قلبها النقي، والثلج الناصع حارس قريتها فوق شرفة الدهر. هنا من على شرفة منزلها في “نجمة الصبح” نقشت لودي حكايات زاهرة بحنان الأهل، وشقاوة ترويها الدروب، ويشهد لها جلال جبل الشيخ: “يأخذني إلى وجه أمّي وحضن أبي، إلى جذوري وأزقّة طفولتي، إلى حيث تركت بعضي يلهو حينًا على سحابةٍ، ويغفو حينًا آخر في أعماق نجمة استراحت على كتف جبل اتّكأ منذ آلاف السّنين على صدر أمّه السّماء” (صفحة ١٧)
قرية تغسل حواسها كلّ صباح بشمس السنابل، كامرأة تراقص النور بنشوة الحياة، فتسكن ضلوع أحبّتها نبوءةُ الفرح: “ترعرعت قريتي في كنف صباح كلّما انجلى” (صفحة ١٩)
لقد قارب كريم الكوسا في روايته “الشيفرة الفينيقية أسرار الكأس المقدّسة” طقوس الذبيحة الفينيقية القديمة التي اعتمدت الخبز والخمر، والتي كانت تجري على قمّة جبل حرمون، بإفخارستيا الكنائس المسيحيّة في يومنا هذا. فهل تلك التراتيل القديمة ما زالت تتهادى مع النّسمات إلى منازل تلوّح للشمس والنجوم في الأمد القريب البعيد؟: “أمّا أمامك فجبل حرمون المكلّل دائمًا بتاج أبيض من الثلوج، يرسل مع كلّ نسمةٍ قبلاتٍ تبرّد جبين النهار، وفي المساء تدغدغ وشوشة السّمر” (صفحة ٢١)
على درج الحنين يفترش “البيت الكبير” ذكرى الأهل التّي تفوح في الأرجاء، والأيام تتوالى وتمنح “نجمة الصبح” بهاء ألوانٍ استعارتها من الفصول. وها هي صُوَرٌ جميلة أنشدت الخير “أيام الحصاد” من سواعد الفلّاحين المباركين بكنيسة القرية، وكاهنٌ جليل يوزّع البركة مياهًا مقدّسة على أبواب لم تُقفل في وجه ضيفٍ
كاتبة وجدت في خيالها لمحات غابرة من أيّام “المدرسة” لتلك المراهقة التّي ازدانت أيامها ببراءة الأقحوان، وانعتق الفكر في ردهات التأمّل الأصمّ كالجدران، ونطق “الأخرس” واستفاق الحلم في أحضان الغمام، مذكرًا الإنسان أنّ في الحياة سرّ السّماء، فعن الأخرس كتبت في الصفحة ٧٨: “لأفياء الجدران ربّما باح بسرائره، فكتم الحجر… ومحا المطر…”
كمدى صواب النهر في ارتحاله الأعمى إلى البحر، فقد يمّم “الضّرير” وجه البشرية بضياء الأمل وذهب بعيدًا في المستحيل: “كان يدرك ببصيرته بواطن الأسرار الّتي تغلّف الأديم، ويعي مناهل الجواهر التي ترصّع السّديم” (صفحة٨١)
عندما تُكتب النوستالجيا، تحضر إشكاليّة حوار بين الأمس والغد عند الحالمين من الكتّاب والشعراء، فيذهب بعضهم إلى المستقبل، لكنّ خياله يسعى دائمًا إلى إعادة تركيب صُوَر الماضي. أمّا لودي الحداد فقد أتعبها زمنها؛ لذلك أتبعت الكلام على ماضيها في قريتها الهانئة “المحيدثة” بـ”إكسير العمر الرهيف”، فكان بوحها باسم ساكنيها، وهي ليست بحاجة إلى وكالة بوح، لأن طفولتها منحتها هذه الثقة، بقلبها البريء
هل نقول شكرًا للودي الحداد التي غمرت البقاع بأنوار شمس حرمون، ووزّعتها براعمَ، على مدى صفحات كتاب “نجمة الصبح”؟ ففي كلّ صفحة، فرح من الماضي يطلّ مع حنين كلّ قارئ
غرفة 19
- لا شيء لي يا حبيبي/ ميسون أسد
- حكاية قلب بايعَ الكتب
- قراءة أنثروبولوجية لأغنية “بنت الجيران” لحسن شاكوش وعمر كمال
- غرفة 19 تقدم: عطر ودماء للكاتب يوسف طراد
- شربل داغر: فينوس خوري-غاتا عائدة من عالم الموت
- ندوتان ثريتان…في أيام الشارقة التراثية حين تلتقي الأسواق التاريخية بالألعاب الشعبية في ذاكرة التراث














1 أفكار حول “قلب بريء على درج الحنين في كتاب “نجمة الصبح” للودي جورج الحداد”